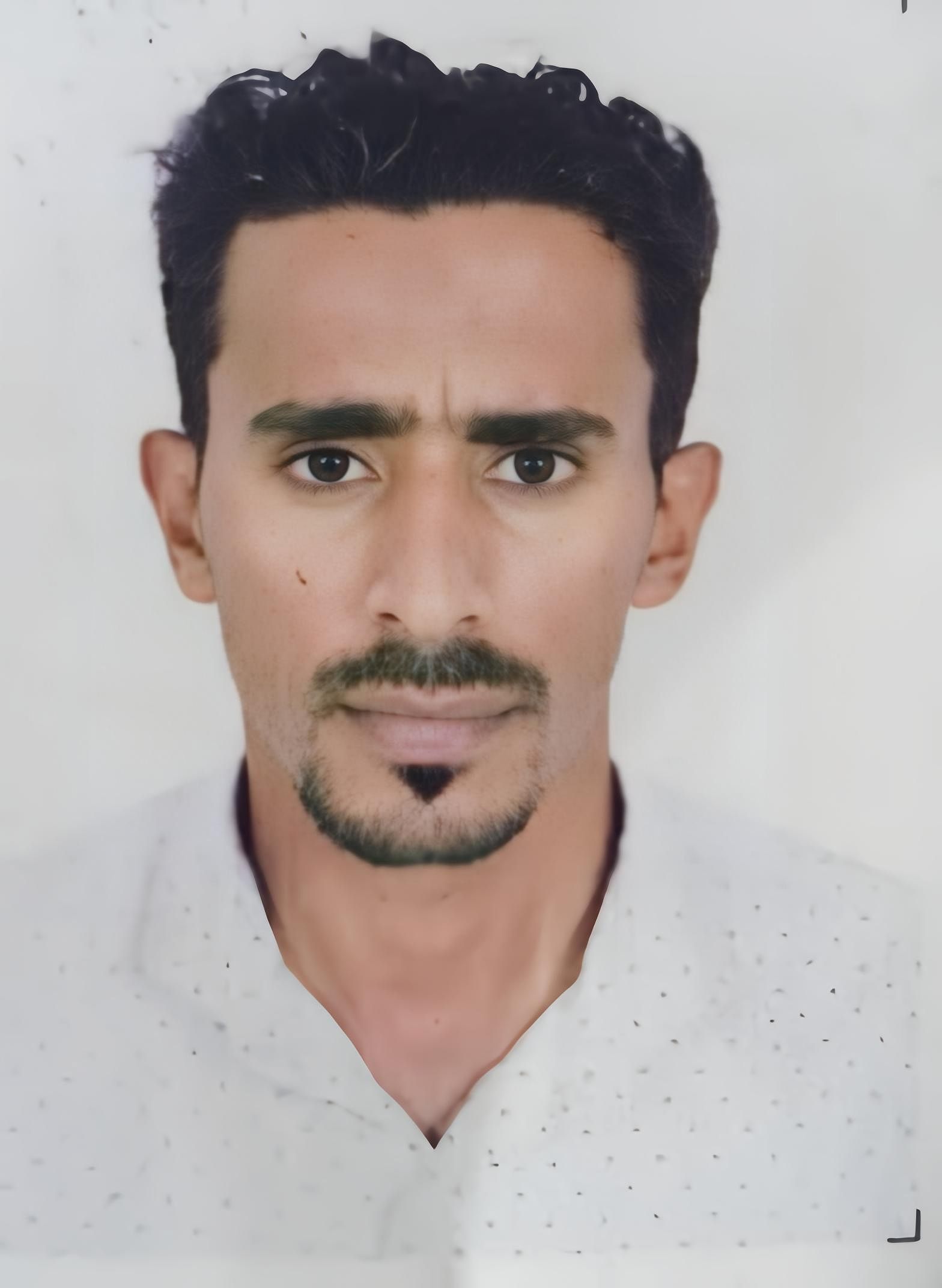السلفية والسلطة
الدعوة السلفية وعلاقتها بالاستخبارات في الدولة الحاضنة، موضوعٌ يتشابك فيه العقدي بالسياسي، ويتداخل فيه النقاء النظري مع مكر الواقع، حيث تبدو السلفية في أذهان كثيرين مجرد تيار عقدي سُني يهتم بالتوحيد والاتباع والحديث، بينما في واقع كثير من الأقطار الإسلامية المعاصرة، وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت هذه الدعوة حاضرة ضمن هندسة الأمن السياسي، بل تُستثمر بوصفها أداة لإعادة تشكيل المجال الديني ومراقبة خصوم الأنظمة.
يبدأ هذا التداخل من اللحظة التي انتبهت فيها بعض الأنظمة العربية، وخصوصًا بعد انهيار مشروع القومية العربية في الستينيات، إلى أهمية التحالف مع التيارات ذات الطابع الديني المحافظ، لضرب المد اليساري، والناصري، ثم لاحقًا الحركي الإسلامي. ولأن السلفية، وخصوصًا التيار المدخلي أو التقليدي، كانت تبشّر بمنهج سكوني، يدعو إلى الطاعة، وينأى عن السياسة، ويركّز على إصلاح العقيدة دون الاشتغال بإصلاح الحكم أو النظام، فقد رأت فيها الدولة أداة مثالية لضبط الخطاب الديني الشعبي، وتوجيهه بما لا يهدّد مركز السلطة.
وفي هذا السياق، برزت أسماء كثيرة تبنّت الدعوة السلفية تحت مظلة دعم الدولة، وبمباركة الأجهزة الأمنية، ومن أبرزها مؤسسات ومشايخ في السعودية واليمن ومصر ودول الخليج. وتجلّى هذا التحالف، لا فقط في الدعم المادي والمعنوي، ولكن أيضًا في التساهل الأمني أمام أنشطة هؤلاء الدعاة، حيث كانت الدولة ترعى مدارسهم الشرعية، وتغضّ الطرف عن خطابهم، طالما لم يتقاطع مع السياسة أو يهدد سلطة الحاكم.
وقد استفادت الدولة من هذه الرعاية في توظيف السلفيين لضرب الخصوم الإسلاميين، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون والتيارات الجهادية، بل حتى التيارات التبليغية والصوفية المعتدلة أحيانًا. كانت الدولة تعرف أن السلفي التقليدي، حين يُمنح المنبر والمسجد ودار الحديث، سينشغل ببيان شرك القبور ومسائل الحجاب والولاء والبراء، ولن يتحدث عن فساد النظام أو غلاء المعيشة أو الاستبداد السياسي. ومع الوقت، أصبح هذا السلفي يُسهم في تشكيل خطاب ديني عام يمجّد الحاكم ويُحرّم الخروج عليه، ويُصنّف المعارضين في خانة "الخوارج" و"أهل البدع"، حتى وإن كانوا لا يحملون سلاحًا، بل حتى لو كانت معارضتهم من داخل الشرع.
وإذا أردنا التمثيل على هذا، فسنجد في شخصية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي مثالًا بارزًا، فقد عاد إلى اليمن بعد دراسته في المملكة السعودية، وأسس دار الحديث في دماج، بدعم غير معلن لكن غير منكور من الدولة اليمنية في بداياتها، وفي ظل تحالف مع السعودية التي رأت فيه حصنًا سلفيًا ضد التمدد الشيعي الزيدي في صعدة، وضد الإخوان المسلمين الذين كانوا يتمددون فكريًا وسياسيًا في الجامعات. ورغم أن مقبلًا لم يكن رجل دولة بالمعنى السياسي، إلا أن خطابه كان يتقاطع موضوعيًا مع مصالح الأمن القومي اليمني والسعودي آنذاك، فكان ينقض السياسة، لكن دون أن يزعزع عروشًا، ويرد على الحزبيين دون أن يقترب من النظام.
لقد نجحت أجهزة الاستخبارات في توظيف هذا النوع من الخطاب لتكريس الطاعة، وكسر الاحتجاج الشعبي باسم الدين، ووضع معايير دينية تُفصل على مقاس الدولة، حيث باتت "السنة" تعني موافقة الحاكم، و"البدعة" تعني معارضته، وصار كثير من مشايخ السلفية يدورون في فلك السلطة طوعًا أو كرهًا، ويُؤمّنون لها غطاءً شرعيًا يمنحها وجاهة دينية في أعين العامة.
وهكذا، تشكّل تحالف ضمني بين السلفية التقليدية والأجهزة الأمنية، يقوم على تبادل المنافع: تمنح الدولة حرية الحركة والتبليغ، وتضمن الحماية القانونية، مقابل التزام السلفيين بخطاب غير سياسي، ورفض التغيير من خارج النظام، والاشتغال على مقاومة التيارات المعارضة فكريًا، بل وشيطنتها. وقد وُظفت هذه السلفية كذلك خارج الحدود، حين تم تصديرها إلى إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، كأداة دينية مضادة للتطرف العنيف من جهة، وللإسلام السياسي من جهة أخرى.
لكن هذا التحالف ليس دائمًا متماسكًا، فقد يحصل التفكك حين يشعر السلفي أنه أداة أكثر مما هو مرشد، أو حين يُطلب منه أن يُوالي النظام مطلقًا حتى مع فسقه وجرمه، أو حين تُقيد حركته ضمن مربعات استخباراتية بحتة. ومع ذلك، فإن الكفة كانت غالبًا في صالح السلطة، لأن الخطاب السلفي الكلاسيكي، منذ ابن حنبل وابن تيمية، يحمل في داخله ميلًا فطريًا للطاعة والسكينة والابتعاد عن الفوضى، وهو ما استثمرته السلطة المعاصرة بذكاء.
وفي المحصلة، فإن العلاقة بين الدعوة السلفية والاستخبارات في الدولة الحاضنة ليست علاقة افتعال مباشر، بقدر ما هي تواطؤ مصالح ضمني، حيث تلتقي الرؤية الأمنية للدولة مع الرؤية العقدية للسلفي في نقطة مركزية: حفظ النظام وتثبيت الطاعة. وما لم يتجاوز السلفي هذا القيد، ويعيد التفكير في معنى "الولاء والبراء" في عصر الدول الحديثة، فسيظل، حتى دون أن يشعر، جزءًا من آلة الضبط التي تحمي النظام أكثر مما تحمي الدين.