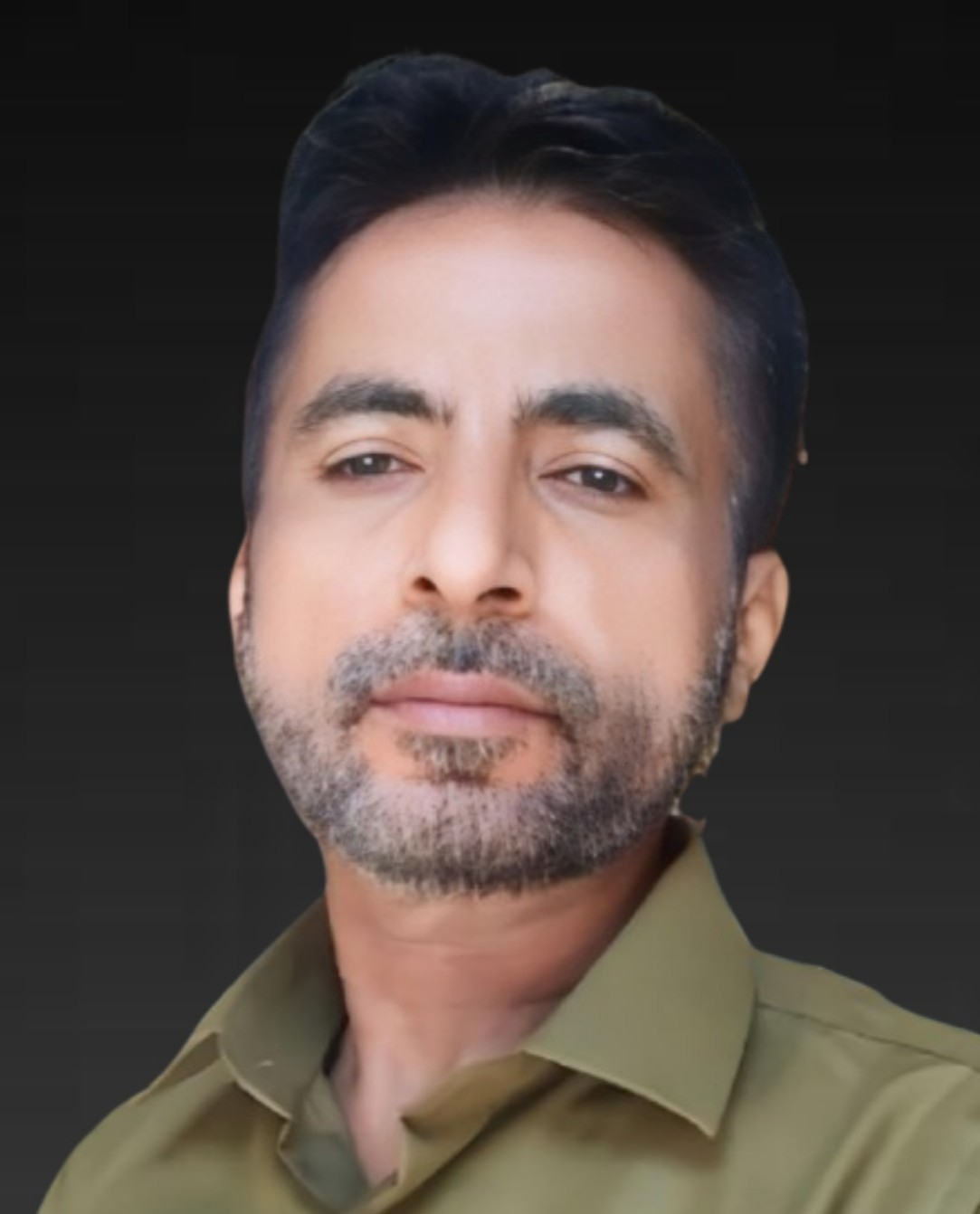الأحمديون كحلم لنبوة تأخرت على الموعد
لو كان للإسلام دفتر ملاحظات سري لكان فيه سطر مكتوب بخط صغير ومائل: "جماعةٌ تؤمن بأن النبوة لم تُغلق تمامًا بل أُغلقت على عَجل". تلك الجماعة هي الأحمديون أو القاديانيون كما يسميهم خصومهم، أبناء الفكرة التي قررت أن تسير على الحافة بين الإيمان والهرطقة، وأن تُجرب قول ما لا يُقال في مملكة الصمت المقدس.
الحكاية تبدأ في الهند البريطانية منتصف القرن التاسع عشر، في زمنٍ كانت القارة تُدار كضيعة استعمارية بيد الإنجليز، والإسلام يُدار كضيعة عاطفية بيد الفقهاء.. في تلك الفوضى خرج رجلٌ هادئ يدعى ميرزا غلام أحمد القادياني من قرية قاديان، معلنًا أنه ليس نبيًا بالمعنى التشريعي، لكنه أيضًا ليس مجرد مصلح عابر.
قال إنه "مجدّد القرن الرابع عشر الهجري"، ثم "المسيح الموعود والمهدي المنتظر"، ثم، حين اشتد الجدل، صار "نبيًّا تابعًا" لا يُخالف شريعة محمد، بل يُذكّر بها. كأنما أراد أن يُعيد للنبوّة حقّها في أن تكون تجربةً روحية لا وظيفةً إدارية.
وهنا ارتبك التاريخ: هل يُكفَّر الرجل لأنه قال إن الوحي لم يتقاعد بعد؟ أم يُكرَّم لأنه أراد أن يُنقذ الإيمان من جمود الموروث؟ لم يكن الفقهاء بحاجة إلى وقت طويل للإجابة. أُدرج اسمه في قائمة "المرتدين الممتازين" ووُصِف أتباعه بأنهم سرطان عقائدي، لأنهم ببساطة حاولوا أن يضيفوا فصلًا صغيرًا إلى كتاب أعلن الكمال على غلافه.
الأحمديون يؤمنون أن الله لا يصمت بعد الأنبياء بل يواصل الكلام لمن يسمع، وأن النبوة في جوهرها وحي مستمر لا يتعارض مع ختم الرسالة، بل يُذكّر بها.. فكرةٌ بسيطة في ظاهرها، لكنها بالنسبة لمؤسسة الفقه أشبه بعبور البحر حافيًا.
لم يتكلموا عن شريعة جديدة، بل عن روحٍ جديدة للشريعة. لم يلغوا الإسلام بل أرادوا تنقيته من سياسة الفتح وميراث الخلافة، لتصبح الدعوة إلى الله أقرب إلى حركةٍ فكرية منها إلى حملةٍ عسكرية. لكن لأنهم قالوا ذلك في زمن كان فيه الإسلام يبحث عن عضلاته لا عن روحه، جرى نفيهم خارج حدود الإيمان بسرعة تفوق سرعة الوحي ذاته.
من قاديان إلى لاهور ثم إلى لندن تمددت الجماعة كظلٍّ طويل لفكرة لم تُدفن كما أراد خصومها. لم يحملوا سيوفًا ولا رايات، بل مطابع وكتبًا وإذاعات. أنشأوا قناة MTA قبل أن تنشأ جمهورياتهم، وفتحوا مساجد في عواصم العالم قبل أن يُسمح لهم ببناء مسجدٍ واحد في باكستان التي طردتهم منها.
هناك في عام 1974 أعلن البرلمان الباكستاني الأحمديين "غير مسلمين"، ثم جاء مرسوم 1984 ليمنعهم من استخدام الشعائر أو الألفاظ الإسلامية، كأن السلطة قررت أن تُصدر مرسومًا رسميًا بمنع الضوء من المرور.
الأحمديون جماعة مسالمة أكثر مما يليق بزمن يحب الضجيج. يرفضون الجهاد القتالي ويؤمنون بأن الحرب الحقيقية هي حرب الأخلاق والعقل. وشعارهم الذي صار نكتة مقدسة: "الحب للجميع ولا كراهية لأحد".. ولهذا تحديدًا يُكرَهون من الجميع، لأن العالم الحديث كما يبدو لا يطيق من يوزع الحب مجانًا دون أن يُوقع استمارة الانتماء السياسي.
في ظاهرهم جماعة دعوية لكن في باطنهم مشروعٌ روحي/ فلسفي لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والله. لا وساطة، لا دم، لا انتظار لمهدي يحمل سيفاً. فقط يقين أن الله لم يتعب من الخلق بعد.
يقولون إن النبوة ليست منصبًا، بل حالة، وإن السماء لا تنغلق بمرسومٍ من دار الإفتاء. وهي فكرة كافية لتجعلهم أعداءً طبيعيين لكل من يظن أن المفاتيح الإلهية مودعة في جيبه.
تقرأ نصوص ميرزا غلام أحمد، فتشعر أنك أمام صوفي مهووس بالفكر الحديث، رجلٌ يريد أن يثبت للغرب أن الإسلام قادر على أن يتكلم لغة العصر دون أن يفقد روحه. كتب بالعربية والأردية والفارسية، ومزج بين القرآن والمنطق الأرسطي وشكسبير، حتى صار فكره أشبه بلوحة انطباعية، من بعيد تراها دينًا، ومن قريب تكتشف أنها تأمل وجودي في معنى الوحي.
ومع أن الأحمديين أُبعدوا من أوطانهم، إلا أنهم نجحوا في بناء شبكةٍ عالمية تمتد من كندا إلى غانا، ومن هامبورغ إلى هيوستن. أقاموا مؤتمرات للحوار بين الأديان، وشيّدوا مساجد بأسماء ناعمة مثل "بيت السلام" و"مسجد النور"، كأنهم يعوضون عن حرمانهم من الوطن ببناء أوطان روحية متنقلة.
في العالم الإسلامي تُغلق الأبواب في وجوههم كلما طرقوها بآيةٍ من القرآن. تُصادر كتبهم لأن فيها آراءً "تُربك العقيدة"، ويُلاحقون في باكستان وتُحرق مساجدهم، بينما السلطات تبتسم بثقة من يظن أن الله يصفّق له.
لكن رغم كل ذلك مازالوا هناك. جماعة لا تملك جيشًا ولا حزبًا ولا دولة، فقط فكرة مستمرة كضوءٍ صغير في آخر نفقٍ طويل: أن الله لا يتوقف عن إرسال المعنى حتى لو توقف الفقهاء عن الاستماع.
قد نختلف معهم كما اختلف الناس مع كل من تجرأ على سؤال المقدس، لكن لا يمكن إنكار أنهم أعادوا طرح السؤال الأقدم في التاريخ: هل أُغلق باب السماء فعلًا، أم أن الضجيج الأرضي هو الذي منعنا من سماعها تُفتح؟
الأحمديون، باختصار، أبناء النبوة التي تأخرت على الموعد، لكن حين وصلت لم يجدها أحد في المطار.