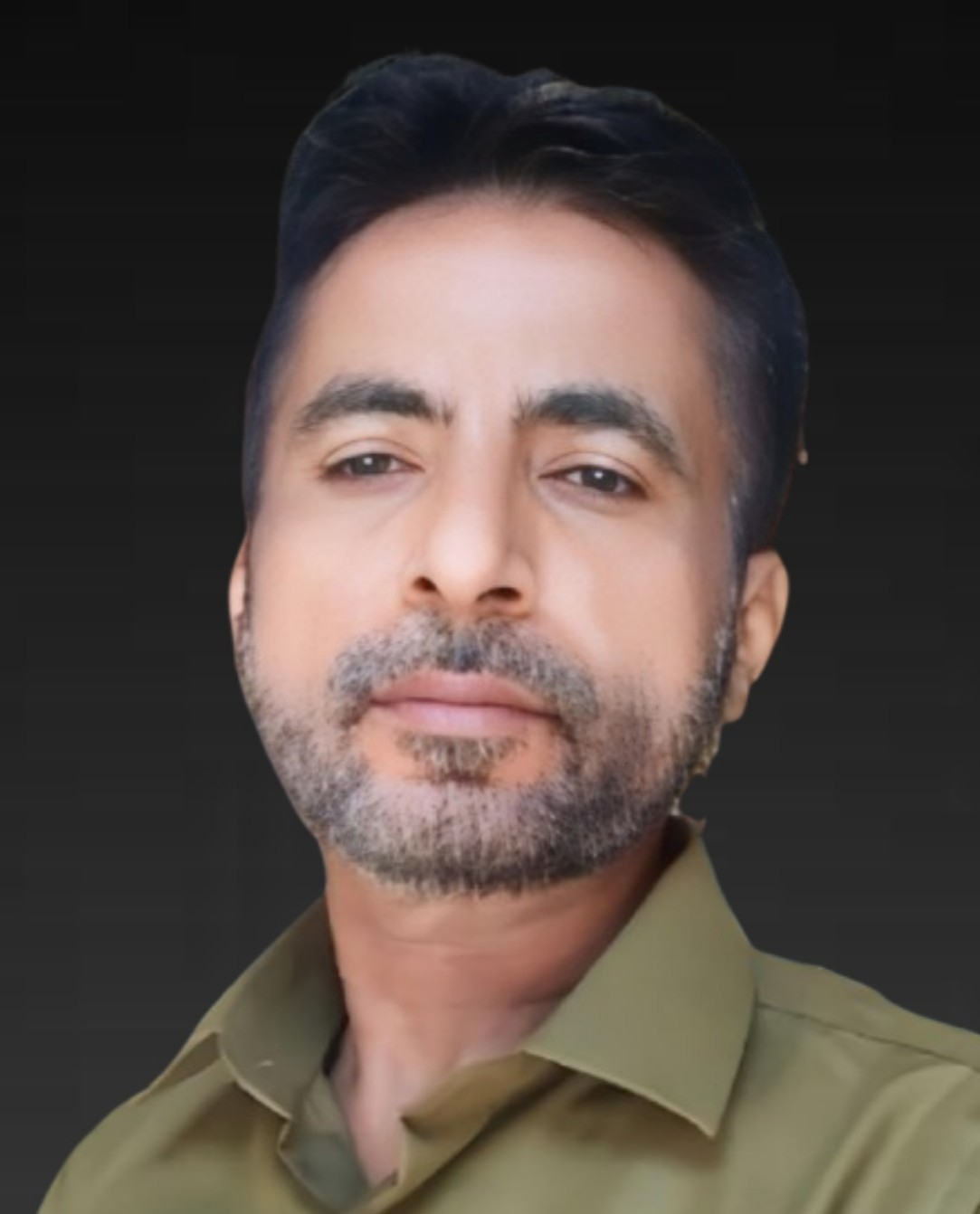الهوية على قياس النسب
لم تكن الطبقية في اليمن مجرد ظاهرة سطحية أو سلوك طارئ يمكن رده إلى الجهل أو التخلف وحدهما، بل كانت ولا تزال بنية اجتماعية عميقة، ترسخت عبر قرون، واستقرت في الوعي العام حتى غدت أشبه بنظام طبيعي للأشياء. نظام لا يُنظر إليه دائماً باعتباره ظلماً بل يُستقبل في كثير من الأحيان كقدر اجتماعي لا فكاك منه.
في هذا المجتمع لم يُقسم الناس وفق ما ينجزونه أو يضيفونه إلى المجال العام، بل بما يُنسب إليهم من أصول. لم يكن العمل هو المحدِّد الأول للمكانة، ولا الكفاءة معيار الصعود، بل النسب بوصفه هوية جاهزة، والدم بوصفه رأسمالاً رمزياً يسبق الفرد ويعلو عليه. هكذا تحوّل الانتماء السلالي من توصيف اجتماعي إلى أداة تصنيف، ومن سردية تاريخية إلى معيار للحق والوجاهة.
في قمة هذا البناء وقف "السادة"، لا باعتبارهم طبقة اجتماعية فحسب بل باعتبارهم فكرة مكتملة عن الحق. لم يكن حضورهم مجرد حضور أفراد داخل المجتمع، بل حضور فكرة متعالية عليه، مؤسسة على القداسة، تحوّل النسب إلى معنى سياسي، وتحولت القرابة من النبي إلى أساس للحكم، أو على الأقل إلى حصانة أخلاقية تحول دون المساءلة.
هنا لا نكون أمام امتياز اجتماعي فقط بل أمام احتكار للشرعية. فالحاكم لا يُسأل لأنه من آل البيت، والمعارض لا يُعارض إلا بقدر ما يسمح له هذا النسب أن يفعل. هكذا تماهى الدين مع السلطة لا بوصفه قيماً أخلاقية بل بوصفه سلطة نسبية مغلقة.
تحت هذه القمة جاءت طبقة "القضاة"، كانوا حراس النص ومهندسي الشرع، ووسطاء بين السلطة المقدسة والمجتمع. امتلكوا معرفة منحتهم احتراماً واسعاً، لكنهم ظلوا غالباً داخل الإطار لا خارجه. فالقاضي لم يكن ثائراً على النظام بل يُديره بمهارة. وهو إذ يفعل ذلك يمنح الطبقية لغة شرعية، ويحول العرف إلى قاعدة، والتمييز إلى اجتهاد، والتراتبية إلى نظام مشروع.
أما "المشايخ" فمثّلوا البعد الأرضي لهذا الترتيب الاجتماعي. سلطة تستند إلى القوة والعصبية، لا إلى القداسة. كانوا فاعلين في المجال السياسي، لكنهم ظلوا يدركون وجود مرجعية أعلى منهم، يتفاوضون معها ولا ينازعونها المعنى. علاقتهم بـ"السادة" لم تكن خضوعاً مطلقاً ولا صراعاً دائماً بل توازناً هشاً، تُدار بالحروب أحياناً والتحالفات أحياناً أخرى. كل ذلك كان على حساب المجتمع نفسه.
أسفل السلّم الاجتماعي وُضع أصحاب المهن، الذين يقوم عليهم الاقتصاد اليومي للحياة، دون أن يحظوا باعتراف رمزي يوازي دورهم. لم تكن الحرفة تُحتقر لأنها بلا قيمة، بل لأنها تذكّر الطبقات العليا بأنها تعيش على جهد غيرهم. هؤلاء لم يُستبعدوا من السلطة فقط بل من سردية الشرف الاجتماعي نفسها، فلا نسب يحميهم ولا سلاح يرفعهم، ولا خطاب ديني يمنحهم معنى.
ثم يأتي "المهمشون"، الذين وضعوا خارج النص كله، وخارج البنية برمتها. لا يُنظر إليهم بوصفهم جزءاً من المجتمع، بل بوصفهم عبئاً عليه. تداخل في تهميشهم الفقر والعنصرية والإرث العبودي، حتى صار وجودهم ذاته موضع تجاهل. هنا لا نكون أمام طبقية فقط، بل أمام إقصاء وجودي. المهمش لا يقصى من السلطة فحسب بل من الخيال الاجتماعي ذاته.
مع قيام الجمهورية، سقط رأس النظام الطبقي شكلياً، لكن بنيته العميقة ظلّت قائمة. انتهى الحكم السلالي، غير أن فكرة الامتياز لم تنتهِ. تغيرت أدواتها وأقنعتها. انتقلت من النسب إلى التحالف، ومن الدم إلى القوة المسلحة، ومن العمامة إلى البندقية. لم تُفكك الطبقية بل أعيد إنتاجها في أشكال جديدة. ظل الزواج معياراً طبقياً، والمكانة الاجتماعية إرثاً، والمهمش مهمشاً، حتى مع الشعارات الجديدة.
إن أخطر الأوهام هو الاعتقاد بأن الطبقية في اليمن مسألة من الماضي. فهي بنية حيّة، قادرة على التكيّف، بارعة في تغيير لغتها، لكنها نادراً ما تتخلى عن جوهرها. وما لم يُعاد تعريف اليمني بوصفه مواطناً لا سلالة، وقيمة لا نسباً، وحقاً لا امتيازاً، فإن أي تحوّل سياسي سيظل محصوراً في القمة، بينما يبقى الأساس، على حاله، صامتاً وصلباً.