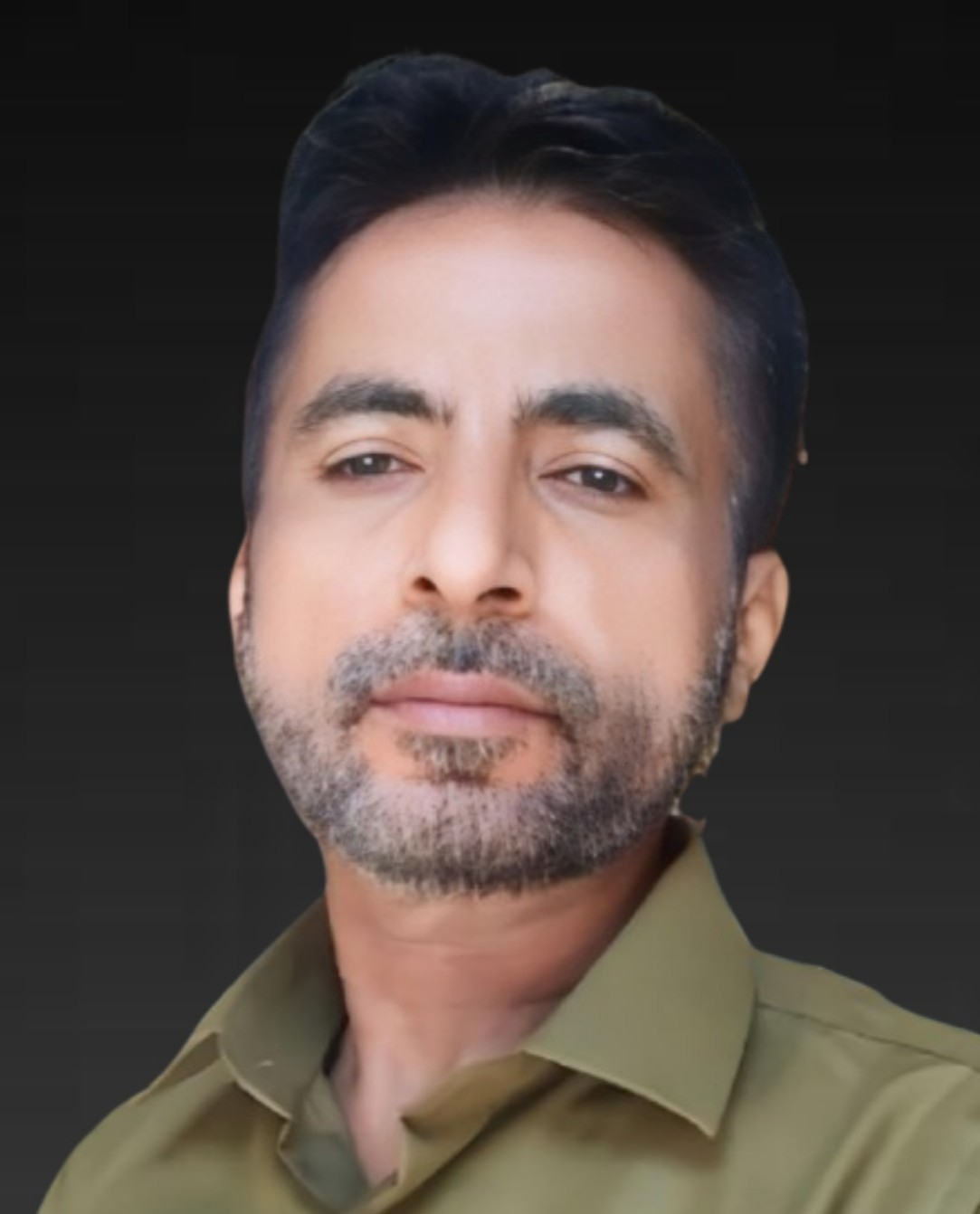الإخوان.. من لحظة التمكين إلى مأزق التصنيف
في اللحظة التي قفز فيها الإخوان إلى واجهة مشهد 2011، كان التاريخ كريماً بطريقة تثير الريبة. سلّم لهم مفتاح الباب، فانشغلوا بتلميع المفتاح أكثر من محاولة فتحه. التيار العقائدي داخل الجماعة صافح تلك اللحظة بذهنية مريد يستعد لليلة ذكر، لا بذهنية حزب سياسي يقف أمام مجتمع ينتظر حلولاً لا خطباً.
تخيل حركة أمضت ثمانين عاماً تنتظر لحظة فتح الباب. وحين فُتح أخيراً، وقفت خارجه تراجع دفاترها القديمة. حصلوا على "فرصة العمر"، تلك الجائزة الكبرى التي لا تمنحها الثورات عادة لمن يكتفون بالمشاركة اللفظية، لكن الإخوان استلموها بثقة تنظيم يظن أن عقارب الساعة تتحرك وفق توقيت المرشد.
في مصر بدا المشهد كأن الجماعة وصلت إلى الحكم لتستكمل دورة تدريبية في "إدارة الشعوب بالوعظ". تحول البرلمان إلى ملحق دعوي، والدولة إلى حقل تجارب لإثبات صحة أفكار سيد قطب، الرجل الذي ظل حكم الإخوان يُدار من ضلوعه أكثر مما يُدار من عقول قادتهم. ظنوا أن الشرعية كتاب منزل، وأن المجتمع جموع من الغافلين ينتظرون من يدلّهم على الطريق القويم. وحين بدأ الناس يفقدون صبرهم، اعتبر الإخوان ذلك دليلاً إضافياً على صحة المسار، كأن الرفض نوع من الطاعة.
وفي اليمن لم يكن المشهد أقل عبثية. دخلوا المرحلة الانتقالية وهم يلوّحون بأنهم قوة الثورة، ثم تصرفوا كأن الثورة ملكية خاصة مسجلة باسم مكتب الإرشاد. استعدوا القبائل، واستفزوا الحلفاء، وتخيلوا أنهم قادرون على بناء دولة حديثة بمنطق "غزوة انتخابية". كأن البلاد ساحة دعوة والمجتمع حلقة شباب يستمعون لدرس بعد المغرب.
أما النهضة في تونس فمثلت النسخة الدبلوماسية من الإرباك ذاته. حاولت التوفيق بين خطاب حداثي وبنية ذهنية تقليدية. وكعادة من يمشي بخطوتين متناقضتين، انزلقت في منتصف الطريق. لم تستطع التخلص من إرث الجماعة ولا تبنيه كاملاً، فبدت كمن يعتذر عما يفكر، ويدافع عمّا لا يريد.
والمفارقة التي تصلح للعرض في متحف السخرية السياسية أن كل هذا الانحدار حدث رغم الدعم الغربي، بما فيه الأمريكي. لكن الغرب، مهما بدا غافلاً، لا يثق طويلاً بحركة لا تفرّق بين إدارة دولة وإدارة جمعية خيرية.
التاريخ نفسه بدا متعباً من الدورات المتكررة. والولايات المتحدة، التي أمضت سنوات تتعامل مع الإخوان ككيان سياسي قابل للتوظيف، قررت أخيراً الخروج من حيادها البارد. بدأت مرحلة "التصنيف الأمريكي" للجماعة، خطوة متأخرة لكنها تفتح سؤالاً حرجاً: هل يستطيع الغرب التمييز بين الإخواني العقائدي المتخندق في ميراث سيد قطب، والإخواني البراغماتي الذي لا يسميها خلافة بل "تدبير مرحلة"؟
هنا تبدأ الحيرة الأمريكية. كيف تصنف حركة لها ألف وجه وألف خطاب؟ كيف تضع في خانة واحدة من يقرأ السياسة كمسطرة مدنية، ومن يقرأها كامتداد لسورة الأنفال؟
والحقيقة أن الجماعة نفسها لم تستطع يوماً التمييز بين جناحها السياسي وجناحها العقائدي. كلاهما يتحدث بلغتين مختلفتين، لكنهما يشتركان في رأس واحد؛ رأس يرى أن الدولة امتداد طبيعي للجماعة، وأن الشرعية روح تُسكب على الواقع لا عقد يبرمه الناس.
الإخوان يريدون من العالم أن يعاملهم كقوة سياسية حديثة، بينما هم يدخلون الدولة دون أن يغادروا منطق الجماعة. يريدون حكم عالم حديث، بأدوات خطاب صيغ قبل نصف قرن، وبعقلية تعبئة جماهيرية لا عقلية إدارة دولة.
والحقيقة الصغيرة التي يهربون منها كبيرة بآثارها. لم يفشل الإخوان لأنهم مضطهدون، بل لأنهم حين وصلوا إلى السلطة تصرفوا كأنهم وصلوا إلى محراب. وحين طلب منهم المجتمع حلولاً، قدموا له اقتباسات. وحين طلب دولة، أعطوه "مشروع تمكين". وحين قدمت لهم الثورات مفتاح الباب، استخدموه مسبحة.
منحهم التاريخ فرصة العمر، لكنهم دخلوها بـ "عدة الدعوة" لا بأدوات السياسة. فبدت اللحظة الثورية اختباراً قاسياً، كشف أن الجماعة مهما تجمّلت، ما تزال تشبه نفسها أكثر مما تشبه العصر.
والآن، بعد أن أصبحت الجماعة موضوعاً للتصنيف الأمريكي، يبقى سؤال واحد يطاردها منذ 2011 بلا إجابة: هل هي حزب يريد المنافسة، أم جماعة تريد أن تهدي العالم خلاصاً مؤجلاً؟
ما نعرفه فقط أنهم كانوا أمام باب الدولة. لكنهم أصروا على إلقاء الخطب بدلاً من الدخول.