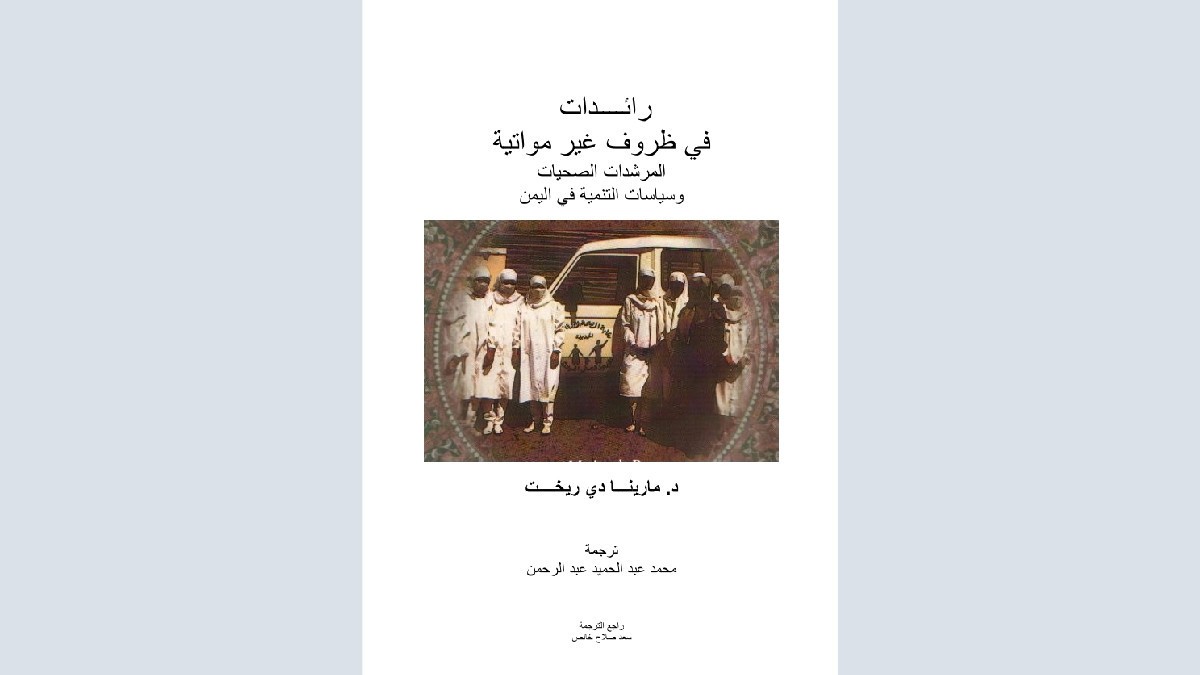رائدات في ظروف غير مواتية 9 - تاريخ موجز لليمن الحديث
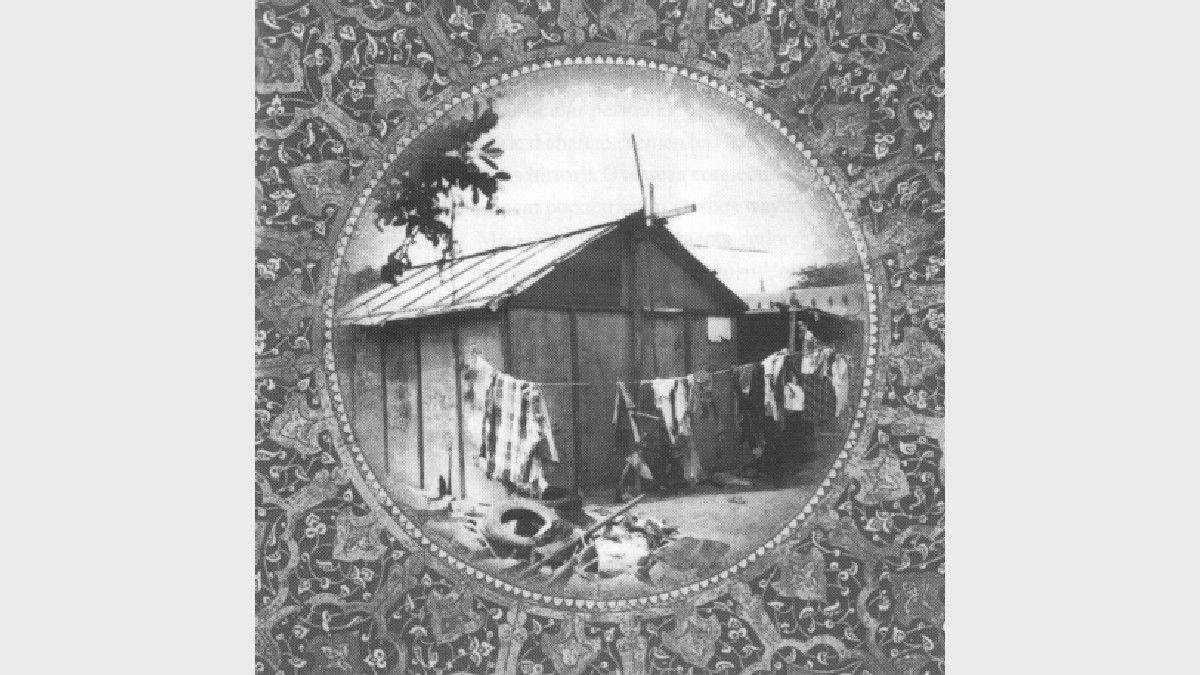
في هذا الفصل، تضع المؤلفة الأساس التاريخي والسياسي لفهم سياق التنمية في اليمن، وتتجاوز الصورة النمطية لليمن كدولة منعزلة. يستعرض الفصل رحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة، بدءًا من فترة حكم الأئمة، مرورًا بثورة 1962، والحروب الأهلية، والوحدة، وصولًا إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تلتها. ويركز بشكل خاص على كيفية تشكل السياسات التنموية في مجالين حيويين: المرأة والرعاية الصحية. يوضح الفصل الخطاب الرسمي المزدوج تجاه المرأة، الذي شجع تعليمها وعملها نظريًا بينما أبقى على الأدوار التقليدية، ويحلل تطور قطاع الرعاية الصحية الذي ظل يعتمد بشكل كبير على المانحين الأجانب وتأثر بالصراعات السياسية الداخلية.
هذا الكتاب
قرى متناثرة على قمم الجبال العالية، رجال يتمنطقون بالخناجر (الجنبيات) ويمضغون القات ونساء مغطيات من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، تلك هي الصورة النمطية لليمن في الغرب. ويصاحب هذه الصورة دائما التأكيد على أن اليمن يمكن مقارنته ببلد كان يعيش العصور الوسطى، معزولا عن بقية العالم إلى أن بدأت فيها التنمية بعد ثورة عام 1962. لكن الصورة التي تشي بها هذه التأكيدات مضللة وتستبطن قيما معيارية لما تعنيه التنمية. أسهمت مثل هذه التعميمات في ترسيخ فكرة أن اليمن كان بلدا منعزلا متخلفا لا تحدث فيه تغييرات.
بالرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا جزئيا لفترة معينة من تاريخ اليمن إلا أنها تتجاهل مئات السنوات من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية إذ كان لليمن مكانة دولية مهمة في العديد من فترات تاريخها. وقد أثرت الصلات الدولية بواسطة التجارة والهجرة على سكان اليمن بصور متنوعة ليس اقلها ما نتج عن ذلك من تنوع عرقي في اليمن، فضلا على أن هذه التأكيدات تعزز ضمنيا فكرة أن الاتصال بالغرب هو الطريق الوحيد المؤدي إلى التنمية ولا تعترف إلا بالمفهوم الغربي للتنمية. في هذا الفصل سأفحص عن قرب الخطابات اليمنية للتنمية بوصف تشكل الدولة الوطنية اليمنية أولا ثم بتحليل خطابات التنمية فيما يتصل بالمرأة والرعاية الصحية. سأركز في الفصل الرابع على خطابات التنمية اليمنية والترجمة العملية لهذه الخطابات على المستوى المحلي للمشروع.
3.1 تاريخ موجز لليمن الحديث[34]
كانت اليمن دولة إمامية يحكمها رجال الدين لعدة قرون، وعندما يقول الناس أن اليمن كانت دولة معزولة فإنهم يشيرون إلى فترتي حكم الإمام يحي (1904 – 1948) وابنه الإمام احمد (1948- 1962) وقد فرض هذان الإمامان عزلة دولية على اليمن، وخاصة عن العالم الغربي، للحفاظ على أوضاعهم[35]. لم تكن الحكومة تشجع اليمنيين على السفر إلى الخارج، وكان التعليم مقصورا على المدارس الملحقة بالمساجد وجهدت الحكومة على تفادى أية صلة تعاقدية مع الأجانب حكومات وشركات وأفراد ما أمكن، وسمح لعدد قليل جدا من الأجانب بدخول البلاد وأخضعت تحركاتهم للرقابة (Stookey 1978: 186)[36]. لم يكن الإمام يحي مؤيدا للتعليم العام وحال دون إنشاء المدارس الحديثة[37]. وكان تعلم القراءة والكتابة مقصورا على النخبة "ومرتبطا بالوجاهة الاجتماعية، الوظائف المميزة والانتماء للبيوتات المتنفذة" (Messick 1983: 44).
بالرغم من السياسات الانعزالية للإمامين يحي واحمد فقد تمكن عدد مقدر من اليمنيين من الهجرة للخارج للعمل أو الدراسة وقد غادر العديد من اليمنيين النشطين وذوي الطموحات التجارية الذين أحبطتهم الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى عدن، المملكة العربية السعودية، شرق أفريقيا، جنوب شرق آسيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تبنى العديد من هؤلاء اليمنيين، خاصة الذين تلقوا تعليمهم في الخارج، وجهات نظر حديثة وأصبحوا يؤمنون بأن الدولة القوية يجب أن توفر مستواُ معيشيا أفضل لسكانها. وكان الرئيس المصري جمال عبد الناصر مصدر الهام قوي لهم بدعوته إلى حركة عربية موحدة ضد الاحتلال والقمع في العالم العربي cf. Zabarah 1982)). في اليمن الجنوبي بدأ المثقفون في الثورة على الاحتلال البريطاني[38]، بينما بدأ الإصلاحيون التقدميون الذين ألهمتهم الأيدلوجيا الناصرية والمحافظون التقليديون الرافضون لتسلط الإمام في انتقاد الإمامة. وفي نفس الوقت تقريبا بدأت عودة العديد من المهاجرين اليمنيين تحت ضغوط الظروف الاقتصادية السياسية التي نجمت عن توسع الحركات الوطنية التي تناضل ضد الاحتلال في بعض بلدان التي هاجر إليها اليمنيون[39]. وكان هؤلاء المهاجرون العائدون ناقمين على الأوضاع التي واجهتهم عند عودتهم إلى بلادهم وكثيري الانتقاد لها مما أدي إلى تزايد النقمة وانتقاد الإمامة بشكل عام. وشكل القرويون في الأرياف جمعيات للتنمية المحلية (cf. Carapico 1998). إضافة لتزايد المقاومة ضد نظام الإمام. وبتصاعد النقمة وحركة المقاومة. تمكنت مجموعة من الضباط من الاستيلاء على السلطة عام 1962 وأعلنوا اليمن جمهورية عربية. نجم عن ذلك اشتعال حرب أهلية دامت سبع سنوات بين أنصار الإمام المدعومين ماليا من السعودية وأنصار الجمهورية الذين كانت تدعمهم القوات المصرية[40].وفي عام 1970 اعترفت المملكة العربية السعودية بالجمهورية العربية اليمنية رسميا أعقب ذلك اعتراف المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بها.
تكونت الحكومة التي شكلت عام 1970 من خليط من الجمهوريين والملكيين كما تضمن الدستور الذي عمل به في ذات العام توجهات وطنية استلهمت الأيديولوجيا الناصرية مع توجهات أخرى محافظة في نفس الوقت. وكان الصراع على السلطة والخلافات المزمنة هو أهم ما يميز السياسية اليمنية وقتها إذ انه في الوقت الذي كانت تعمل فيه الحكومة على بسط نفوذها في كل اليمن الشمالي احتفظ شيوخ القبائل بمواقع نفوذ ومواطئ أقدام في المناطق الريفية ولم يقبلوا بتدخل الحكومة المركزية في شؤونهم، إضافة إلى رفض شيوخ القبائل الذين أيدوا الملكية القبول بالحكومة الجديدة واستمرارهم في تحدى سلطتها، كما تفشى الفساد[41] وإساءة استخدام السلطة وسط العدد المتزايد من موظفي الدولة وأصبحت الصلات الشخصية هي المفتاح الوحيد للمسؤولين الحكوميين. وكان من المستحيل على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لمثل هذا الوضع مع الحفاظ على السلام مع جميع الأطراف. وتشير حقيقة تعاقب أربعة رؤساء على الجمهورية الوليدة، مات اثنان منها مقتولين، خلال عشر سنوات فقط إلى المصاعب الجمة التي واجهتها القيادة السياسية في اليمن الشمالي[42].
بدأت الشركات والمنظمات المانحة الأجنبية اهتمامها باليمن بعد عام 1962 مباشرة وأظهرت الدول العربية والغربية رغبة في الاستثمار في اليمن بسبب موقعها الاستراتيجي على حافة الجزيرة العربية، بالنسبة للحكومات العربية الأخرى مثل السعودية والكويت كان من الضروري ألا تصبح الجمهورية العربية اليمنية مكتملة الاستقلال بتوجهاتها الجمهورية التي تهدد سلطة النخب المحافظة التي تتولى الحكم في بقية دول شبه الجزيرة العربية، كما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الغربية عقب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 ولم تستأنف إلا عام 1972Halliday (1974:142) . نظرت حكومات الدول الغربية إلى اليمن كحليف مهم لموازنة نفوذ النخب الحاكمة في السعودية وبقية دول الخليج، علاوة على أن الأزمة النفطية التي أعقبت حرب 1973 قد أوضحت للدول الغربية أهمية الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة العربية وتحسين العلاقات بدولها لاستمرار تدفق الإمدادات النفطية وارتأت هذه الدول أن الاستثمار في اليمن وسيلة لتعزيز وضعها في هذه المنطقة. كانت الحكومة الهولندية من الحكومات التي بدأت في تمويل مشاريع وبرامج التنمية في الجمهورية العربية اليمنية وأصبحت فيما بعد واحدة من أهم وأكبر المانحين الأجانب لليمن.
وفي حين اسُتلهمت الخطابات التنموية اليمنية من أفكار التنمية الناصرية التي شددت على القومية العربية، معاداة الإمبريالية والاعتماد على الذات في الخمسينيات والستينيات، بدأت المفاهيم الغربية للتنمية تصل إلى اليمن في أواسط السبعينيات بأفكارها حول السوق الحر، والاستثمار الأجنبي والمساعدات الخارجية وتكتسب مزيدا من الأهمية. وبالرغم من ذلك بقيت الأهداف العملية لهذه الأيدولوجيات المتباينة على حالها وهي تتمثل في خلق اقتصاد قوي، وتوفير خدمات الصحة والتعليم للشعب وإزالة الفقر.
صدر الكتاب الإحصائي السنوي الأول للجمهورية العربية اليمنية عام 1971 بمساعدة من البنك الدولي. (Weiter 1988: 419). واعدت أول خطة تنمية ثلاثية بناء على هذا الكتاب عام [43]1973 وقد ركزت هذه الخطة على إنشاء البنيات الأساسية[44]. في عام 1975 صنفت اليمن رسميا ضمن الدول الأقل نموا وهو تصنيف الأمم المتحدة للدول التي يقل نصيب الفرد من الدخل القومي فيها عن 300 دولار أمريكي في السنة. خلال العقود التالية انخرط العديد من المانحين الإقليميين والدوليين في تنمية اليمن الشمالي " ساهم تقريبا كل المانحين على النطاق والدولي والثنائي والشرق أوسطي، بغض النظر عن تباين الأيديولوجيات، في تقديم العون التنموي لليمن والذي بلغ حوالي مليار دولار عام 1980 ثم تراجع بعدها ليصل إلى نصف مليار دولار عام 1985 وتدنت إلى مائة مليون دولار فقط عام 1988" (Carapico 1998: 43). وبالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، مول المانحون الأوربيون والبنك الدولي والأمم المتحدة دعم الوزارات الرئيسية ودربوا اليمنيين على بناء وإدارة المؤسسات وساهمت الكويت وعدد من الدول العربية في تطوير نظام التعليم العام ببناء المدارس وتوظيف المدرسين الأجانب للعمل فيها (مصدر سابق) [45].
في الوقت التي بدأت فيه الشركات الأجنبية والمنظمات المانحة اهتمامها باليمن غادرت أعداد كبيرة من اليمنيين بلادهم، إذ تزامن تأسيس الجمهورية العربية اليمنية مع الطفرة النفطية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي نتجت عن الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول.
كان هنالك طلب كبير على العمالة غير الماهرة في الدول المنتجة للبترول في شبه الجزيرة العربية وقرر آلاف اليمنيين تجربة حظهم هناك[46]. وخلال وقت قصير أصبحت التحويلات التي يبعث بها المهاجرون اليمنيون مصدر دخل مهم للدولة اليمنية، لكن النقص الكبير في المهارات المتخصصة في اليمن دفع بآلاف الأجانب إلى اليمن أيضا، وفقا لدريش (2000: 133) كان ما يربو على الخمسين ألف أجنبيا يعملون في اليمن في منتصف السبعينيات منهم بناة طرق صينيون، مدرسون مصريون، أطباء وممرضون سودانيون، متطوعو سلام أمريكيون وآخرون كثر، كما تم تشجيع المهاجرين اليمنيين الذين كانوا في الخارج وحصلوا على تعليم افضل على العودة للبلاد بوعود بحياة افضل في اليمن للإسهام في تنميتها خاصة في عهد الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي 1974 – 1977، حيث عاد إلى البلاد عدد كبير من اليمنيين الذين كانوا يعيشون في الخارج وخاصة في شرق أفريقيا، وكانت الظروف السياسية المتغيرة في بلدان المهجر سببا إضافيا لعودة المزيد منهم الى بلادهم[47].
وقد قرر بعض هؤلاء العائدين الهجرة ثانية إلى السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص أفضل. وبالرغم من تغير عدد من الرؤساء فقد اتسم الوضع في اليمن في السبعينات بالتفاؤل إذ استمرت تحويلات المغتربين والمعونات الأجنبية في التصاعد وتوسع قطاع الأعمال والتجارة الوطني والأجنبي وتكاثرت مشروعات التنمية "ويبدو أن أية حفرة في الأرض أصبحت تسمى مشروعا في تلك الأيام" (مصدر سابق 133).
وهكذا نجد أن المساعدات الأجنبية والعمالة المهاجرة أصبحتا عماد اقتصاد الجمهورية العربية اليمنية منذ وقت مبكر، وكان لهذا الاعتماد الكبير على مصادر تمويل خارجية تبعات مهمة أولها أن توفر العملات الأجنبية أدى إلى تزايد الاستيراد لأنواع جديدة من السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الراديو والمسجلات والتلفزيون والبطاريات والحليب المجفف وبحلول عام 1977 كانت اليمن تستورد 40% من احتياجاتها من المواد الغذائية (مصدر سابق).
وكان لهذا التطور إثر سلبي على القطاع الزراعي في اليمن إذ آثر المزارعون التحول عن زراعة الحبوب والخضراوات إلى المزيد من زراعة القات ذو الربحية الأعلى، ولم تفعل الحكومة إلا القليل لمنع انهيار القطاع الزراعي وكانت سياسة "دعه يعمل" هذه أكثر وضوحا في الجهود المتواضعة جدا لإنشاء قطاع صناعي، حيث كان رجال الأعمال أكثر حرصا على شراء الأراضي وتشييد المنازل من الاستثمار في الصناعة ولم يمنعهم شيء من المضي قدما في ذلك (مصدر سابق 137).
ومن التبعات الباهظة الأخرى للاعتماد المفرط على مصادر التمويل الخارجية هشاشة تلك المصادر فعلى سبيل المثال تناقصت فرص العمالة في السعودية ودول الخليج في منتصف الثمانينيات نتيجة لانخفاض أسعار البترول وبدأ بعض المهاجرين اليمنيين في العودة الى بلادهم، وقد إثر ذلك سلبا على الاقتصاد اليمني بتراجع تحويلات المغتربين في وقت تزايد فيه عدد السكان[48]. وكان الأثر الثالث للاعتماد على مصادر التمويل الأجنبي هو النفوذ الكبير للمانحين الأجانب على تشكيل الدولة اليمنية.
شدد الممولون الأجانب ضمن برامج العون الثنائي والدولي على حد سواء على بناء المؤسسات وأقيمت وزارات ضخمة أدت إلى مضاعفة أعداد الموظفين الحكوميين (مصدر سابق 133، 159). في السبعينيات كان بوسع كل من يحمل شهادة إكمال الدراسة الابتدائية أن يحصل على وظيفة حكومية وأصبحت الحكومة أكبر مخدم (رب عمل) في البلاد مانحة موظفيها عقودا للعمل مدى الحيّاة مع كل امتيازات العطلات وعطلات المرض والولادة والتامين الصحي.
خلال وقت قصير تحولت الدولة إلى جهاز متضخم ومثقل يعمل من أعلى إلى أسفل بشكل رئيسي. وفقدت الشعارات الثورية للستينيات والسبعينيات بريقها وقيمتها عندما سيطر المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس على عبد الله صالح[49] منذ تسلمه السلطة عام 1978، على كل المبادرات المحلية ودمجها في برامج الحكومة، " وإذا كانت كلمة "مشروع" هي الكلمة المفتاحية في السبعينيات فقد أصبحت كلمة "برامج" تلعب نفس الدور الثمانينيات" (Dresch 2000: 160). ومع ذلك بقيت نصف الموازنة الحكومية توجه للجيش والشرطة بينما كانت مشاريع التنمية تمول بواسطة المنح والقروض الأجنبية (Carapico 1993: 13; Dresch 2000: 157). اضطرت الحكومة إلى تخفيض نفقاتها في النصف الثاني من الثمانينيات بسبب الركود الاقتصادي العالمي وتزايد عدد السكان في اليمن بعد عودة أعداد كبيرة من المغتربين وتناقص التحويلات والمساعدات الأجنبية[50]. وكان من نتائج هذه الإجراءات أن أصبح الحصول على الشهادة الإعدادية[51] شرطا للحصول على وظيفة حكومية بدلا من الابتدائية وقلت الوظائف الحكومية. لقد تحول النظام الإداري اليمني إلى "نظام إقطاعي" حيث تتيح الصلات الشخصية الجيدة بالمسؤولين الحكوميين مداخل مضمونة للاقتصاد النقدي وأكثر أهمية من العمل والادخار (مصدر سابق 164، 179) وازدهر الفساد والمحسوبية.
بتحقيق الوحدة اليمنية في مايو عام 1990 انطلقت مرحلة جديدة من التاريخ اليمني. اتبعت الدولتان اليمنيتان توجهات متباينة منذ أواخر الستينيات حيث كانت دولة الشمال جمهورية محافظة رأسمالية بينما كانت دولة الجنوب اشتراكية. وقد اتسمت علاقتهما بالعداء لكن نهاية الحرب الباردة أدت إلى تغير المناخ السياسي وأصبحت الوحدة قابلة للتفاوض عليها بعد سنوات من التوتر والصراع. وشكلت حكومة انتقالية من المحافظين في الشمال والاشتراكيين في الجنوب لثلاثة سنوات على أن تعقبها انتخابات حرة لبرلمان بتعددية حزبية في أبريل عام 1993. بتحقق الوحدة ساد اليمن مناخ ديمقراطي ازدهرت فيه الصحافة الحرة والتعددية الحزبية ونشأت منظمات غير حكومية متنوعة ولجان من كل الأنواع نمت كالفطر في كل مكان (Carapico 135 - 136) كانت التجربة الديمقراطية الأولى في شبه الجزيرة العربية التي منحت الأمل لليمنيين لكن الحكومة السعودية تابعتها بقلق واضح.
لكن ذلك المناخ المفعم بالأمل سرعان ما تبدد خلال أشهر بالغزو العراقي للكويت ونشوب أزمة الخليج بنتائجها الدرامية على الجمهورية اليمنية الموحدة الوليدة. بدلت حكومات المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى حقوق الإقامة التي كانت تمنحها لليمنيين[52] بسبب معارضة اليمن التي كانت عضوا في المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأي عمل عسكري ضد العراق ودعوتها لحل عربي عاد إلى اليمن 800 ألف مغترب يمني وعائلاتهم من السعودية ودول الخليج.
كان لهذه العودة الجماعية أثر مدمر على الاقتصاد اليمني (cf. Addleton 1991; Van Hear 1994). ولم تفقد البلاد تحويلات المغتربين، إحدى أهم مصادر دخلها فحسب بل كان عليها أن تعتني وفجأة بمئات الآلاف من العائدين وتوفر لهم المأوى والمأكل والعمل والرعاية الصحية ولم يكن من المدهش ألا تتمكن الدولة اليمنية من التعامل مع هذه الكارثة المفاجئة بشكل مناسب. كما أن موقف اليمن خلال أزمة الخليج أدى أيضا إلى رحيل العديد من الشركات والمنظمات الأجنبية المانحة الغربية في وقت كانت اليمن فيه أحوج ما تكون لعونهم.
أدت أزمة الخليج والأزمات الاقتصادية التي واجهتها اليمن نتيجة لها إلى توتر فوري بين الحزبين الحاكمين الذين يرأسهما الرئيس على عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض[53]. تعذر الاتفاق بينهما على كيفية إدارة البلاد وحل مشاكلها ولم يتحقق إلا القليل مما وعدوا به الناس عقب الوحدة إضافة إلى انه أصبح من الواضح أن القوانين والأعراف التي كانت متبعة في الشمال أصبحت هي السائدة في دولة الوحدة مما تسبب في المزيد من الإحباط والتوتر في أوساط الاشتراكيين. جرت الانتخابات الديمقراطية الأولى في أبريل 1993 أسفر عنها تحالف حاكم بين المؤتمر الشعبي العام المحافظ والحزب الاشتراكي اليمني وحزب الإصلاح[54] انهار بعد عام واحد. وفي مايو 1994 انفجرت الحرب الأهلية بين الجيشين الشمالي والجنوبي وانتهت بانتصار الجيش الشمالي في 7 يوليو 1994. نتيجة ذلك تضاءل تأثير الاشتراكيين على المشهد السياسي وتقدم حزب الإصلاح لملء الفراغ، وعاد للسلطة تحالف محافظ وبسيطرة محكمة على الشمال والجنوب هذه المرة.
كان الوضع الاقتصادي كارثياً ليس فقط بسبب الحرب الأهلية المكلفة بل أيضا لانهيار أسعار النفط الخام وانسحاب المنظمات الأجنبية المانحة. أعلنت الحكومة اليمنية الجديدة العديد من الخطط والبرامج للإصلاح وإعادة بناء البلاد انتشال الاقتصاد وإعادة تنظيمه (Carapico 1988: 58) واتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي بما في ذلك تخفيض سعر تبادل الريال اليمني، إلغاء الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والدقيق وزيت الطعام وتجميد التوظيف في الحكومة[55]. بالنسبة لغالبية اليمنيين كانت هذه الإصلاحات تعني المزيد من التدهور في مستوى معيشتهم، ارتفاع تكاليف المعيشة، تدنى المرتبات والأجور تصاعد ومعدلات البطالة. وللتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الهيكلي أسس البنك الدولي صندوقا للتنمية لتمويل المشروعات التي تستهدف الحد من الفقر.
وبالرغم من ذلك فقد نجم عن ذلك إعادة إنتاج أنماط عدم المساواة الموجودة أصلا بدلا عن إزالة الفقر. ولم تتلاش الفروق بين العلاقات الشخصية والعلاقات السياسية فحسب بل أصبحت الحدود الفاصلة بين السياسي ورجل الأعمال أيضا شديدة الضبابية والالتباس. متشجعين بالدعوة إلى الخصخصة عمد الكثير من الساسة إلى شراء أسهم الشركات المهمة للحفاظ على مصادرهم للعملات الأجنبية. فعلت المنظمات المانحة الأجنبية القليل جدا لمكافحة هذا النهج الحكومي ذي الوجهين لأن ذلك كان سيعني تفكيك الدولة بأكملها (مصدر سابق 208). جرت انتخابات عامة جديدة عام 1997 لكنها لم تؤد إلى تغيرات كبيرة واحتفظ المؤتمر الشعبي العام بأغلبيته المريحة[56]. وينطبق ذلك تماما على انتخابات عام 2001 التي أعقبها على أية حال تعيين د. وهيبة فارع وزيرة لحقوق الإنسان لتصبح أول امرأة يمنية تتولى منصب وزير، كما سنوضح لاحقا يمكن أن يعتبرا هذا مثالا جيدا لسياسات الهوية التي تتبعها الحكومات باستخدام المرأة كرمز للحداثة لإرضاء المنظمات الأجنبية المانحة.
عن المؤلفة
هوامش ومراجع:
[34] بما أن هذا البحث يتناول مشروعا للتنمية في الحديدة الواقعة في اليمن الشمالي فإنني سأستبعد اليمن الجنوبي ما لم يكن الأمر متعلقا بموضوع هذه الدراسة.
[35] كل الوظائف الهامة كان يشغلها أقارب الإمام اللصيقين والمنتمين إلى العائلات المتنفذة الأخرى (Burrowes 1986: 18).
في عهد الإمام يحي تم التوصل إلى نظام حكومي يضم وزراء ومجلس للوزراء (Dresch 2000:65)
[36] ينقل ديرش (Dresch 2000:50) عن الإمام يحي قوله انه يفضل أن يأكل هو وشعبه التبن على أن يسمح للأجانب بالدخول إلى اليمن لتطوير مواردها.
[37] بالعكس من الرأي الشائع بأن اليمن لم تشهد تغييرات أثناء فترة الإمامة يعطي ميسيك صورة مثيرة للاهتمام عن المدارس الحديثة التي أنشأها الأتراك العثمانيون في اليمن والنظام المدرسي المتغير في اليمن الإمامية (Messick 1983: 44) في كتابه عن العلاقات المتغيرة بين النصوص المكتوبة والدولة في اليمن الإمامية.
[38] كانت عدن محمية بريطانية من 1839 إلى 1967.
[39] أشير هنا إلى حركات التحرر في أثيوبيا، كينيا، تنزانيا، الهند وإندونيسيا التي كان يعيش فيها أعدادا كبيرة من اليمنيين.
[40] كان الدور المصري في هذه الحرب كبيرا جدا إلى الحد الذي يمكن الحديث فيه عن علاقات استعمار جديدة، فعلاوة على الأعداد الكبيرة من القوات المصرية في اليمن دخل إليها أيضا عدد كبير من المدنيين المصريين الذين أنشأوا جهازا حكوميا جديدا تضمن وزارات ومصالح وهيئات حكومية وهيئات شبه حكومية مماثلة للأجهزة الحكومية المصرية وظهر خلال السنة الأولى من دخول المصريين طبقة من حوالي أربعة آلاف من الموظفين الحكوميين (Dresch 2000: 95). لكن هذا الجهاز الحكومي كان ضعيف الفعالية بسبب من سيطرة المصريين عليه وقلة خبرة اليمنيين في الإدارة الحكومية الحديثة وعدم مناسبته لاحتياجات اليمن (Burrowes 1986: 25).
[41] في عام 1969 كان هناك ثلاثة عشر ألف موظف حكومي في أواسط السبعينيات ارتفع هذا الرقم إلى ثلاثين ألفا. (Dresch 2000: 95).
[42] لنظرة تفصيلية للتاريخ السياسي لليمن راجع Halliday (1974) Peeterson (1974) Zubara (1982) Stookey (1978) Burrowes (1986). Dresch (200) (1987).
[43] منذ عام 1974 تم وضع ستة خطط تنمية وكان لكل خطة أولوياتها وتطلعاتها الخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل. كل خطط التنمية وضعت وفقا للمتطلبات والشروط التي وضعتها الدول المانحة، ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
[44] كان إنشاء الطرق هو أكبر مكونات برنامج الاستثمار اليمني حيث أن تحسين الطرق والاتصالات واحدة من أولويات التنمية لتسهيل التجارة والوصول إلى الأسواق وتسريع نمو الزراعة والصناعة كما أنها ستعزز سيطرة الدولة على البلاد (Gascoigne 1986: 11).
[45] كان هناك نقص حاد في المدرسين والمدرسات اليمنيين لذلك عمل عدد كبير من المدرسين المصريين والسودانيين والسوريين في اليمن وكان العديد منهم من المتدينين المحافظين الذين تدفع السعودية مرتباتهم لتدعيم أيديولوجيتها الدينية. ((Carapico 1988: 41
[46] في عام 1970 كان هناك 300 ألف يمني يعملون في الدول النفطية في شبه الجزيرة العربية (Dresch 2000:119) بنهاية نفس العقد ارتفع ذلك الرقم إلى 800 ألف (مصدر سابق 131)
[47] أسهمت حملة التأميم في إثيوبيا والقوانين التي صدرت لمصلحة التجار الأثيوبيين على حساب التجار الأجانب في عودة الآلاف من اليمنيين لبلادهم وصلت موجات العائدين من إثيوبيا ذروتها عام 1974 عندما عمدت الحكومة الأثيوبية الاشتراكية الجديدة إلى مصادرة ممتلكات الأجانب (Meyer 1986: 17).
[48] إضافة إلى الأحداث الدموية في اليمن الجنوبي عقب محاولة الانقلاب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص عام 1983 حيث لجأ حوالي ثلاثين ألف من اليمن الجنوبي إلى الشمال بمن فيه الرئيس الجنوبي السابق على ناصر (Dresch 2000:269).
[49] أسس المؤتمر الشعبي العام عام 1982 ليكون أداة للمشاركة السياسية والتعبئة، عمليا تحول المؤتمر الشعبي العام إلى حزب سياسي وبقي الحزب السياسي الوحيد في شمال اليمن حتى قيام الوحدة علم 1990 (Wenner 1991: 158).
[50] بلغت المساعدات التنموية لليمن أكثر من مليار دولار عام 1981 وانخفضت إلى نصف مليار عام 1985 ثم تقلصت إلى اقل من مائة مليون دولار عام 1988. (Carapico 1993:13).
[51] كان النظام التعليمي المصري هو النموذج المتبع في اليمن الشمالي بتعليم عام يتكون من ثلاثة مراحل، المرحلة الابتدائية لستة سنوات ثم المرحلة الإعدادية لثلاثة سنوات ثم المرحلة الثانوية لثلاثة سنوات.
[52] بينما كان كل العاملين الأجانب في السعودية يحتاجون لكفيل محلي للإقامة والعمل في السعودية ودول الخليج كان مسموحا لليمنيين العمل بدون كفيل أو إذن إقامة، فقد اليمنيون ذلك الوضع المميز اعتبارا من 19 سبتمبر1990.
[53] كانت حكومة الجمهورية العربية اليمنية حليفة للعراق بينما كانت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية معارضة للعراق.
[54] تأسس حزب التجمع اليمني للإصلاح عام 1990 وهو تحالف يعتمد على الشماليين المحافظين الذين يجمعهم موقف موحد ضد الاشتراكية وأهداف اجتماعية محافظة (Clark forthcoming)، غالبا ما يعتقد الكثيرين مخطئين أن الإصلاح حزب أصولي ذو خصائص مشتركة مع حركة الإخوان المسلمين، لكن أهداف الإصلاح وموقعه في المؤسسة السياسية اليمنية أكثر تعقيدا من ذلك (cf. Dresch and Haykel 1995).
[55] تضمن برنامج الإصلاح الهيكلي فصل ثلاثين ألف موظفا حكوميا من أصل سبعمائة ألف (Detalle 1997: 27) لكن الضغوط الداخلية أدت إلى التخلي عن هذه الخطة. تتولى وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تحديد شروط خدمة موظفي الدولة، بينما تتولى وزارة المالية دفع رواتبهم وتقوم الوزارات الأخرى بإدارة ومراقبة عملهم اليومي. هناك خطة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية (Al-Dubai 2000: 42).
[56] في الانتخابات الرئاسية حصل الرئيس علي عبد الله على 96.3% من الأصوات مما يضع التجربة الديمقراطية اليمنية موضع تساؤل جدي.