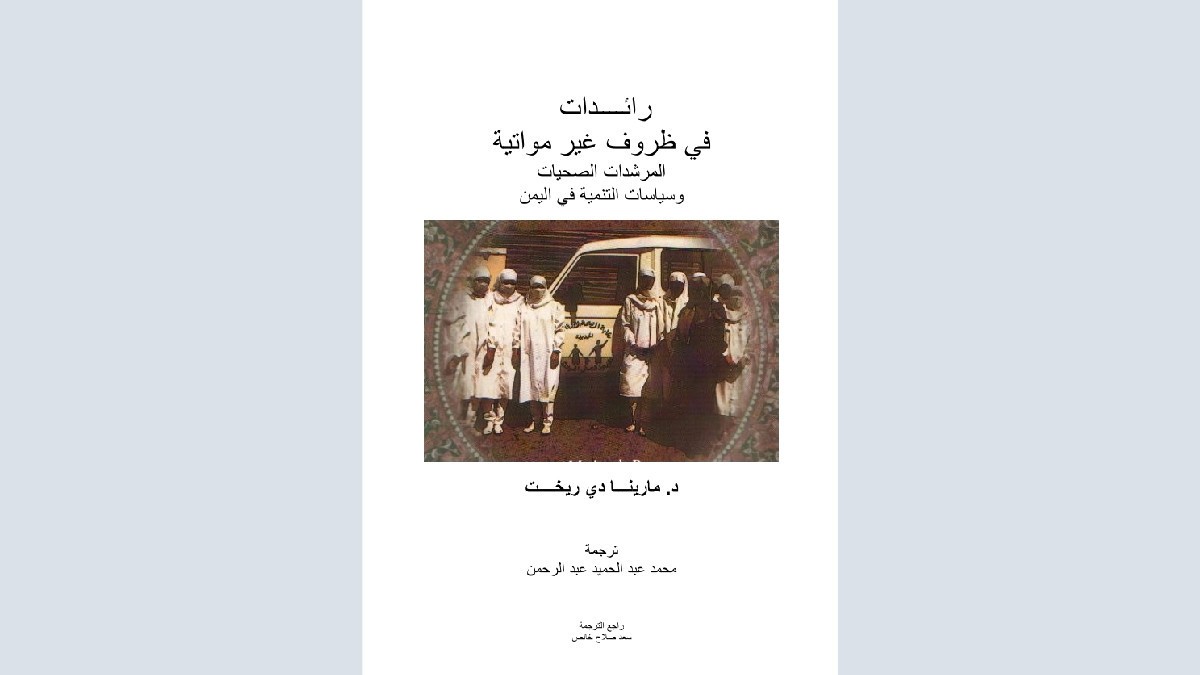رائدات في ظروف غير مواتية 6 - خطابات التنمية
في هذه الحلقة، تفكك المؤلفة فكرة أن الرعاية الصحية هي مجال خيري ومحايد، وتوضح كيف أنها أداة سياسية بامتياز. تستعرض كيف تم استخدام الطب الغربي تاريخياً لخدمة المصالح الاستعمارية، وكيف أن سياسات الرعاية الصحية الأولية الحديثة، رغم أهدافها النبيلة، غالباً ما تُفرض من الأعلى وتخدم أجندات الدول المانحة والحكومات المحلية. وتؤكد على ضرورة تبني "منظور متعدد المستويات" لفهم كيف تختلف معاني وأهداف الرعاية الصحية بين المنظمات الدولية، المسؤولين المحليين، والمجتمع المستهدف.
هذا الكتاب
2.2 خطابات التنمية
تمثل مقالة خالد فهمي حول مدرسة القابلات جزءاً من الكتاب الذي حررته ليلي أبو لغد بعنوان "إعادة صنع المرأة؛ النسوية والحداثة في الشرق الأوسط" Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East (1998). Lila Abu-Lughod الذي قدمت فيه مقاربة جديدة المرأة والجندر في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالدراسة التاريخية للمشروعات التي ركزت على "إعادة صنع النساء" (المشروعات التي استهدفت تحديث النساء في الشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والعشرين). وترى أبو لغد أن الدراسات السابقة عن المرأة والجندر في الشرق الأوسط لم تعتن بحيوية وحساسية الجدال حولهما في لحظة تاريخية محددة ولا بأهمية الصلة بين الإصلاحات التي أنجزت لصالح المرأة وسياسات التحديث (مصدر سابق 5).
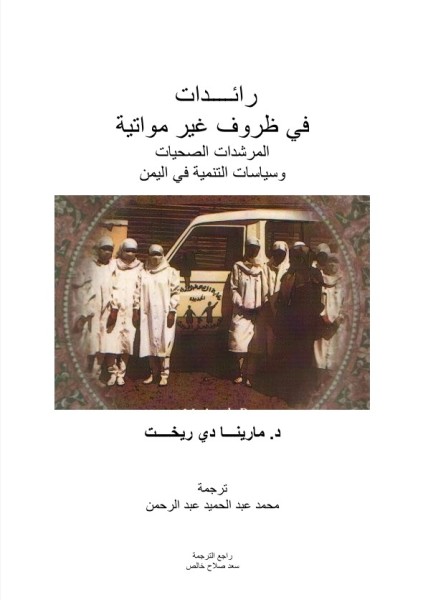 لا يمكننا وضع الالتباسات والغموض الذي يكتنف هذه المشروعات في بؤرة الاهتمام إلا بتحليل الطرق التي اتبعت لإنتاج وإعادة إنتاج المفاهيم المختلفة للحداثة. وتدعو أبو لغد- على خطى ميشيل فوكو- لكشف وتوضيح الافتراضات حول المرأة في المجتمع، تلك الافتراضات التي تشكل أساس العديد من هذه المشروعات، كما وتُولي أهمية كبيرة للدراسة النقدية لـ "سياسات الحداثة Politics of Modernity". إن الطرق التي يتم بموجبها اعتبار الأفكار والممارسات الجديدة حديثة وتقدمية لم تأت بأشكال وصيغ تحررية فحسب بل لازمتها أيضا أشكال جديدة من الضبط الاجتماعي (مصدر سابق 6).
لا يمكننا وضع الالتباسات والغموض الذي يكتنف هذه المشروعات في بؤرة الاهتمام إلا بتحليل الطرق التي اتبعت لإنتاج وإعادة إنتاج المفاهيم المختلفة للحداثة. وتدعو أبو لغد- على خطى ميشيل فوكو- لكشف وتوضيح الافتراضات حول المرأة في المجتمع، تلك الافتراضات التي تشكل أساس العديد من هذه المشروعات، كما وتُولي أهمية كبيرة للدراسة النقدية لـ "سياسات الحداثة Politics of Modernity". إن الطرق التي يتم بموجبها اعتبار الأفكار والممارسات الجديدة حديثة وتقدمية لم تأت بأشكال وصيغ تحررية فحسب بل لازمتها أيضا أشكال جديدة من الضبط الاجتماعي (مصدر سابق 6).
ثانيا يتعين علينا الاهتمام بما تسميه أبو لغد "سياسات علاقات الشرق والغرب وبالخطابات المستلفة من أوربا، أو تلك التي يدعمها الأوربيون، the politics of East/West relations أو تلك التي تشكلت استجابة للتعريفات الاستعمارية لـ "تخلف" الشرق (مصدر سابق) وتشدد ليلى أبو لغد على الحاجة الملحة للاهتمام بالديناميات الفعلية للتهجين الثقافي لنتمكن من مساءلة المفاهيم الجامدة للثقافة ولتجاوز ثنائية الشرق والغرب (مصدر سابق 16). ثالثا تؤكد أبو لغد على أنه من الضروري دراسة دور الطبقة الاجتماعية بربطها بسياسات الحداثة وعلاقات الشرق والغرب. لا بد أن نعرف من هم المشاركون في الجدال والنقاشات حول المرأة وما هي علاقة مشاركتهم هذه بتعزير المشروعات الطبقية وتلك المتصلة بالهوية؟ (مصدر سابق 6).
بينما تركز المقالات الواردة في كتاب أبو لغد على المشروعات الحداثية في القرنين التاسع عشر والعشرين فإنني أرى مقاربتها مفيدة جدا لتحليل المشروعات الحداثية المعاصرة مثل مشروعات التنمية فيما يسمى بـ "العالم الثالث". لقد استخدم مفهوما التحديث والتنمية في خطابات محددة للحداثة ذات صلة بتاريخ الرأسمالية والاستعمار وبزوغ نظريات معرفة أوربية معينة ابتداء من القرن الثامن عشر.
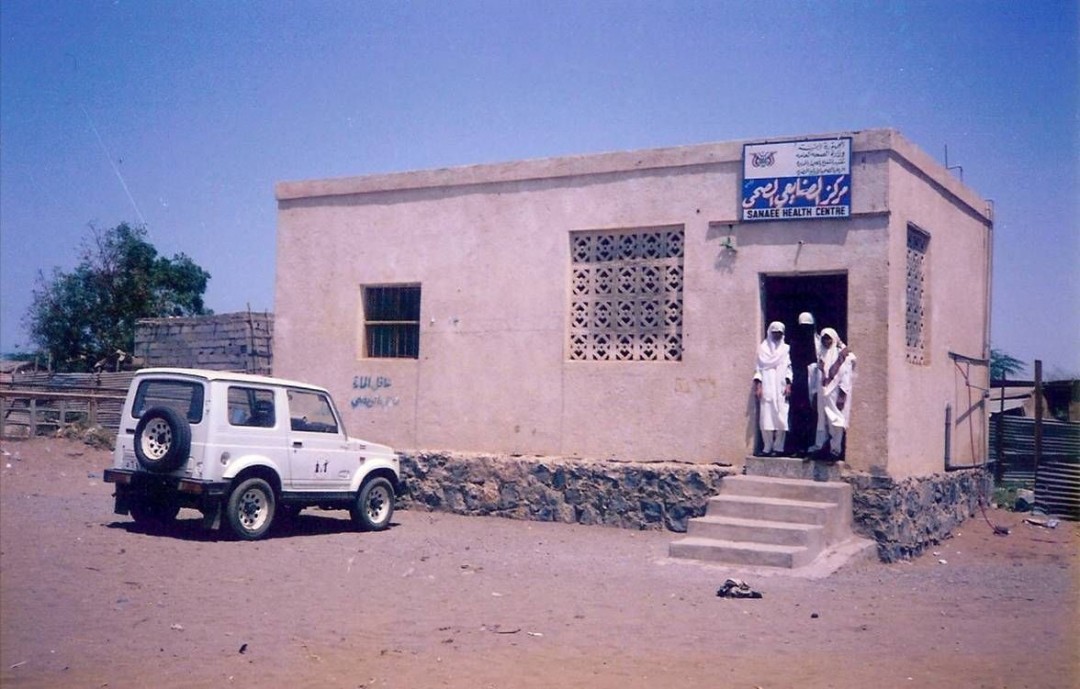
وبينما كانت المشروعات الاستعمارية جزءاً من "سياسات العلاقات بين الشرق والغرب" اندرجت مشروعات التحديث والتنمية ما بعد الاستعمارية في نطاق "سياسات العلاقات بين الشمال والجنوب". تعتبر التنمية مفهوما مفتاحيا لنظريات التحديث بعد الحرب العالمية الثانية حيث تزايد اهتمام الدول الغربية بتحديث الدول المستعمرة والمتحررة حديثا من الاستعمار وتنطلق هذه الفكرة من منظور تطوري تتحدد فيه مراحل مختلفة من التنمية على أساس أن دول "العالم الثالث" تمثل مراحل مبكرة من التنمية، وللوصول إلى مستوى الدول الأوربية (الحداثة الأوربية) فإنها تحتاج إلى مساعدة وان التحديث والتنمية يمكن أن يساعدا هذه الدول في اللحاق بالركب الأوربي. وبالرغم من أن نظريات التحديث قد انتُقدت ورُفضت على نطاق واسع فإن الافتراضات الأساسية التي يستنبطنها مفهوم التنمية ظلت جزءاً من خطابات التنمية الراهنة.
خلال العقدين الماضيين تزايدت بشكل واضح البحوث الأكاديمية التي فككت المزاعم المعرفية المضمنة في خطابات التنمية السائدة وصاغت موقفا نقديا للكيفية التي تشتغل بها صناعة التنمية، حيث يذهب اسكوبار Escobar (1984; 1995) إلى أن خطابات التنمية قد أنتجت "العالم الثالث " بالاستخدام المطرد لوسائل وطرق محددة تنظم المعرفة والسلطة. أولا يسبق التنمية استيلاد مفهوم "الشاذ" أو غير العادي كتعريف للظواهر الاجتماعية التي تختلف عن تلك المعروفة في الغرب ثم وإطلاق تسميات كـ "المتخلفة" و"الناقصة النمو" و"الأمية". يعقب ذلك تقديم هذه الظواهر كمشكلات يتعين حلها. ثانيا ظهرت سلسلة من المنظومات التنموية الرئيسية والفرعية التي تسمح للخبراء بإزاحة هذه المشكلات من السياق السياسي وإعادة عرضها في السياق العلمي المحايد بوضوح (1984: 384). كان ظهور اقتصاديات التنمية تطورا هاما في هذه الاستراتيجية حيث اعتبر النمو الصناعي والاقتصادي طريقا لتحقيق ما توصلت إليه الدول الغربية وصمم اقتصاد التنمية لمساعدة الدول غير الغربية لتحقيق ذلك الهدف. ثالثا تم مأسسة ومهننة التنمية وصار لها مؤسساتها ومهنها وممارساتها على المستويات المحلية والوطنية والدولية (مصدر سابق 388).
يمكن تعريف مشروعات التنمية التي تبادر بها وتمولها وتديرها المنظمات الغربية المانحة كمشروعات مجسدة لخطابات تنمية. بينما كانت مشروعات التنمية موضوعا للدراسات الأنثروبولوجية منذ نشأتها، مال الأنثروبولوجيون إلى التركيز على دراسة آثار الأنشطة التنموية، أسباب فشلها والطرق الكفيلة بتحسين كفاءة هذه المشروعات.
وأدى إيلاء أهمية أكبر للعوامل الثقافية والاجتماعية إلى تعيين أنثروبولوجيين للعمل في مشروعات التنمية وظهر إلى الوجود "أنثروبولوجيا التنمية" (cf. Escobar 1991). وأصبحت الافتراضات التي يقوم عليها مفهوم التنمية مقبولة من حيث المبدأ بدلاً عن مساءلتها وتدقيقها ونقضها كما يقترح اسكوبار. خلال السنوات العشرة الماضية تزايد بشكل ملحوظ عدد الأنثروبولوجيين الذين اتخذوا التنمية موضوعا للدراسة بهدف تفكيك الأفكار والممارسات التي تشكل أساس التنمية (cf. Sachs 1992; Hobert 1993; Crush 1995) هذه الدارسات تسمي في بعض الأحيان "الانثروبولوجيا التنموية" تمييزا لها عن "أنثروبولوجيا التنمية"[29]
تعتبر دراسة فيرجسون المعنونة " الآلة اللاسياسية: التنمية، اللاتسييس والسلطة البيروقراطية في ليسوتو"[30] Ferguson’s The Anti-Politics Machine: “Development, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho (1990). واحدة من أولى الدراسات التي تناولت خطاب التنمية مطبقا على مستوى مشروع تنمية. يركز فيرجسون في دراسته لمشروع تنموي ريفي في ليسوتو (جنوبي أفريقيا) على الآثار الجانبية غير المقصودة للمشروع ويفعل ذلك بتحليل الأفكار والخطابات التي تؤسس للمشروع وتأثيرات هذه الأفكار والخطابات على الممارسات العملية. مقتفيا خطى فوكو يتحدث فيرجسون عن التنمية كـ "جهاز مفهومي" لتأكيد حقيقة أنها "ليست مجموعة من الافتراضات الفلسفية والعلمية المجردة بل آلية ذات نسق مفصل تفعل شيئا ما" (مصدر سابق 15).
خُطط ونُفذ المشروع في ليسوتو بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في الريف والحد من الفقر الذي اُعتبر مشكلة فنية وليست سياسية. بالرغم من فشل معظم أنشطة المشروع، بمعنى أنها لم تؤد الغرض منها، فقد كانت النتائج الجانبية للمشروع أكثر أهمية لأنها أدت إلى تعزيز وتقوية السلطة البيروقراطية للدولة. وبالتالي فقد كان للمشروع نتائج سياسية هامة جدا لكن لم يتم الإقرار بهذه النتائج تحت غطاء "مهمة فنية محايدة" لا يستطيع أحد الاعتراض عليها (مصدر سابق 256) ولهذا يطلق فيرجسون تسمية "الآلة اللاسياسية" على التنمية؛ فهو يرى أن الجهاز المفهومي للتنمية يُنكر النتائج السياسية لأنشطتها من جانب فيما تعزز سلطة بيروقراطية مستعمرة وتوسع من نطاقها وانتشارها من جانب آخر (مصدر سابق 1973).
يقدم فيرجسون دراسته كدراسة أنثروبولوجية ولكنه يضيف انه يركز على الجهاز الذي ينجز "التنمية" (بالعكس من الأبحاث الأنثروبولوجية التي تركز على التنمية) وليس على البشر الذين يراد تنميتهم (مصدر سابق) فهو يرى أن العاملين في التنمية والمستفيدين منها وممثلي الحكومات جميعا جزء من الماكينة الشاملة للتنمية وأن الطريقة الوحيدة لتفادي هذه الخطابات التنموية هي مقاومتها وتكوين حركات مناهضة لها. يتبنى كل من اسكوبار وفيرجيسون أطروحات ميشيل فوكو حول مفهوم الخطاب باعتباره نسقا متكاملا من الأفكار يكمن خارج نطاق الأفراد ويركزان على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب التنمية. بالرغم من دراساتهما قد قدمت إضاءات مهمة لآليات اشتغال خطابات التنمية إلا انهما لم يتركا إلا مساحة محدودة للأدوار الوسيطة والتمثل الفعلي للخطاب على الأرض.
إن افتراض أن المعرفة التنموية حزمة واحدة من الأفكار والمفاهيم و"نشاط كلي واحد يخضع لسيطرة قوية من الأعلى" (Grillo 1997: 20) لا يحظى بإجماع بين الباحثين في أنثروبولوجيا التنمية، إذ يصفها جريللو (مصدر سابق 21) بـأنها "أسطورة التنمية" وينتقد هذه الأسطورة ويوصمها بالافتقار إلى المعلومات والمركزية الثقافية وأنها مؤسسة على ثقافة الضحية التي يكون طرفيها "العاملين في التنمية" و"ضحايا التنمية"، وتماما مثلما ليس هنالك " بشر يتم تنميتهم" لا توجد أيضا مجموعة واحدة ومفردة من "العاملين في التنمية" إذ أن مجموعات البشر المنخرطون في التنمية تتشكل من خليط واسع غير متجانس كما أن أفكارهم وممارساتهم قد تتغير بمرور الزمن علاوة على أن الناس لا ينحصرون فقط فيمن يتأقلم مع التنمية أو من يقاومها بل لديهم ردود فعل واستراتيجيات اكثر تنوعا وتعقيدا. يقدم لونج Long (1992) مقاربة تعتمد على الأطراف الفاعلة، تعترف بالحقائق المتعددة والممارسات الاجتماعية المتنوعة لمختلف الأطراف.
تقتضي المقاربة المعتمدة على الأطراف الفاعلة، عند تطبيقها في مجال التنمية، تحليلا متكاملا للكيفية التي تتعامل وتفسر بها مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة العوامل الجديدة في حياتهم، وفهما للعوامل التنظيمية والاستراتيجية والتفسيرية المتصلة بها وتفكيكا للمقولات التقليدية للتدخل المخطط (مصدر سابق 9).
في كتاب صدر حديثا يطبق ارسي ولونجArce and Long (2000) ) المقاربة المعتمدة على الأطراف الفاعلة لدراسة الحداثة ويركز ارسي ولونج على دراسة الكيفية التي تتم بها مواءمة وتجسيد أفكار وممارسات الحداثة على الممارسات المحلية (مصدر سابق 1) بينما كانت الحداثة مرتبطة لوقت طويل بالرؤى الغربية للتنمية أصبح من الجلي الآن أن الناس يمكن أن يكون لديهم أفكار ورؤى مختلفة للحداثة وأنهم قد يتبنون ميولاً معادية للحداثة ويرى آرسي ولومنج ضرورة اعتماد اثنوغرافيا عاكسة يتم خلالها تحليل ممارسات وخبرات الأطراف المحلية إضافة إلى معارف وتجارب الباحث لكي يتسنى إجراء بحوث أنثروبولوجية تنموية جيدة (مصدر سابق 27). تلك هي الطريقة الوحيدة للتخلص من المقولات الأحادية الجانب حول التنمية والاعتراف بالمفاهيم المختلفة للتنمية والحداثة التي قد تكون لدي الناس إضافة للممارسات والاستراتيجيات التي يتبنونها لوضع هذه المفاهيم موضع التنفيذ. وهكذا نرى أن مفاهيم التنمية تحيل إلى مفاهيم الناس حول التقدم المجتمعي بينما تحيل مفاهيم الحداثة إلى إحساس الناس بانتمائهم للحاضر.
عن المؤلفة
هوامش ومراجع
[29] الخط الفاصل بين أنثروبولوجيا التنمية Development Anthropology والانثروبولوجيا التنموية Anthropology of Developmentليس واضحا تماما ويفضل البعض عدم استخدام هذا التمييز إطلاقا (Grillo 1997; 2).
[30] هنالك دراسات أخرى تناولت مشاريع التنمية من زاوية نقدية منها دراسة (Prter en al. 1991; Villareal 1994).