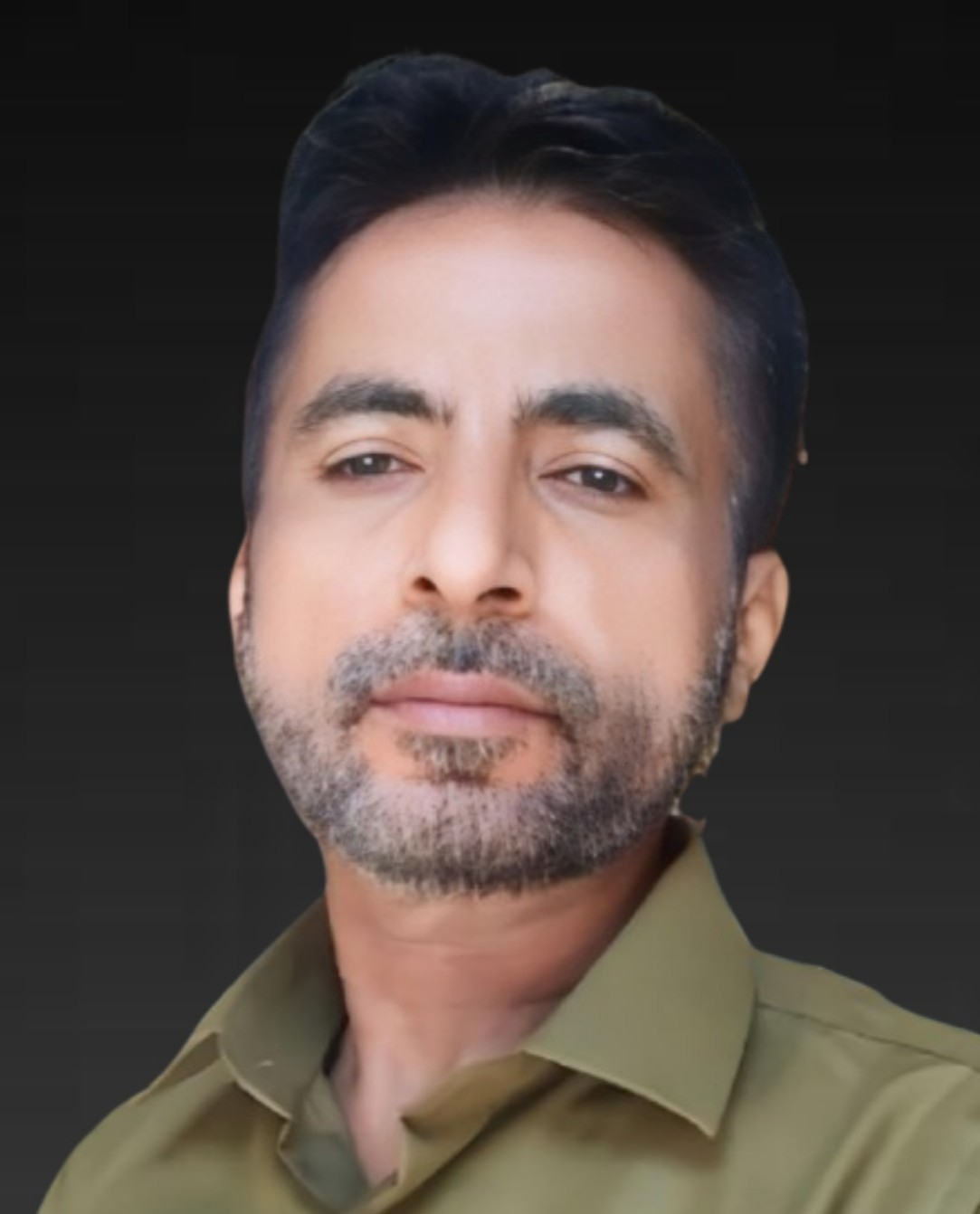نصر حامد أبو زيد.. المسافة الحرجة بين النقد والقداسة

نصر حامد أبو زيد
نصر حامد أبو زيد أشبه بأنثروبولوجي ضلّ طريقه إلى النصوص الدينية، أو كمفكّر دخل ورشة الموروث الإسلامي وفي يده مفك فلسفي لا يصلح لبراغي القرون الوسطى. الرجل لم يطلب المستحيل، كل ما أراده هو أن يُعامل النص كما يُعامل أي نص، يُقرأ ويُحلل ويُفهم داخل شروطه وسياقاته. لم يكن متمردًا بالمفهوم الرومانسي الذي يحبه الإعلام، بل كان مفكرًا من النوع الهادئ، النوع الذي يوقظ الأسئلة دون أن يرفع صوته. اقترب من النص بخوف الباحث لا بجرأة المتمرد، لكن مجرد اقترابه كان كافيًا لتشعر المؤسسة الدينية بأن أحدهم يعبث بمفاتيح خزائنها القديمة.
اقترح الرجل ببساطة أن القرآن خطاب تشكّل داخل لحظة تاريخية، وأن فهمه يحتاج إلى أدوات العلم لا إلى قداسة الجدران. اقتراح يبدو بديهيًا في جامعات العالم، لكنه عندنا كان كافيًا لإعلان حالة الطوارئ، وكأن الرجل يحاول تهريب العقل عبر الحدود بلا ختم شرعي.
كان مشروعه في "نقد الخطاب الديني" محاولة لفصل الإلهي عن البشري، وفهم كيف تحول النص إلى سلسلة طويلة من القراءات، وكيف تحولت هذه القراءات إلى سلطات، ثم إلى حصون، ثم إلى خطوط نار. لكن المؤسسة الدينية المتخصصة في تحويل أي نقاش إلى معركة، اعتبرت مجرد دراسة النص تهديدًا أمنيًا. وهكذا وجد أبو زيد نفسه في قلب معركة لم يخطط لها، معركة ضد آليات التقديس لا ضد الدين نفسه.
المفارقة أن الهجوم جاء من جبهتين متناقضتين في الوقت نفسه.. الإسلاميون رأوا أنه ذهب بعيدًا جدًا. تعامل مع النص الديني بوصفه خطابًا تاريخيًا، وألغى الأسس التشريعية، وهدد شرعية الفقه التقليدي. العلمانيون بالمقابل رأوا أنه لم يذهب بعيدًا بما يكفي. بقي داخل مركزية النص، حاول إصلاح التراث لا تجاوزَه، وتردد بين القداسة والتاريخية، محاولًا استخراج منظومة حداثية من مواد لا تصلح دائمًا للحداثة.
الأولون اتهموه بزعزعة قداسة النص وجرّوه إلى المحكمة، والآخرون اتهموه بأنه لم يخلع حذاءه تمامًا خارج أسوار النص. بدا أبو زيد بينهما كطالب جاء ليشرح درسًا بسيطًا فوجد نفسه في امتحان شفهي أمام لجنتين غاضبتين.
حتى بعض المتعاطفين معه انتقدوا لغته الأكاديمية الثقيلة التي جعلت مشروعه أسير الجامعة، محدود القدرة على الوصول إلى الجمهور الواسع. قالوا إن مشروعه يحمل جوهرًا علمانيًا لكن لغته حالت دون أن يتحول إلى قوة فكرية شعبية.
ظل الرجل يعمل في منطقة مزعجة. مساحة تفضح العتمة دون أن تصرخ، وتكشف الموروث دون أن تحرقه. اقترح أن القرآن نصّ حيّ يتفاعل مع المجتمع، لا وثيقة حجرية تُقرأ بعيون القرن الثالث. تحدث عن "البنية اللغوية" و"آليات الخطاب" و"سياق التنزيل" و"علاقة النص بالواقع"، وكأن هذه الكلمات قنابل صوتية في ساحة مليئة بمن يخافون الأنوار. هؤلاء يفضّلون النص المغلق، لأنه أسهل للتحكم، ولأنه يبقي مفاتيح الفهم في يد من يملك "الإجازة" لا من يملك العقل.
مأساة أبو زيد أنه اكتشف باكرًا أن مجتمعات لم تطوّر علاقتها بالنص ستظل عالقة بين "قداسة لا تُناقش" و"واقع لا يقبل التجميد". حاول أن يفتح نافذة ليدخل الهواء، فاتهموه بأنه يريد هدم الجدران. حاول أن يضيف منهجًا علميًا، فاتهموه بالمؤامرة الغربية. حاول أن يشرح أن النص يتشكل داخل التاريخ، فاتهموه بأنه يريد إلغاء التاريخ نفسه.
لم يكن أبو زيد مشروعًا لإصلاح الدين بقدر ما كان مشروعًا لتحرير الإنسان من القراءات التي تحولت إلى قيود. كان يؤمن أن النص أكبر من الفقيه، وأن العقل لا يقلّ قداسة عن الإيمان، وأن الحرية ليست ترفًا بل شرط للفهم. وربما لهذا السبب تحديدًا هوجم، لأنه حاول أن يجعل العقل شريكًا في المقدس لا ضيفًا ثقيلًا عند بابه.