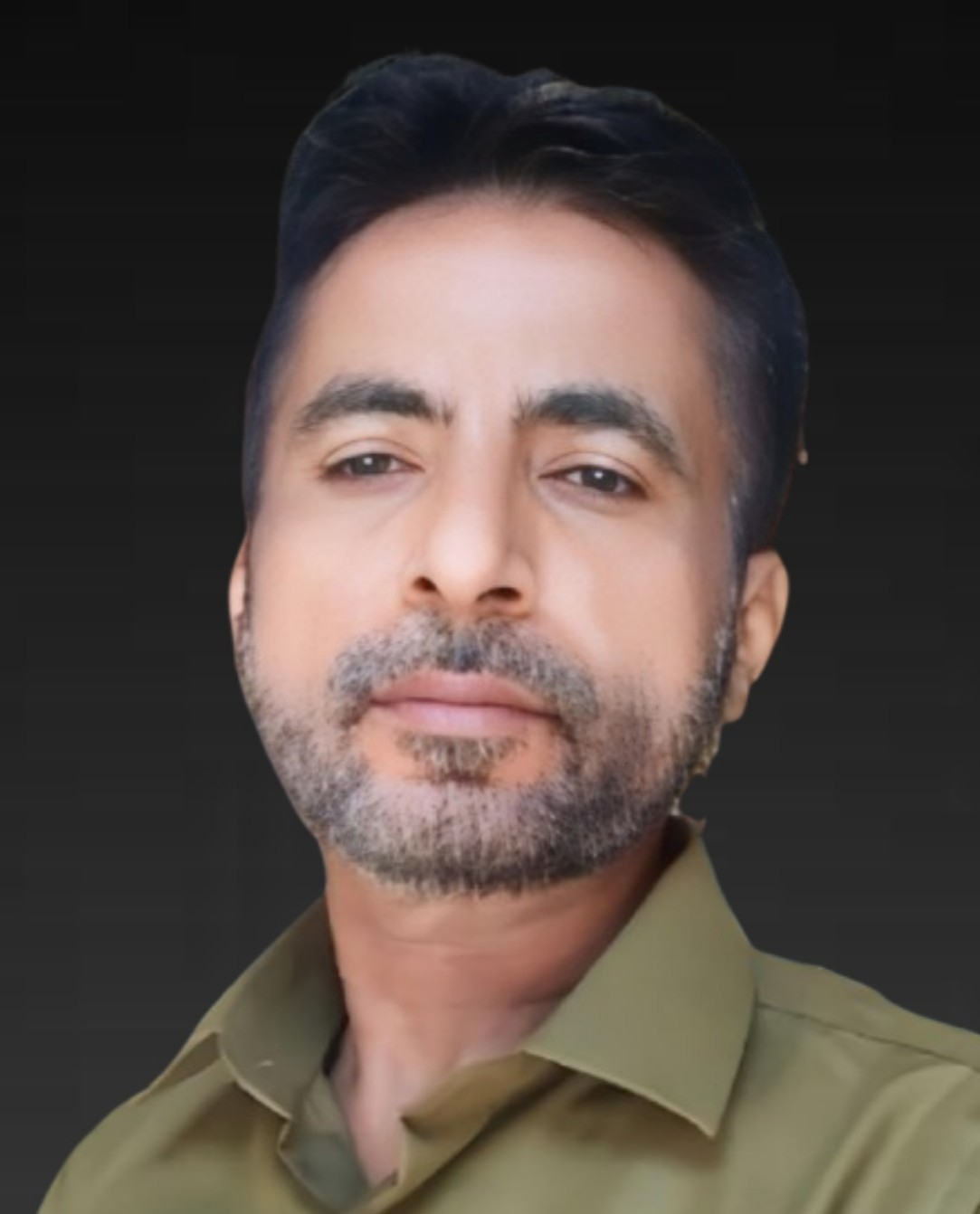من الثورة إلى التشويه: التاريخ يشيطن أبطاله (2-6)
التاريخ الذي يكتبه كتبة السلطة لا يرى غضاضة في أن يمحو نصف الحقيقة، ويضع مكانها نصف شتيمة.. يبدو أن عبهلة العنسي كان مشاغبًا بما يكفي ليثير حفيظة التاريخ نفسه. التاريخ الرسمي الذي لا يحب الذين يقتربون كثيرًا من فكرة السيادة الوطنية قبل اختراع مصطلح "السيادة" بعدة قرون.. لذلك ما أسهل أن يتحول القائد الثائر إلى "مدّعي نبوة"، والراية الوطنية إلى راية فتنة، والثورة إلى رِدّة.
الحكاية تبدأ في اليمن، حيث لم يكن عبهلة ينتظر إذنًا من أحد ليشعل ثورته. لم يأتِ حاملًا صحفًا مقدسة ولا مشروع دولة بالمعنى الفقهي، بل جاء كمن يخلع الغبار عن وجه القبيلة، يوقظها من سبات الطاعة العمياء، ويعيد لها شهوة الصراع على تقرير مصيرها.. كان رجلًا من لحم ودم قبل أن يصبح أسطورة سوداء في كتب التراث، فارسًا يقود قبائل مذحج وكأنه يردّ على مشروع سياسي قادم من الشمال يريد أن يجعل اليمن مجرد ذيل في جسد الخلافة.
عبهلة بن كعب سيد مذحج وقبائل اليمن الوسطى، لم يكن بحاجة لأن يتحوّل إلى شخصية أسطورية مخيفة في كتب التراث.. كفى أنه طرد الفرس من اليمن، رفض دفع الزكاة إلى يثرب، وأعلن أن خراج اليمن أولى به اليمنيون.. هنا يبدأ الخيال الشعبي في تصويره شيطانًا لحيته تحترق من غضب السماء. لكن الحقيقة أقل إثارة، وأكثر استفزازًا، كان الرجل ببساطة يطالب بأن تبقى أموال اليمن في اليمن، وألا يكون باذان بن ساسان الفارسي حاكمًا على صنعاء بعمامة إسلامية.
وحين رفع شعاره الأشهر "أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، فنحن أَوْلى به"، كان في الواقع يقدم خطابًا اقتصاديًا متقدمًا، الضرائب يجب أن تعود لخدمة دافعيها، لا أن تُشحن إلى عاصمة بعيدة لتسمين نوقها.
لكن المأساة اليمنية لا تكتمل إلا بخيانة من الداخل.. فيروز الديلمي ابن "الأبناء" (الفرس المستقرين في اليمن)، تظاهر بالولاء لعبهلة، ثم غدر به في فراشه، وكأنما يكرر الدرس الأزلي: كل ثورة يمنية عظيمة لا بد أن تنتهي بخيانة، لا بانهزام في ساحة المعركة. وما أسهل على المؤرخين أن يحوّلوا الاغتيال إلى "تطهير إلهي" من فتنة، والغدر إلى بطولة، والدم إلى ماء طهور يغسل عار العصيان.
ما يثير السخرية أن كل دوافع الثورة كانت سياسية واقتصادية صِرفة: طرد النفوذ الأجنبي، وقف استنزاف الخراج، إعادة ترتيب السلطة على أسس يمنية لا فارسية ولا قرشية. ومع ذلك، جرى تصويرها على أنها عودة إلى الوثنية، وادعاء للنبوة، وتمرّد على "الدين" الدين الذي لم يكن قد ترسّخ بعد، ولم تكن معانيه قد استقرت حتى في عقول أهل يثرب أنفسهم.
عبهلة لم يكن نبيًا، ولا كان ساحرًا، ولا حتى بطلًا رومانسيًا يكتب أشعاره في الليل ويهتف للجماهير في النهار.. كان رجلًا عمليًا، يرى أن اليمن لليمنيين، وأن الاحتلال يبقى احتلالًا حتى لو غيّر اسمه، وأن الزكاة التي لا تعود بالنفع على فقراء اليمن ليست زكاة، بل جزية، ولعل هذا ما جعله أخطر بكثير من أي نبي مزعوم.. لم يطلب من الناس الإيمان به، بل طلب منهم الإيمان بحقهم.
ما أرعب السلطة المركزية لم يكن شخص عبهلة، بل فكرة أن اليمن قد تحكم نفسها بنفسها.. لهذا كان لا بد من تحويله إلى "الأسود العنسي"، ربطه بالشيطان، وتسجيل مقتله كانتصار للدين، حتى يطمئن القارئ أن الحق قد عاد إلى نصابه، وأن أية محاولة لاستعادة القرار اليمني بعد ذلك، ستكون مجرد نسخة باهتة من فتنة تم القضاء عليها في فجر الإسلام.
الآن، بعد أربعة عشر قرنًا، تبدو قصة عبهلة أقرب إلى درس متكرر في التاريخ اليمني.. كل مرة يظن اليمني أن بإمكانه أن يدير شؤونه بنفسه، ينبثق "فيروز" جديد من قلب المشهد، ويعيد ضبط الساعة إلى الصفر.. ومع ذلك، يبقى اسم عبهلة يتردّد كرمز للتمرد، حتى لو أرادوا له أن يكون رمزًا للكفر. ربما لأن اليمن، مهما جُرّدت من قوتها، لاتزال تؤمن أن لها الحق في أن تقول: "أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا".
هل كان عبهلة نبيًا كاذبًا؟ الأكيد أنه كان ابن لحظة يمنية خالصة، لحظة قررت أن تقول للخلافة: لسنا تابعين ولسنا مجرد سوق تُجبى منه الصدقات.. لقد كان الحقيقة المزعجة التي فضّلت السلطة أن تسميها كذبًا. كان صوتًا مرتفعًا في زمن أرادوا له أن يكون همسًا. ولهذا سيظل اسمه أشبه بشوكة صغيرة عالقة في حلق التاريخ الرسمي، تذكّره أن هناك رواية أخرى لم تُكتب بعد.