الانفلات من الضمير المشدود - محمد ناجي أحمد
العيش في بلدٍ تسلطيَ يجعل الأشياءَ تكيِّف نفسها في محيطٍ يعزز من حالة التماثل. فالشدة كصفة ذكورية يتم إعلاؤها في مواجهة "الرخاوة" كصفة يُراد لها أن تكون صفة أنثوية.
حين قرأت مقالة العزيزة نبيلة الزبير "ضمائر الرخوة" لم يُصدم أفقي المعرفي بهذا التوصيف، بل بدأتُ أتحسس داخلي تلك الرخاوة المخفية بملامحي الصارمة والجادة، لكنها تستبطن ذاتاً وعمقاً أنثوياً، لا أجده عيباً ينبغي أن أتداركه، بل ميزة يجب أن أطلقها من أسر تلك الملامح (الرصينة). وأن تكتب نبيلة الزبير عن "رخو" مثلي فهو بمثابة التكريم الذي ينبغي أن أقابله بالشكر بحسب رأي أشدّ قرائها إعجاباً بهذا المقال (خالد الشعبي)، وهو في أضعف الإيمان تقدير واعتبار تمنحه لي (نبيلة) بحسب تقدير العزيزة أمل الباشا. وامتثالاً لهذا الرأي سوف أحمدُ لها مقالتها جلَّ شأنها.
وسأتقبل محاولتها تعميم الألم وجعله، ليس ظاهرة تخصها وحدها، كلنا لدينا ما يتستر عليه الصمت، وننطلق رغماً عنه، قابضين على الجمر، بل وأكثر من ذلك سأروض نفسي لتقبل لغتها المجازية المدرسية "قابضين على الجمر" و"أن ضميرك ميت منذ زمن، ميتٌ تأخر دفنه". "ضمير رخو" طالما وهذه اللغة المجازية رغم مدرسيتها الاعتيادية ستجعل بعض القراء يتهافتون عليها احتفاءً بها وشماتةً بهذا الضمير الذي "تأخر دفنه".
تحصن "نبيلة" كتابتها تجاه الاختلاف على طريقة اليقينيين، فتشكك بعدالة الكاتب وتغمز بنوايا الكتابة؛ مصادرةً حرية الكاتب في الاختلاف معها تماماً كما عملت على مصادرة ضميره واعتباره ميتاً.
عندما نتحدث -افتراضاً- عن نقد ينال الوظيفة ومحدداتها وليس الأشخاص فنحن بالتأكيد نتحدث عن وطن افتراضي قد تجاوز أنظمته التسلطية، وأصبحت الوظيفة السياسية فيه محكومة بمحدداتها وحدودها، وكأننا لا نعيش في ظل نظام تسلطي، الوطن فيه ليس سوى امتداد (للشخص). ومن هنا كان نقدي الموجه للعزيزة نبيلة الزبير، جعلت الهجاء المتمركز حول الشخص يلتبس مع المدح حين يفترض أن هناك وظيفة لها محددات وحدود، فتصبح الكتابة عنه شيئاً من التزييف، تخدم الحاكم حين تُوهم الآخر خارج حدود الوطن أننا نعيش في ظل نظامٍ يتقبل النقد من أعلى وظيفة فيه إلى أدناها!! وطنٌ يخلو من أدوات القمع المدنسة والمقدسة، من جلاوزة العقل والدين والمجانين!!
أزعم أن مقالتي عن "ابتسام" بكاءً وليس تباكياً، وتفاعلاً وليس ادعاءً، واتساقاً مع حيوية الضمير وليس موته. وأزعم أن ما كتبته عن وزير الثقافة (أبوبكر المفلحي) قائم على الإحساس بأن الرجل تربى على قيم المحافظة على المال العام، واحترام الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وليست "عزبة" ونفوذاً يُضاف إلى واجهته المشيخية، كما هو حال "الوزير المثقف" خالد الرويشان والذي أراه خلال وزارتيه الأولى والثانية لم يؤسس لبنيةٍ ثقافية حقيقية لا في المسرح ولا في السينما ولا في المكتبات العامة أو صناعة الكتاب ومعارضه. يكفي أن مدينة كتعز ما زالت حتى يومنا تفتقر إلى مكتبة عامة، وإن أنشئ في عهده زقاق ضيق تابع للهيئة العامة للكتاب، لا يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف عنوان!!
وزيرٌ في عهده كانت صنعاء "عاصمة للثقافة العربية"، فأسأل العزيزة نبيلة: ما الذي تبقى من عاصمة الثقافة العربية؟ شجع المواهب الجديدة! واستحثها على قراءة الشعر العمودي! في مواجهة كُتاب قصيدة النثر، احتفاءً بالتقاليد الشعرية! هذا الوزير "الوحيد من بين وزراء الثقافة أجمعين الذي أشرع أبواب الوزارة للأدباء والفنانين، خاصةً الشباب، وعنى برفد وتجديد المشهد الإبداعي، عبر التنقيب عما أمكن من مواهب صاعدة أو مغمورة، ودعم تجربتها؛ بأن أقام لها الفعاليات، وبشراء بعض نتاجها"، حسب تعبيرك القطعيّ (الوحيد) قام بدور لم يُسبق إليه. بل وأزيدكِ من رواية عبدالله ثابت "الإرهابي 20" أن احتفاءه بالمواهب قد امتد إلى دول الجوار!!
لقد قام بوظيفة معلم المدرسة الذي يفتقد للموهبة الإبداعية، لكنه يشجع تلاميذه عليها، وأما موضوع "الأبواب المشرعة" فشخصياً لم أجد باباً من أبواب وزارته مشرعة أمامي، وحكاية "الأبواب المشرعة" تؤكد الملكية الشخصية للوظيفة العامة، فبإرادته تفتح الأبواب وتغلق، وتوهب المساعدات وتمنع، ويقال لهذا: أحسنت، أعد أعد؛ ولذاك: بخٍ بخ!!
واعتناؤه بالمبدعين مسألةٌ فيها نظرٌ واختلاف. وأما شراء بعض نتاجها فتقليدٌ تسير عليه بعض الوزارات، وبمعايير شخصية تشجع هذا وتهمل ذاك!!
سأفترضك الفضيلة وأنا الرذيلة، أوَليست الرذيلة أمرٌ بشري وطبيعي يمكننا أن نتفهمه بدلاً من مصادرة حريته في التعبير من خلال إسقاط عدالته والتشكيك بنواياه؟! ولا يقف الأمر عند ذلك بل يتم الحكم على الضمير بأنه "ميت".
إن من فضائل مقالتك عليّ أنها جعلتني أشعر بفداحة عنف اللغة، تلك التي لا تولد سوى عنفٍ مقابلٍ بل وأشدّ، وتجعلنا نتاجاً لثقافةٍ متماثلة في رغبتها جعل الآخر صريعاً، بل "وميتاً منذ زمن. ميتاً تأخر دفنه".
بقي أن أتساءل عن رغبة الانتقام التي وُصفت بها مقالتي تجاه زملائي الذين لم يمسوني بأذى، ويبدو أنكِ ملزمةٌ بتوضيح الادعاء بالانتقام، وإلا فإنكِ قد تجنيتِ في الادعاء إضافةً إلى تجني لغتكِ المجازية، وتشيعكِ بلغةٍ يقينية لـ"خالد الرويشان".
من رواية "جوستين" للمركيز دوساد:
جاء في الإهداء: بنيان هذه الرواية غريبٌ دون شك. حيث تبدو الرذيلة بكل مكان ظافرة، أما الفضيلة فضحية قرابينها. هنا امرأةٌ تعيسة الحظ تصبح ألعوبة الشر والغواية: تتعرض لأشد الميول فساداً وبربرية: فريسة دائماً لأشد الأهواء وقاحة ومراوغة، ولا تملك غير رقة روحها التي تقارع بها المزيد من الحظوظ العاثرة، والكثير من الانحلال.
قصارى القول.. لقد جازفت بكتابة أجرأ المواقف استثنائية، وأعتى قواعد السلوك ضراوة...
فهل وفّقتُ يا كنستانس؟ هل تطفر دمعةٌ من مآقيكِ بضمان توفيقي؟
لو أتيح لكِ قراءة "جوستين"، أفلن تقولي أخيراً: "آه! كم تحفزني صور الجريمة على التباهي بعشق الفضيلة! وكم ستكون سامية دموع الضحية! وكم سيرفعها حظها التعس إلى ذرى النبالة!".
آه! يا كنستانس، دعي كلماتي هذه تقطر من شفتيك، فبها تتوجين كل ما عملت يداي!!
mohmad



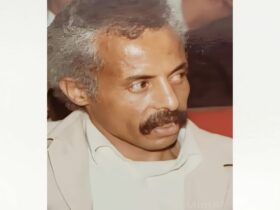


على شبكات التواصل