القضية الجنوبية من منظور وطني - طاهر شمسان
حتى أيام قليلة مضت كنت أستقبح الحديث عن احتلال الشمال للجنوب، وأعتبره ضربا من الجنون الخالص. ولكن تبين لي أنني لم أكن على صواب 100% وأن الجنوبيين ليسوا على خطأ 100%. فالناس يقرؤون واقعهم من مواقعهم المختلفة و"النار لا تحرق إلا رجل واطيها". فعلى سبيل المثال: الحزب الاشتراكي اليمني هو الذي قاد معركة استقلال الجنوب، وهو الذي وحد السلطنات والمشيخات والإمارات في دولة مركزية واحدة، وهو الذي حكم الشطر الجنوبي من الوطن، وهو الذي مثل الجنوب في اتفاقية الوحدة، وهو الذي سلم دولة الوحدة دولة كاملة السيادة وثلثي الأرض والثروة، وهو الذي حصد كل مقاعد المحافظات الجنوبية في انتخابات أبريل 1993 النيابية... الخ؛ ومع كل ذلك استكثرت قيادة المؤتمر الشعبي العام عليه أن يتحدث باسم الجنوب خلال الأزمة السياسية التي سبقت حرب صيف 1994، بحجة أن لا وصاية له على جماهير الجنوب. ومع ذلك أعطت نفسها الحق أن تجتاح الجنوب بالدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ باسم الشرعية (الأغلبية العددية) التي لم تحقق نجاحا انتخابيا ذا قيمة في محافظاته الست حتى على صعيد الأصوات. وإذا عدنا إلى قوام هذه الأغلبية في البرلمان سنجدها شمالية. فهل قُدِّر على الجنوب أن يدفع ثمن كونه أقلية سكانية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا طالت استحقاقات الحرب إلى يومنا هذا؟ لماذا يرفض المنتصر إزالة آثارها؟ لماذا يحول انتصاره على الحزب الاشتراكي إلى هزيمة لكل اليمنيين؟
مثالا ثانيا: لم تقم الوحدة بين حزبين، وإنما بين دولتين لم تكن أي منهما تمثل الأنموذج الذي يستحق السير على منواله. لذلك اتفق قادة الشطرين على أن لا تكون دولة الوحدة هي دولة الشمال ولا هي دولة الجنوب، وأن يأخذ النظام الجديد بما هو أفضل في النظامين السابقين. وما نراه اليوم هو تكريس بالقوة لنظام "الجمهورية العربية اليمنية" وإعادة إنتاج سلبياته بمعدلات عالية وتجريم لنظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعدم الاعتراف له بأي حسنة. ألا يعد هذا انقلابا على الوحدة وتحولها إلى احتلال؟
مثالا ثالثا: الأصل في اتفاق الوحدة هو الشراكة واقتسام السلطة مناصفة بين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام. وكان هذا هو الخيار المتاح حينها عمليا، لأنه –بسبب غياب الديمقراطية في الشطرين- لم تكن هناك أطراف أخرى قادرة على الدخول في القسمة، والشراكة لا تعني دوام القسمة على 2 وإنما أن يستمر الطرفان في رعاية دولة الوحدة حتى يصلا إلى مرحلة القسمة على الكل، أي تحقيق الاندماج الوطني الكامل للدولتين الشطريتين في إطار الدولة الجديدة وتمكين مؤسسات هذه الدولة من الاشتغال الديمقراطي الطبيعي الذي يحول دون انتكاس التجربة والعودة بها إلى الخلف. وما يحصل اليوم قسمة على واحد واستئثار عصبية أسرية – ومعها بعض المنتفعين – بالسلطة والثروة. فماذا نسمي هذا إن لم يكن خروجا على اتفاقية الوحدة وتحولها إلى احتلال؟
مثالا رابعا: اقترنت الوحدة بالديمقراطية كآلية للانتقال التدريجي من حالة القسمة على 2 إلى حالة القسمة على الكل. فالهدف من الديمقراطية هو تحقيق الاندماج الوطني الكامل وتكييف مؤسسات الدولة لمتطلبات عملية التحول الديمقراطي وعلى النحو الذي يوسع قاعدة الشراكة لتشمل -تدريجيا- أطرافا أخرى وليس فك الشراكة بين طرفي الوحدة بعد أول دورة انتخابية. وما يجري اليوم هو ديمقراطية مقيدة تعيد إنتاج الأغلبية "المريحة" وتجدد شرعيتها وتعطيها الحق في أن تفعل ما تشاء مقابل حق الأقلية "المتعبة" في أن تقول بعض ما تريد. فهل هذه هي الوحدة التي تم الاتفاق عليها في 30 نوفمبر 1989؟
مثالا خامسا: اتفق الطرفان على فترة انتقالية الغرض منها استكمال دمج مؤسسات دولة الوحدة وأسسها القانونية والنظامية. وحددت هذه الفترة بسنتين ونصف. وهذه مدة زمنية قصيرة انتهت دون أن تتهيأ لدولة الوحدة أرضية صالحة لتبدأ مشوارها الطويل. وكان هناك جيشان مستقلان سهل فيما بعد انزلاقهما السريع نحو الحرب. والمعروف أن الفترة الانتقالية كانت موضوع خلاف أصرت معه قيادة المؤتمر الشعبي العام على عدم جواز تمديدها بغض النظر عن المهام المرتبطة بها. وما نراه اليوم هو أن هناك جيشا جنوبيا تم الاستغناء عنه وتحويله إلى متقاعدين أو عائدين مهمشين. فهل هذه هي الوحدة؟
مثالا سادسا: بُعيد قيام الوحدة, وعلى قاعدة اتفاق مع قيادة المؤتمر الشعبي العام, برز التجمع اليمني للإصلاح كقوة سياسية كبيرة متطلعة للسلطة ومحملة بإرث ثقيل من العداء الأيديولوجي المتبادل بينها وبين الحزب الاشتراكي. ولم تبذل قيادة المؤتمر الشعبي العام أي جهد يذكر للتقريب بين هذين الحزبين لمصلحة دولة الوحدة الفتية. وعلى العكس من ذلك مارست معهما سياسة "فرق تسد" وسوقتها باسم الوسطية والاعتدال. ولم تكن هذه -الوسطية- في الواقع سوى انتهازية سياسية مدمرة ألقت بظلالها الكثيفة على مسار دولة الوحدة خلال الفترة الانتقالية وما تلاها. والذي نراه اليوم أن هذين الحزبين يلتقيان ويأسفان على ما مضى ويتطلعان إلى المستقبل. بينما لا تزال قيادة المؤتمر الشعبي العام متمترسة وراء سياساتها القديمة رغم ما جلبته على اليمن من محن وإحن. فمن ذا الذي لديه استعداد لأنْ يلغي عقله ويصدق أن قيادة المؤتمر الشعبي العام حريصة على الوحدة كما يفهمها الوحدويون شمالا وجنوبا.
مثالا سابعا: خلال الفترة الانتقالية استقوت قيادة المؤتمر الشعبي العام بوضعها التحالفي الممتاز مع التجمع اليمني للإصلاح وبدأت تتنكر تدريجيا لاتفاقية الوحدة. وبسبب ذلك مارس علي سالم البيض اعتكافين صامتين. وانتهى الاعتكاف الثاني إلى صياغة "وثيقة التنسيق والتحالف على طريق التوحيد بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني". وقبل البيض بهذه الصيغة كحل وسط في مواجهة شعار "لا شراكة إلا بالدمج". ومن بين ما تضمنته تلك الوثيقة: تشكيل كتلة برلمانية واحدة للحزبين، وإجراء إصلاحات دستورية هيكلية للنظام السياسي ألغت مجلس الرئاسة وأبدلت به رئيسا ونائبا ينتخبان بالاقتراع العام في قائمة واحدة، وإنشاء مجلس شورى تمثل فيه المحافظات بالتساوي ويشكل مع مجلس النواب جمعية وطنية يرأسها نائب الرئيس، والتحضير لانتخابات المجالس المحلية... الخ. وقد تم التوقيع عليها من قبل الرئيس ونائبه عقب الانتخابات النيابية مباشرة. وفي الرابع من أغسطس 1993 وبينما كان نائب الرئيس خارج البلاد وافق البرلمان مبدئيا وبأغلبية 216 صوتا على تعديلات دستورية تجاوزت كل ما نصت عليه تلك الوثيقة. وكان هذا بمثابة الشرارة التي اندلع منها لهيب الأزمة السياسية وراهنت قيادة المؤتمر الشعبي العام في إدارتها على ميزان القوة العسكرية الذي بدا لصالحها بعد انكشاف قوة الحزب الاشتراكي لها. وقدرت أنها قادرة على حسم المعركة خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير. ولهذا عسكرت الأزمة السياسية ودفعت البلاد إلى مطحنة الحرب تحت شعارات الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية.
وما نراه اليوم هو أن حرب صيف 1994 لم تحقق الغرض السياسي المعلن لتبرير قيامها. فالغالبية العظمى من الجنوبيين ليسوا مع الوحدة المعمدة بالدم وسيذهبون إلى آخر الدنيا لتخليص أنفسهم من الشعور بالهزيمة. ودستور دولة الوحدة المستفتى عليه أدرج ضمن استحقاقات الحرب، مثله كمثل أراضي عدن وشواطئها وقطاعها العام الذي جرت خصخصته لصالح متنفذين وتحويل شغيلته إلى متقاعدين. وإذا كان هناك من إيجابية يجب أن نعترف بها لحرب 1994 فهي أنها أبقت على اليمن موحدا حتى اليوم. وما عدا ذلك فهي كارثة وطنية بكل المقاييس. والأسوأ من كل ذلك أن اليمنيين فقدوا الإحساس بوجود دولة تمثل إرادتهم جميعا، وما يرونه هو سلطة متعالية على المجتمع تتحكم أكثر مما تحكم وتستحوذ على كل شيء ولم تترك للمجتمع أي شيء. بعد حرب 1994 تضاعفت معدلات الفساد والاستئثار بالسلطة والثروة بوتائر ما كان بمقدور أحد أن يتصورها أو يتقبلها في زمن التشطير. هذا فضلا عن التدمير الممنهج للتعليم وتفشي البطالة بين الشباب وانتشار الفقر وتدهور مستوى معيشة الطبقة الوسطى وتشكل بيئة طاردة للاستثمار.
إن الأوضاع في اليمن تسير بمتوالية هندسية من سيئ إلى أسوأ. وليس من العيب أن توجد عوامل الضعف في مجتمعنا وفي نظامنا السياسي. ولكن العيب كل العيب هو في التعمية على هذه العوامل والحديث الدائم عن قوة البلاد, ورسوخ الوحدة كرسوخ الجبال, والتقدم المطرد في مختلف الميادين, والقول أن الدنيا سمن على عسل, و"يا فرح ويا سلا", دون أن يكون هناك ظل من الحقيقة لما يقال سوى الحرص على مصالح ضيقة.
والخروج من الأوضاع الراهنة لا يكون إلا عبر مصالحة وطنية شاملة تتمحور حول إعادة بناء الدولة على أسس وطنية سليمة وبما يحقق المساواة في المواطنة بين كل اليمنيين، ويضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة ويمكن قطار التنمية من الحركة دون توقف.
والمصالحة الوطنية لن تأتي إلينا طوعا، ولكن نحن الذين يجب أن نذهب إليها. فهي قضية نضالية تستوجب التفكير بطريقة جديدة والتخلص من أحقاد الماضي وضغائنه، والقبول بالآخر واعتباره طرفا أساسيا في القسمة العادلة للسلطة والثروة.
والطريق إلى المصالحة هو التسليم بأن الوحدة اليمنية سفينة مشتركة لكل اليمنيين غير قابلة للخرق أو التقسيم، وشرفنا الكبير الذي لا يجوز تمريغه وتحويله إلى احتلال أو هراوة لقمع المعارضين وإذلالهم، واعتبار النظام الجمهوري مكسبا وطنيا عظيما لا يصح فيه التوريث على أي مستوى من مستويات السلطة وفي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وما يتم الآن هو فساد يستوجب مكافحته والقضاء عليه بالطرق السلمية وفي إطار الدستور والقانون، والتمسك بالديمقراطية كمنظومة متكاملة واحترام حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، واعتبار حرية المواطن وكرامته وحقه في العيش الآمن من أهم مقومات شرعية الدولة.
tahershamsan



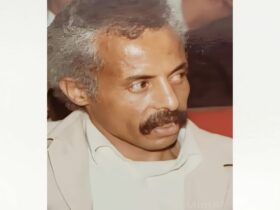


على شبكات التواصل