تبدو المؤشرات مقلقة فيما يخص الوصول إلى حل توافقي للمشكلة القائمة، التي باتت تعرف بـ"القضية الجنوبية"، طالما ظل الطرف الذي يعتبر نفسه مظلوماً و"مقصياً" على ما هو عليه: يدفع بالأحداث الى نقطة البداية الأولى: ما قبل حرب صيف 94م، تلك الحرب التي أفضت نتائجها إلى هذه الحالة المثارة بعد 13 عاما.
إنها الدائرة ذاتها من عدم الاستقرار السياسي، التي عانى منها الجنوب في محطات مختلفة عقب الاستقلال الوطني (1967م). على أن توخي الحلول بالصراعات والاقتتالات، من شأنه أن يبقي الملف مفتوحاً ليعاد بعثه وقراءة محتوياته لاحقاً، وبالطريقة الانتقامية ذاتها التي تحدث اليوم.
وعليه يمكن القول إن الحل المنطقي للمشكلة الجنوبية (التي لا يمكن إنكار وجودها وبشكل تسارعي كبير)، لن يكون بعودة الحال الى ما قبل 1990، أو حتى 1994.
قد يكون الحل الذي تتبناه ثورة "المقاعدين" الحقوقية (ولا يعيبها أن تتسم بطابع سياسي على أساس أن ما بني عليه ظلمهم جاء كذلك) هو الحل الأكثر تأثيرا، ليس في استعادة حقوقهم فحسب، إنما لتعميمها على مستوى الوطن لاستعادة وطن بأكمله. من هنا يمكن القول إن ظهور نفر أو ثلة قليلة تحاول استغلال تلك الثورة السلمية البيضاء، لتكسب مصالح سياسية خاصة فقدت أثناء الصراع السياسي، من شأنها أن تجهض هذه الثورة!! وهذا ما سنحاول توضيحه في هذه التناولة بشكل أدق.
بين الحق في السلطة والحق في الحياة
لا يمكن التغافل عن التراكمات السالبة التي أعقبت حرب صيف 94م من الناحية السياسية، والتي أفرزت كأي حرب طرفي المعادلة: منتصر، ومهزوم. وذلك ما ينطبق أيضاً على حرب 1986 في الجنوب. غير أن تأثير تلك الحرب على القيادات التي صنعت قرارها، ربما كان سيكون أقل أثراً باعتباره النتيجة المؤلمة للصراع، لو أن النتائج لم تتعدَّ تلك القيادات لتصل الى المواطن. بل الأسوأ أن تصل إليه تحت تصنيف التبعية الجغرافية.
وهو ما رسخ إشكالية ما تتبناه بعض التعريفات أنه "احتلالـ" وليس دفاعاً عن الوحدة.
ذلك الأمر من ناحية الممارسات اللاحقة للحرب (التي خالفت ما قامت عليه: تحت اسم الدفاع عن الوحدة) جعل من الحديث عن إزالة آثار تلك الحرب أمراً مبرراً، بل ومطلبياً، عجز النظام القائم عن تصنيفه ضمن "الخطوط الحمراء" للوحدة، في الوقت الذي اعتبر فيه الحديث –المستحيي– عن تصحيح مسار الوحدة، يندرج ضمن تلك الخطوط، ويتهم من ينادي بذلك بتهمة "الانفصالـ".
لاحقاً عرف معنى "تصحيح مسار الوحدة" أنه استعادة السلطة للقيادات الجنوبية ضمن إطار الوحدة الوطنية، على اعتبار أن تلك القيادات شريكة في صناعتها. وقد لا يمثل مثل هذا التعريف إشكالاً من الناحية الاعتبارية العامة إذا ما تجاوزنا أن هناك قراراً بالانفصال تم اتخاذه من قبل تلك القيادات، وأدى الى هذا اللون الواحد من شكل النظام. غير أن تحقيق ذلك على أرض الواقع لم يكن بالأمر السهل، خصوصاً وأن تلك القيادات صنفت على أنها خائنة وعميلة، الأمر الذي جعل النظام يتحايل بتفويض قيادات جنوبية لتولي مناصب قيادية كبرى (نائب الرئيس، ورئيس الوزراء).
مع كل ذلك لم يكن هناك من تأثير حقيقي على مجريات الأمور مثلما ظهرت عليه تأثيرات ثورة "المقاعدين": الحق الوطني الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه إلا به. هذا الحق مع أنه أخذ في تلك الظروف التي أخذت فيها السلطة من قيادات الجنوب الفعلية، إلا أن قمعه أو التحايل عليه كان أمراً مستحيلا. وللإجابة على سؤال: لماذا؟ في اعتقادي هناك سببان اثنان: الأول أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. والثاني أن تلك الحقوق كانت مدعومة من قبل معظم أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ومعظم شرائح المجتمع اليمني.
ولتدعيم ما ذهبنا اليه يمكن فقط الإشارة الى الارتداد العكسي لما أقدمت عليه السلطة من محاولة لقمع تلك الأنشطة السلمية. وهو أمر لم يكن ليؤثر على سلطة أدمنت القمع واستخدام السلاح في مواجهة الشعب، لو لم تقف في وجهه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع في الشمال والجنوب على السواء.
ولذلك فإن ظهور تلك الثلة القليلة لتقول للأحزاب وتلك المنظمات: قفوا أماكنكم ولا تتقدموا! هو أمر يسعى لإخماد جذوة تلك الشرارة ولا يدعمها تحت مسميات أنانية ضيقة تحاول النيل من حركة المجتمع المدني، عبر تشظيته بفرزه جغرافياً.
استغلالية المشترك
إن الوعي التحرري الذي بنته القيادات الوطنية الحزبية والمستقلة عبر الفعل السياسي المناهض (من خلال الصحافة والمناشط التوعوية المختلفة من اعتصامات ومظاهرات وغيرها)، وإلى جانب ما توجته الانتخابات الرئاسية 2006 من مواجهات حقيقية بين المعارضة والنظام القائم، كان الجانب المشرق منها: كمّ التوعية التي عمدت أحزاب المشترك إلى ضخها للمواطنين أثناء التنافس، والتي كسرت المحرمات وأسقطت الصنمية... كل ذلك بجملته كان له الأثر البالغ في تتويج ثورة الحقوق السلمية. ولمّا ظهر التناغم الوطني بين تلك الثورة وبين النضال السلمي الذي قادته أحزاب اللقاء المشترك، اهتز عرش النظام وبدا كأنه فقد قوته الهلامية، فراح يصدر القرارات العشوائية والارتجالية وحاول استخدام كافة الأساليب الترغيبية والترهيبية. لكن ذلك كان في نهاية الأمر يكشف مزيدا من العجز أمام القوة التي ظهرت عليها الثورة. فلجأ تارة إلى اتهام قيادات المقاعدين بأنهم انفصاليين، وتارة إلى اتهام أحزاب المشترك بأنها انفصالية، في محاولة منه لتخويفها من أجل التخلي عن دعمها لتلك الثورة وإيقاف أنشطتها الميدانية التي كانت خططت لها مسبقاً ضمن خطتها الشعبية لدعم مشروع برنامجها للإصلاح السياسي. ولما شعر النظام بجدية الموقف ولامس الخطر بدأ باستخدام أوراق أخرى إحداها كانت محاولة شق قيادات المتقاعدين بالمال والمناصب والوعود العسلية، غير أنه عجز كما عجز مع أحزاب المشترك التي رفضت دعواته للمهادنة في بداية الأمر، لكنها لم تسلم من خديعته حين اعتقدت أنها يمكن أن تستغل هذا الحراك الشعبي لتحقيق مكاسب وطنية عامة تدخل في إحداث إصلاحات جوهرية تطال عمق الاختلالات التي يستند عليها النظام في بقائه. وعلى أساس ذلك استأنفت أحزاب اللقاء المشترك حوارها مع الحاكم، مع إصرارها على عدم التخلي عن حق المتقاعدين وغيرهم من فئات الشعب في ممارسة أنشطتهم السلمية من مظاهرات واعتصامات، في الوقت الذي كان إعلام الحزب الحاكم يحذرها من ذلك ويتهمها بـ"الكيل بمكيالين".
متلازمة الاستغلال
وفيما كان مؤملاً من هذا التناغم بين الحركة الشعبية والمعارضة، إحداث نقلة نوعية في القوانين الناظمة لإصلاح كافة الاختلالات التي عانى منها الشمال والجنوب، انتقل النظام إلى استخدام بعض من ظل يستخدمه كأوراق لشق الحزب الإشتراكي، منذ ما بعد مؤتمره العام الخامس بشكل واضح. هذه المرة لشق الحركة التحررية الشعبية. وظهر من يتحدث بلسان ثورة الحقوق السلمية ويكتب دفاعاً عنها، لكن بطريقة من شأنها أن تحدث شروخاً في بنيانها. لقد ظهر من يقول أن "الوحدة لم تتم أصلاً" وأن على اللقاء المشترك أن لا يتدخل في قضية الجنوب، وأن قضية الجنوب قضية جغرافية محدودة وليست قضية شعب بأكمله.
والذي قرأ ما كتبه أحد هؤلاء المنظرين بتمعن سيدرك حتماً أنه أراد من الآخرين التخلي عن دعمهم للحركة الشعبية، فهو سعى فيما كتب إلى تأكيد أن القضية الجنوبية لا تريد تدخلا من الشماليين. وهذا مخطط واضح لإفقاد الحركة فاعليتها وتأييدها، وزخمها الكبير الذي يؤمل منه التوسع ليشمل استعادة الحقوق في اليمن بكامله. وهو (أي هذا المخطط) هدف أيضا يسعى النظام الحالي الوصول إليه. بل من المعلوم أن أي حركة ثورية تسعى لكسب تأييد واسع من مختلف القوى الداخلية والخارجية. غير أن إطلاق مثل هذه التصريحات ينافي تماماً هذا المنطق وبالتالي يتضح الهدف الحقيقي منها.
تحويل الزخم
أمر آخر يرتبط بمحاولة تجزيء المشكلة وبالتالي حلولها: من وطنية كلية إلى مناطقية جزئية، وقد يقضي على الزخم الثوري الذي بدأ يتشكل ضمن الوعي الجمعي للمواطنين في شتى بقاع الأرض اليمنية.
ذلك أن هناك من يحاول الهروب بهذا الزخم الثوري من المشكلة الكلية القائمة على ظهر النظام الفاسد في كل الوطن، إلى تجزيئها لتبدو وكأنها خاصة بفئة ومنطقة. ومثل هذه التصرفات والأفكار تخدم النظام الفاسد وتحيل كافة التراكمات والتضحيات التي قدمتها القيادات سواء في الحزب الإشتراكي (باعتبار شعبيته الجنوبية) أم في بقية أحزاب الشمال، إلى سلة المهملات السياسية. إذ أن مثل تلك التضحيات الكبيرة التي قدمت على مدى 17 عاماً من عمر الوحدة والديمقراطية، بغرض الوصول إلى الثورة الكبرى لإحداث إصلاح في نظام وطن، هناك اليوم من يحاول طمسها لإنعاش ثورة صغرى تستوحي مصالح أشخاص من خلال المطالبة بإحداث إصلاحات جزئية في منطقة جغرافية محددة.
بين استعادة وطن واستعادة سلطة
أما الأمر الثالث الذي من شأنه أن يضعف ثورة "المتقاعدين" قد يشبه إلى حد ما النقطتين السابقتين، لكنه في حقيقة الأمر يمتزج بينهما ليصنع نقطة مستقلة بذاتها. فالثورات حتى تصل إلى مرتبة أن تكون عظيمة يجب أن تكون مستندة على قيم عظيمة. وقيمة الثورة حين تسعى لاستعادة وطن مفقود بأكمله، حتماً أعظم من قيمة استعادة سلطة مفقودة.
ولقد ظهر اليوم من يفتخر بأنه يريد أن يتخلى عن الوطن الكبير، من أجل الحصول على وطن صغير. لا تقوده من قيمة إلى ذلك سوى توخي استعادة مجد أفل، ولاستعادة سطوة سابقة، يضحي بوطننا جميعاً من أجل وطنه هو.
أولئك الذين أوصلوا الوطن بكافة شرائحه عبر قراراتهم السياسية غير الحكيمة، إلى هذا الضعف، يسعون اليوم للتخلي عن الجميع لمجرد أنهم لمحوا بوادر فرصة اعتقدوا أنهم قد ينجحون بتوجيهها لمصلحتهم إذا اندسوا فيها لحرف مسارها الشعبي العام إلى الشخصي الخاص.
إن جزء من الشعب الذي احتفى بالوحدة كمنقذ له من خلال تحقيق "دولة النظام والقانون"، قد يخسر قيمه ويتخلى عن تراكماته النضالية ليقف مع دولة "اللاقانون"، إذا ما شعر أن هناك من يسعى لخيانته من أجل استعادة مصالحه الشخصية..!!. ومثل هذه التوجهات من الطبيعي أن تسندها وتستغلها الآلة الإعلامية للنظام القائم لعكس فكرة الثورة الكبرى ضده، الى ثورة يقود توجهاتها وأهدافها هو.
في مفهوم: أن جغرافية الشمال لا النظام هو المحتل
إن مثل تلك التنظيرات المتقعرة كما أرادت أن تصل بتفاعلية الثورة إلى نتائج مشوهة قد تخلط الأوراق ليعاد ترتيبها وفق مخطط مصلحي شخصي دون الولوج إلى العمق المؤمل منه لتصحيح مسار الوطن الواحد برمته، فإنها قد تصل بالوطن إلى تشرخات قد لا يمكن الوقوف بسهولة على علاجها. ذلك أن أحد مفاهيمها الخطيرة يسعى لتعزيز فكرة أن الجغرافية الشمالية احتلت الجغرافية الجنوبية في حرب 94م وما بعدها. وهي محاولة لتعميم مشكلة فساد تصرفات النظام الى الشعب. أو بمعنى آخر: محاولة تسعى إلى تحويل المشكلة من مشكلة قديمة قائمة بين الشعب والنظام الفاسد إلى مشكلة حديثة بين شعب في الشمال وشعب في الجنوب!
إن محاولة ترسيخ أن الشمالي عدو للجنوبي هو أخطر ما يمكن أن تنتجه تلك الخطة الخبيثة بغرض تبرئة النظام من أن يكون عدواً للجميع.
نهاية المطاف
من كل تلك المؤشرات قد تبدو ثورة المتقاعدين (التي اكتسبت، منذ بداية نشاطها الشعبي قبل 9 أشهر وحتى اليوم، تأييداً جماهيرياً واسعاً خرج لها أبناء الشمال قبل الجنوب) على شفا جرف هارٍ، قد ينهار بها طرفا الصراع على السلطة.
فاليوم ظهر من خارج السلطة -وتدعمه هذه الأخيرة- من يستغل هذه الثورة لضرب أحزاب اللقاء المشترك وبالتالي ضرب مشروع الإصلاح السياسي الوطني الشامل، والذي بات يهدد المناخ الشاذ الذي تنمو معه السلطة كحشرة متوحشة ضد شعبها. كما ظهر من يسعى لأن يستغلها لضرب مقومات الوحدة الوطنية، التي يعول عليها العمل كحائط صد قوي ضد توجهات وأد عملية التحول الديمقراطي نحو وطن النظام والقانون.
وعليه فقد يتوجب على قيادات اللقاء المشترك وقيادات المتقاعدين وكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية، التنبه لمثل تلك المحاولات، والإبقاء على زخم وقوة ثورة التحرر والحقوق الشعبية لتمتد على طول الوطن وعرضه لاستعادة وطننا الذي إن افتقده إخواننا في المناطق الجنوبية منذ 13 عاما، فإن إخوانهم في المناطق الشمالية افتقدوه منذ ما قبل تلك الفترة بأكثر منها.
علينا أن نؤمن أننا نبلي بلاء حسنا حتى الآن.



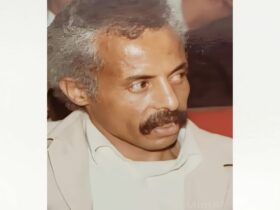


على شبكات التواصل