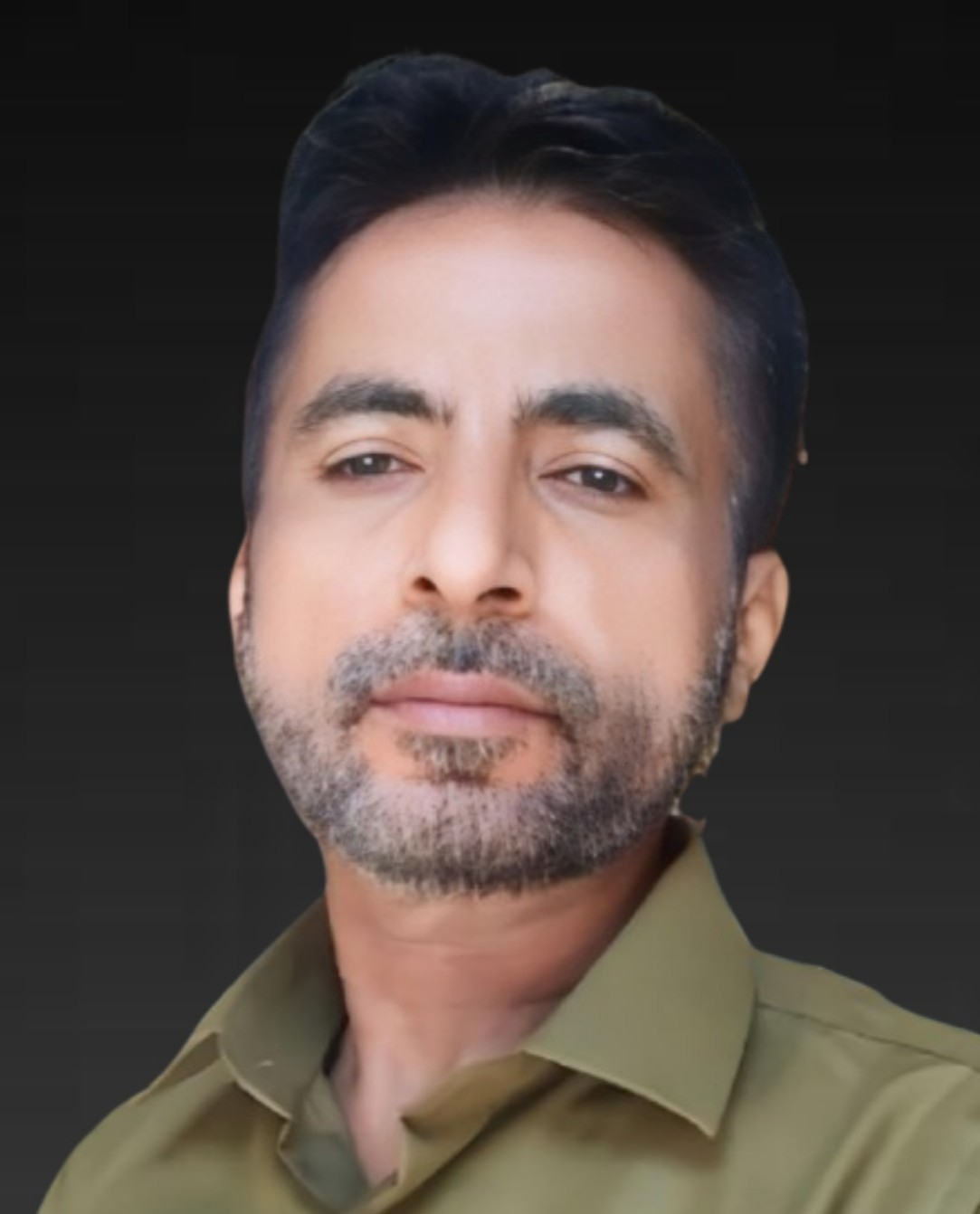نادية الكوكباني.. من عمارة الحجر إلى هندسة الذاكرة

نادية الكوكباني واحدة من تلك الأصوات التي تشبه الأمكنة العتيقة، كلما اقتربت منها اكتشفت طبقة جديدة من المعنى، وكلما حاولتَ اختصارها أفلتت منك إلى اتساع أكبر. لم تدخل الأدب مصادفة ولا بوصفه هواية جانبية، بل جاءت إليه محمّلة بوعي مزدوج. وعي المعمارية التي ترى العالم فضاءً قابلاً لإعادة التشكيل، ووعي الكاتبة التي ترى الإنسان سؤالاً مفتوحاً على القلق والذاكرة والهوية.
انتقالها من العمارة إلى السرد لم يكن انتقالاً من علم إلى فن، بل من بناء الحجر إلى بناء الإنسان. ما تفعله في نصوصها يشبه تماماً ما يفعله المعماري الجيد. تحترم الفراغ وتقيس الضوء وتترك للنوافذ وظيفة التنفس. نصوصها ليست مكتظة بالبلاغة بل مشغولة بالهواء، بالمسافة بين الجملة والأخرى، وبالوجع الذي لا يقال كاملاً. وبين العمارة والسرد بنت مشروعها الأدبي كما تُبنى المدن القديمة، طبقة فوق طبقة وحكاية فوق حكاية دون أن تفقد الروح أو المعنى.
الكتابة عند نادية ليست احتفالاً بالجمال بقدر ما هي محاولة لإنقاذ ما تبقى من المعنى. تكتب لأن الصمت لم يعد صالحاً، ولأن الواقع أكثر قسوة من أن يُترك بلا شهادة. هي ليست روائية بالمعنى الوظيفي، ولا قاصة بالمعنى التقني البارد، بل كاتبة تحمل مشروع رؤية، وتكتب كما لو أنها ترمم ذاكرة بلد يتداعى من الداخل.
تمثل نادية الكوكباني في المشهد الثقافي اليمني حالة نادرة. كاتبة تكتب من قلب المجتمع لا من هامشه، تستدعي التاريخ لا لتقديسه بل لمساءلته، وتستحضر المرأة لا بوصفها ضحية فقط، بل بوصفها شاهدة وصانعة معنى. في نصوصها لا نجد المرأة صورة رومانسية مزخرفة، بل كائناً يتصارع مع القهر والذاكرة والجسد والمدينة والعائلة والسلطة. المرأة عندها ليست موضوعاً أدبياً، بل ميزاناً خفياً لعدالة الحكاية.
بدأت بالقصة القصيرة وليس ذلك تفصيلاً عابراً. فالقصة عندها مختبر لغوي ونفسي، تُجرّب فيه التكثيف وحدّة المشهد واقتصاد العبارة. مجموعاتها مثل "زفرة ياسمين" و"تقشير غيم" و"نصف أنف… شفاه وحيدة" تكشف عن صوت سردي شديد الحساسية يلتقط التفاصيل التي تمر عادة بلا انتباه. نظرة امرأة، ارتباك جسد، صمت غرفة، أو انكسار داخلي لا يجد لغته. قصصها لا تصرخ لكنها تترك أثراً يشبه الوخز الخفيف الذي لا يزول سريعاً. تكتب عن العادي لتكشف ما فيه من انهيار كامل، وعن البسيط لتفضح ما يخفيه من مأساة مكتومة.

لكن التحول الأبرز في مشروعها جاء مع الرواية. هناك اتسع صوتها، واتسعت معه خريطتها السردية. في "حب ليس الا" أعلنت حضورها كروائية تمتلك حساً إنسانياً عميقاً في تناول العلاقات والهشاشة العاطفية. ثم جاءت "عقيلات" لتشكّل منعطفاً حاسماً، حيث انتقلت من الفرد إلى الجماعة، ومن الحكاية الخاصة إلى الذاكرة النسوية الجمعية. لم تكن تكتب عن نساء بقدر ما كانت تكتب عن مجتمع كامل من خلال أجساد النساء وصمتهن الطويل. الرواية هنا ليست بياناً نسوياً بل وثيقة إنسانية تقول إن المرأة ليست هامشاً في الحكاية اليمنية بل قلبها المخفي.
وفي "صنعائي" بلغت العلاقة بين الكاتبة والمكان درجة نادرة من التماهي. صنعاء لم تعد خلفية سردية، بل كائن حي، يشيخ ويغضب ويحب ويتألم. الرواية هنا ليست عن مدينة، بل عن العلاقة المعقدة بين الإنسان ومكانه، عن الكيفية التي تصنعنا بها المدن كما نصنعها نحن، وعن تحوّل الذاكرة العمرانية إلى ذاكرة روحية.
أما "سوق علي محسن" فكانت مغامرة جريئة في الاقتراب من مناطق شائكة في التاريخ الاجتماعي والسياسي، حيث تتحول السوق إلى استعارة كبرى لليمن نفسه: الفوضى، التعدد، الصراع، والبحث الدائم عن نجاة مؤقتة.
وفي أعمالها الأحدث وخصوصاً "هذه ليست حكاية عبده سعيد" الفائزة مؤخراً بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية 2025 في مصر، نلمس ذروة نضجها السردي. العنوان وحده يعلن أن الحكاية لم تعد حكاية فرد، بل حكاية بلد وذاكرة وطبقات من الالتباس والألم. هنا تبلغ لغتها درجة عالية من الصفاء، حيث تختلط السخرية الخفيفة بالحزن الثقيل، والواقعية القاسية بالشاعرية الخفية

ما يصنع فرادة نادية الكوكباني ليس براعة لغتها فحسب، بل نظرتها العميقة إلى فعل الكتابة ذاته. لغتها منخفضة النبرة لكنها كثيفة الدلالة، لا تستعرض جمالها بل تهمس بمعناها. لا تغوي القارئ بزخرف البلاغة بل تستدرجه بصدق التجربة. لا تصرخ في وجهه لكنها تدفعه إلى مواجهة أسئلة ثقيلة لا مهرب منها. شخوصها يبدون عاديين في ظاهرهم غير أنهم يحملون براكين مكتومة، والمكان في سردها ليس خلفية محايدة بل قدر يتشكّل حوله المصير.
هي لا تكتب لتلميع الواقع بل لتفكيك طبقاته وكشف ما يتخفّى تحت سطحه. لا تمنح القارئ طمأنينة الأجوبة الجاهزة بل تزرع فيه قلق السؤال وتتركه مفتوحاً على احتمالاته. في كتابتها تشعر أن السرد ليس زينة جمالية بل موقف أخلاقي، ومحاولة عنيدة لحماية الذاكرة من التآكل، والإنسان من أن يُختصر في صورة مبسطة أو حكاية ناقصة.