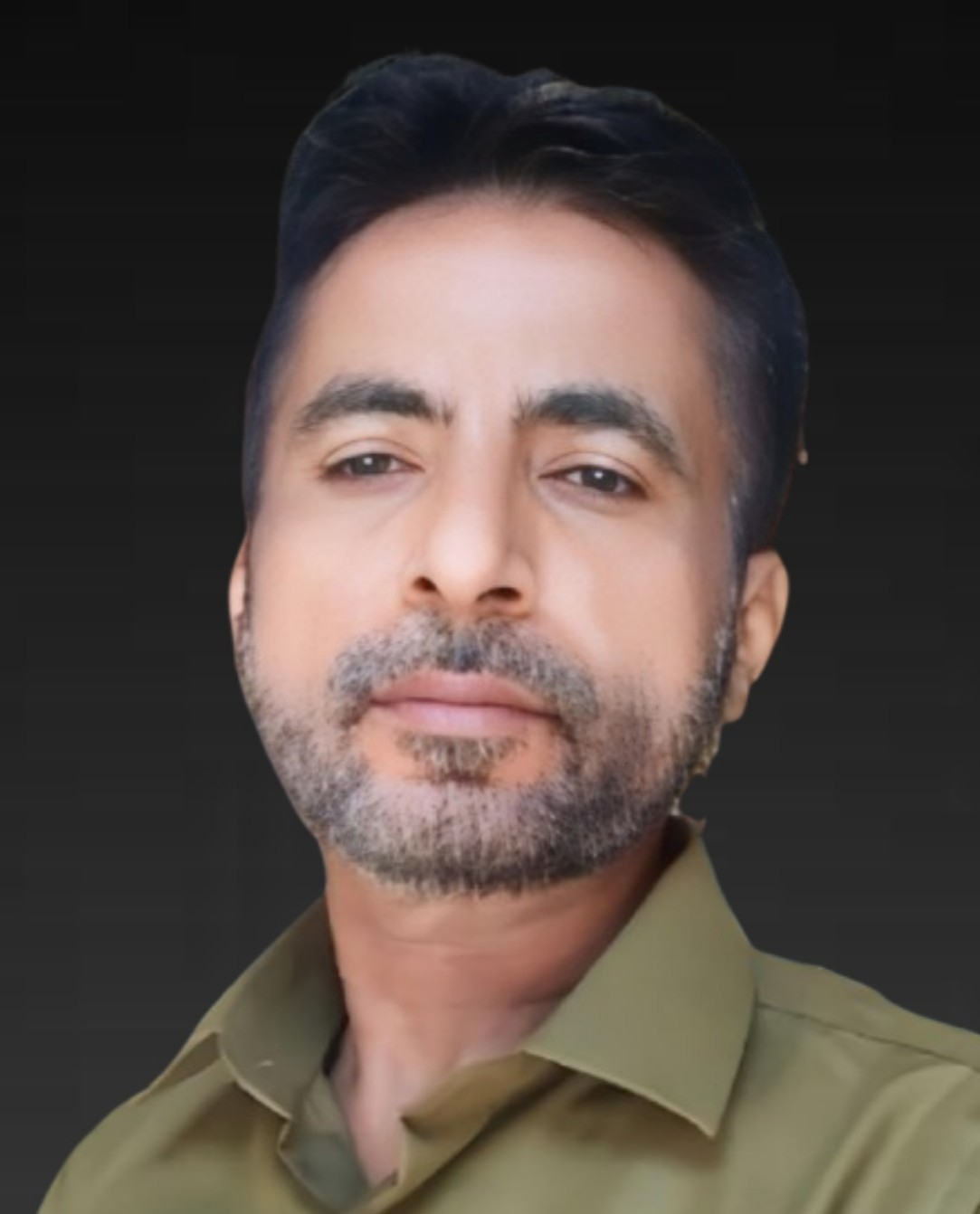مسيح دارفور.. البحث عن معنى للحياة في مقبرة مفتوحة
"أهون لجمل أن يلج من ثقب إبرة من أن يدخل الجنجويد ملكوت الله" - مسيح دارفور
في دارفور الأرض التي احترفت الاحتراق، لم يعد الدخان بحاجة إلى شهادة ميلاد. هناك في غرب السودان تنبت الأسطورة من رماد الجثث ويخرج "المسيح" لا من رحم العذراء بل من رحم الحرب.. وفي روايته "مسيح دارفور" لا يكتب عبد العزيز بركة ساكن رواية عن الحرب بقدر ما يكتب إنجيلًا للخراب. إنجيلًا بلا بشرى وصليبًا بلا قيامة. رواية تبدأ حيث تنتهي الإنسانية وتنتهي حيث يبدأ النسيان.
في أرضٍ تآمر عليها المطر وارتدت السماء فيها ثوب الصمت، يولد "مسيح دارفور"، شاب غامض، يهمس الناس بأنه نبي جديد وأنه قادر على إعادة الحياة إلى القرى المحروقة. يؤمن به البسطاء، لأن الإيمان آخر ما تبقى لهم بعد أن سرقت الحرب كل شيء، البيوت والحقول وحتى الخوف نفسه. لكن الكاتب بدهاء ساخر يجعل هذا المسيح رمزًا للمأزق السوداني نفسه، لا هو قادر على الخلاص ولا الناس قادرون على الكفر به. يتحول "المسيح" إلى أضحوكة دموية ثم إلى جثة جديدة على مذبح الأمل.
بركة ساكن لا يكتب عن دارفور كمنطقة في الخارطة بل كرمزٍ لكامل السودان. وطن تَشرب ترابه دماء أبنائه، ويغسل جراحه بخطابات رسمية مطرزة بآيات من النفاق.
القرى المحروقة في الرواية ليست مجرد خلفية للأحداث بل شخصية حية تئن وتتكلم وتلعن، بينما المدن البعيدة تمارس فضيلة الإنكار. وفي هذا التناقض بين "دارفور التي تموت" و"الخرطوم التي تتحدث باسمها"، تنكشف الهوة الأخلاقية بين السلطة والناس، بين الدولة والمجتمع، بين الحاكم والمقهور.
في الرواية تتحول الأسطورة الدينية إلى أداة للبقاء، الناس يخلقون أنبياءهم كما يخلق الأطفال أصدقاءهم الخياليين. وحين يظهر "مسيح دارفور" لا يبحثون فيه عن الخلاص، بل عن سببٍ جديدٍ لتأجيل اليأس.. بركة ساكن لا يهزأ من الإيمان، بل من تحويله إلى مسكّن سياسي وجماعي، من استغلال العطش الروحي لتبرير القتل، ومن رفع راية الله فوق خيام النازحين التي تمطرها الطائرات.
الرواية تنظر إلى المأساة السودانية من ثقب صغير في جدار معسكرٍ للنازحين. كلّ وجه فيها يحمل نصفَ إيمان ونصفَ جرح. لا أحد بريء تمامًا ولا أحد مذنب تمامًا. حتى الجلاد في لحظة ما يبدو كأنه يبحث عن مغفرة من ضحيّته. لكنّ الكاتب يذكّرنا بأن الحرب لا تتيح رفاهية التوبة، فهي آلة لا تتوقف حتى تُفرغ آخر قطرةٍ من المعنى.
لغة عبد العزيز بركة ساكن في هذه الرواية ليست حيادية ولا واقعية باردة. إنها لغة مشبعة بالشعر، متوترة كوتر قوس في يد جندي أعمى. يجعل الجملة القصيرة تلمع كالطلقة، والجملة الطويلة تمتد كصرخة في صحراء بلا صدى. يمزج بين الديني والسياسي، بين القهر اليومي والرمز الكوني، حتى يصبح القارئ شريكًا في العذاب لا متفرجًا عليه.
في نهاية الرواية يُقتل "المسيح" بصمت روتيني، كأن موته إجراء إداري في وزارة النسيان. لا قيامة هنا ولا خلاص، فقط أرض تواصل إنجاب القتلى. وكأن الكاتب يقول لنا: في دارفور المخلّص الحقيقي ليس من يأتي ليُنقذ بل من يبقى حيًا ليحكي.
"مسيح دارفور" ليست رواية تُقرأ للمتعة بل لتُخزينا قليلًا. مرآة سوداء نرى فيها وجوهنا جميعًا، نحن الذين صمتنا عن المذابح ومررنا بجانب الأخبار كمن يمر بجانب قبر لا يعرف صاحبه.. ليست رواية عن دارفور فحسب، بل عن العالم الذي تواطأ مع دارفور بالصمت، وعن المسيح الذي قُتل، والإنسان الذي مازال يبحث عن معنى للحياة في مقبرة مفتوحة.