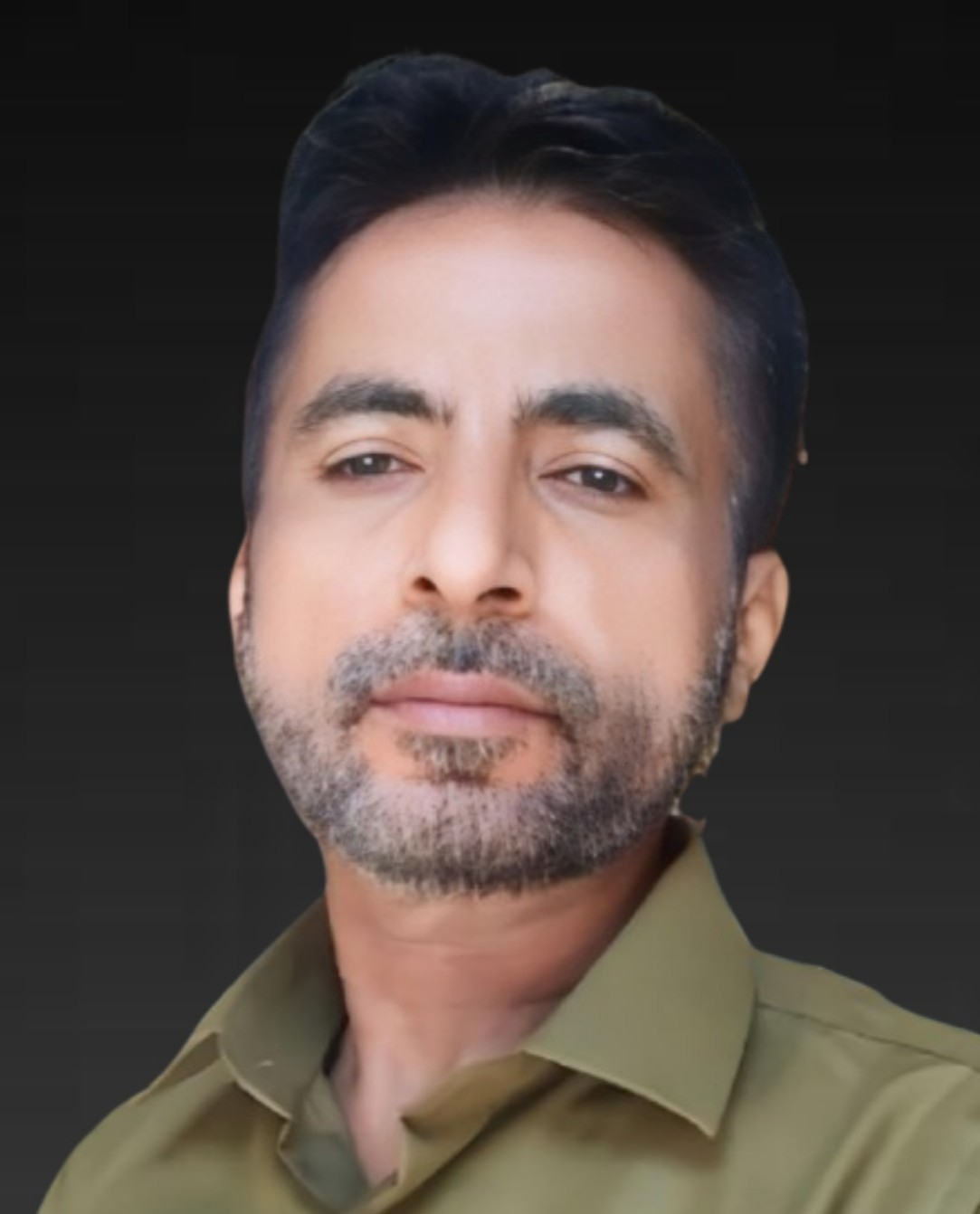ابن ملجم.. الحكاية تحت غبار المرويات
منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، ما تزال ضربة فجرٍ واحدة في مسجد الكوفة تُحدث رجاتٍ سياسيةً وعقائديةً إلى اليوم، كأن الزمن لم يمضِ، وكأن السيف ما زال معلّقًا في الهواء ينتظر أن يسقط على عنقٍ آخر.. حادثة مقتل علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي ليست مشهدًا دمويًا فحسب في سجلّ التاريخ، بل مرآة مشقوقة يرى فيها كل فريقٍ وجهه كما يشتهي. المنتسبون إلى علي رأوا فيها مأساة النور المسفوح فحوّلوها إلى كربلاءٍ مبكرةٍ، بينما خصومهم رأوا فيها تصحيحًا لمسارٍ زاغ عن الجادّة، فيما بقي المؤرخون يتبادلون الحبر واللعنات منذ ذلك الفجر وحتى اليوم.
ابن ملجم، هذا الاسم الذي تحوّل إلى كلمة مرورٍ للشيطنة في الذاكرة الإسلامية، لم يكن في بداياته ما يوحي بالدم أو الشر. كان تلميذًا من تلاميذ المصحف، يقرأه أكثر مما يقرأ نفسه. قرّبه عمرو بن العاص في ولايته لمصر ليعلّم الناس القرآن. لم يكن وحشًا خرج من كهوف التاريخ، بل واحدًا من حملة المصحف الذين قرّروا أن يعيدوا تفسيره في أرضٍ غارقةٍ بالدماء.
ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون، صُوِّر الرجل شيطانًا، لا لأنه كان كذلك، بل لأن المنتصرين احتاجوا شيطانًا يعلّقون عليه ذنوبهم، فالحكاية دائمًا تحتاج إلى شريرٍ لتبدو صالحةً للعرض.. ومع ذلك، حين نزيح الغبار عن المرويات ونعيد قراءة الحكاية بنظارةٍ أقل تورعًا عن السؤال، سنكتشف أن ابن ملجم لم يكن قاتلًا مأجورًا كما أرادته الروايات المتأخرة، بل مشروعًا يائسًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دينٍ اختُطف، وسلطةٍ تحوّلت إلى إرثٍ قرشيٍّ مقدّس.
بعد الجمل وصفّين والنهروان، حين حوّلت قريش الإسلام إلى حلبةٍ دموية، وتحولت الخلافة إلى صراعٍ قبليٍّ على المقود، خرج من رحم الفوضى تيارٌ ثالث قال: لا لعليٍّ ولا لمعاوية، لا لدماء المسلمين باسم الله، ولا لخلافةٍ تُدار بالوراثة والسيوف.. سماهم التاريخ “الخوارج”، وكان ابن ملجم واحدًا منهم، شاهدًا على المجازر ومؤمنًا بأن من يملك الجرأة على الوقوف ضدّ عليٍّ ومعاوية معًا، لا يفعلها إلا بدافعٍ أخلاقيٍّ قاسٍ كقدرٍ لا يرحم.
لكنّ كتبة التاريخ الذين يحبون القصص أكثر من الفلسفة، اختصروا كل شيءٍ في امرأةٍ اسمها “قِطام” قالت له: “مهري رأس عليٍّ”.. اختزالٌ ذكوريٌّ ساذج لقرارٍ سياسيٍّ/دينيٍّ بالغ التعقيد. ابن ملجم كان يرى أن ثلاثي الحكم القرشي: عليًّا، ومعاوية، وعمرو بن العاص، هم رموز الفتنة التي لا تنطفئ إلا بقطع الرؤوس، وأن القضاء عليهم سيوقف طوفان الدم.
لعل في دوافعه ما هو أعمق من العقيدة نفسها؛ شعورٌ يمانيٌّ بالخذلان من قريش التي احتكرت الخلافة كما تحتكر القبائل الماء في موسم الجفاف. خذلانٌ متوارث منذ سقيفة بني ساعدة، حين قررت قريش أن تُقصي سعد بن عبادة عن الخلافة، فتحوّل اليمنيون من ملوكٍ ما قبل الإسلام إلى جنودٍ في معارك السادة الجدد.. فهم اليمنيون الرسالة: هذه دولة قريش، وما نحن إلا هوامش تُقرأ على مهل.
في قلب هذه الخيبة يمكن قراءة الضربة، لا كجريمةٍ بل كاحتجاجٍ يائسٍ بالسيف على التاريخ. لم يكن ابن ملجم يقتل شخصًا، بل يضرب فكرةً؛ فكرة احتكار قريش للدين والسلطة. أراد أن يوقف طاحونة الدم التي طحنت تسعين ألفًا في ثلاث معارك، وأن يردّ للإسلام عقله بعد أن استولى عليه الغضب.
ربما ظنّ أنه ينقذ الدين من رجاله. يُقال إنه حين ضرب عليًّا صاح: “لا حكم إلا لله، ليس لك يا عليّ ولا لأصحابك”، ثم تلا: “ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله”.. جملةٌ لو لم يقلها هو لقالها التاريخ نيابةً عنه، كأنه أراد أن يذكّرنا بأن المأساة الكبرى تبدأ حين يعتقد كل طرفٍ أنه يقتل باسم الله.
ولأن الحكاية لا تكتمل دون نهايتها المأساوية، فقد أُخذ الرجل بعد مقتل عليٍّ وقُطِّع، وقيل صُلب، وقيل أُحرِق، ليُمحى لا كشخصٍ بل كرمزٍ أراد التاريخ أن يلغيه.
لم ينتصر أحدٌ في النهاية.. عليٌّ قُتل، وابن ملجم أُحرِق، ومعاوية ورّث الملك لابنه، وبقي الإسلام يبحث عن عدله المفقود منذ النهروان. أما ابن ملجم فقد خرج من كتب الفقه إلى كتب اللعن، ومن التاريخ إلى الخرافة، يُستدعى كفزّاعةٍ لتبرير كل ظلمٍ جديد.
المفارقة الأكبر أن الرجل الذي أراد أن يوقف الحرب، صار هو الحرب ذاتها، والسيف الذي أراد إنهاء الدم صار عنوانًا للدم إلى الأبد. كأن التاريخ، في لحظةٍ عبثية، قرّر أن ينتقم بطريقته، ويتركنا نحن نختلف حول من كان على حق، فيما الضحية الحقيقية كانت ولا تزال: العقل الذي حاول أن يفهم.