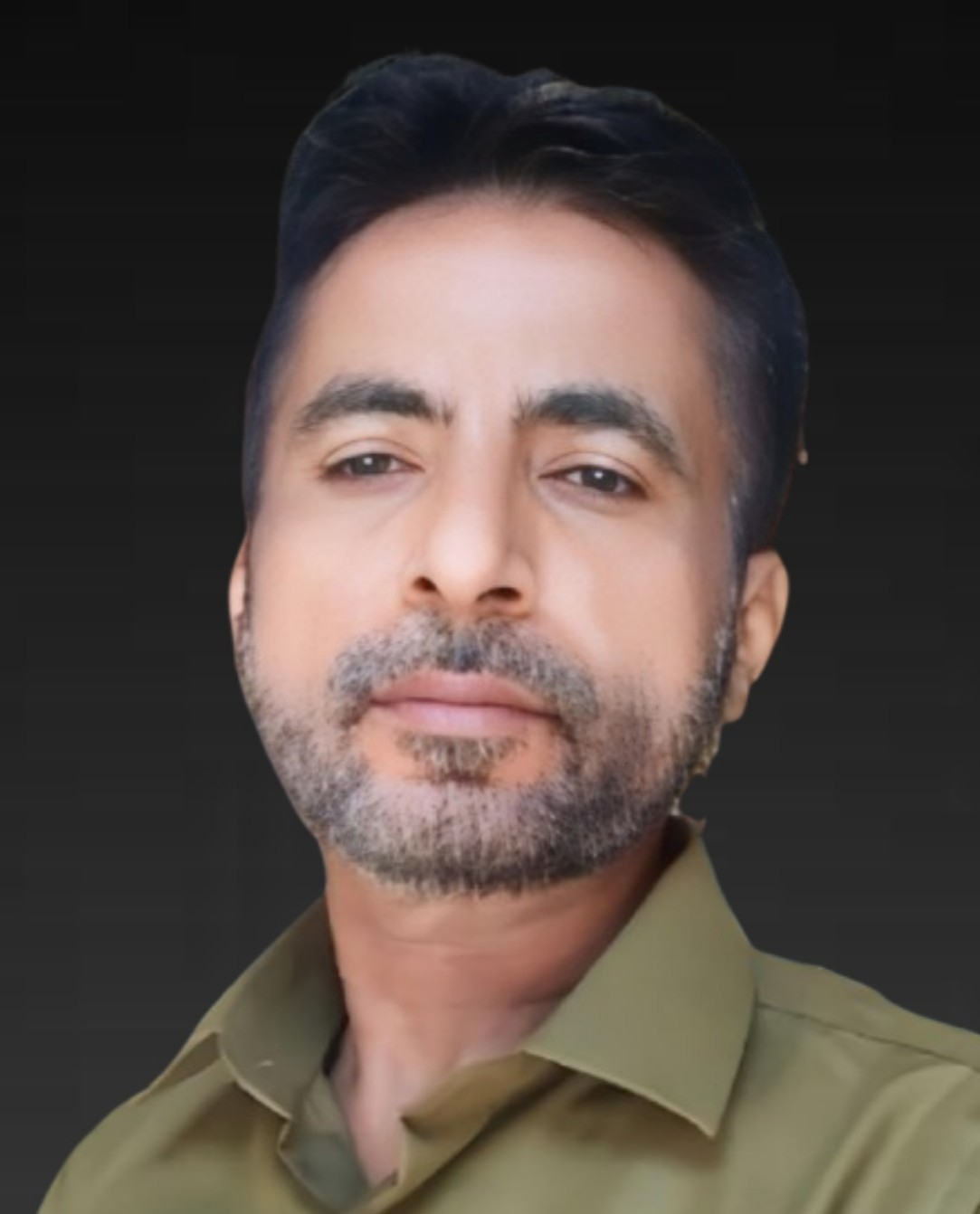التجربة التي انتهت قبل أن تبدأ
كان إبراهيم الحمدي يشبه تصحيحًا لغويًا في نصٍّ قبليٍّ طويل، حاول أن يصحّح الجملة، بينما أراد الآخرون حذف الصفحة كلها. جاء إلى السلطة لا من باب المصادفة، بل من نافذة الحلم التي تُطل عادة على الهاوية. ظنّ أن بالإمكان تهذيب الفوضى بالعقل، وأن اليمن يمكن أن يُدار كما تُدار مؤسسة لا كما تُقاد قافلة. لم يكن ثوريًا بالمعنى الرومانسي، بل كان موظفًا يحاول أن يُعيد للدولة معناها، فظنّه الجميع خصمًا لطبيعة الأشياء.
جاء الرجل في زمنٍ كانت فيه الدولة تُدار كمضيفةٍ قبليةٍ كبيرة، فيها المشايخ على الكراسي، والوزراء على الأرض، والضباط بينهما يوزّعون الولاءات. قرر الحمدي أن ينقل اليمن من حكم البركة إلى حكم الخطة، من إدارة الغنيمة إلى إدارة الدولة، فبدت فكرته كمن أراد أن يزرع ورودًا في معسكر.
لكن الإصلاح عندنا دائمًا مشروع انتحاري. فالذي يُصلح في اليمن عليه أن يُوقّع وصيته أولًا. إذ لا أحد يكره النظام أكثر من المستفيد من الفوضى، ولا شيء يُرعب الشيخ أكثر من دولةٍ لا تحتاج وساطته، ولا شيء يُغضب التاجر أكثر من ميزانٍ لا يُمكن رشوته. لذلك حين بدأ الحمدي يضبط إيقاع الدولة، بدأ خصومه يضبطون إيقاع مؤامرتهم.
ومع كل خطوة إصلاحية كانت تزداد حوله عزلة سياسية. لا قبيلة تحميه، ولا جار عربي يصفّق له. الرجل أراد الاستقلال السياسي عن الجوار، فأصبح الجار هو الذي يكتب مستقبله. أراد أن يحيّد القبيلة، فصارت القبيلة هي التي تُصدر له بيانات الوداع.
الطريف أن الحمدي لم يكن بلا أخطاء. فقد ظنّ أن بناء الدولة يمكن أن يتم بالقوة الأخلاقية وحدها، متجاهلًا أن السياسة اليمنية لا تُدار بالأحلام، بل بالتحالفات، وأن المشايخ لا يتقاعدون، بل يتوارثون الكراسي كما يتوارث الناس أسماءهم.
كما أنه في حماسه للتنمية أدار ظهره أحيانًا للتوازنات الدقيقة التي تقوم عليها السلطة، فصار عدوه هو "النظام" ذاته الذي حاول إصلاحه. كان رجلًا يسير بسرعة في طريقٍ مزدحم بالعربات المعطوبة، فانقلبت عليه إحداها في النهاية.
ثم جاء يوم الاغتيال، يوم أُغلق فيه دفتر الحلم بإتقانٍ إداريٍّ بارد. اختُتمت التجربة بدمٍ بارد وملفٍّ بلا ختام. ومنذ تلك اللحظة دخل الحمدي أسطورة اليمنيين لا بوصفه رئيسًا، بل فكرةً ميتة لم يدفنوها جيدًا. صار رمزًا لكل ما لم يتحقق، وباتت ذكراه مناسبةً سنوية للبكاء على ما كان يمكن أن يكون.
أما خصومه فقد مات بعضهم بالملل، وبعضهم بالرفاهية، وبعضهم بالإنكار، لكن أحدًا منهم لم ينجُ من لعنة السؤال الذي تركه الحمدي معلّقًا: هل يمكن لليمن أن يُدار يومًا بالعقل لا بالعصبية؟
من المفارقة أن عهد الحمدي القصير يبدو اليوم كحلمٍ طويلٍ مقطوع، وأن السنوات اللاحقة أعادت تعريف الكآبة الوطنية بمقاييس جديدة. صار المواطن اليمني بعده كمن يعيش في تجربة اجتماعية قاسية، كل جيلٍ يظن أنه الأسوأ، ثم يأتي الجيل التالي ليصحح له المعلومة.
الحمدي حاول أن يجعل من اليمن دولةً تشبه المستقبل، فجعله خصومه درسًا في الماضي. بنى الجسور، فهدموا الجسر الذي كان يقف عليه. حلم بالوحدة، فاستيقظت عليه الجغرافيا غاضبة. أراد أن يُعيد ترتيب الأولويات، فكان أول ضحية في جدول الإصلاحات.
وحين يتحدث اليمنيون اليوم عن "زمن الحمدي"، لا يتحدثون عن فترة حكمٍ بقدر ما يتحدثون عن شعورٍ فقدوه، الشعور بأن الدولة يمكن أن تكون شيئًا نزيهًا، وأن الرئيس يمكن أن يكون موظفًا لا مالكًا. لقد صار الحمدي بعد موته المواطن الوحيد الذي اتفق الجميع على أنه كان أفضل من الجميع. أما مشروعه فمازال يطلّ بين الركام كوثيقة غير موقّعة، عليها توقيعه ودمه معًا.