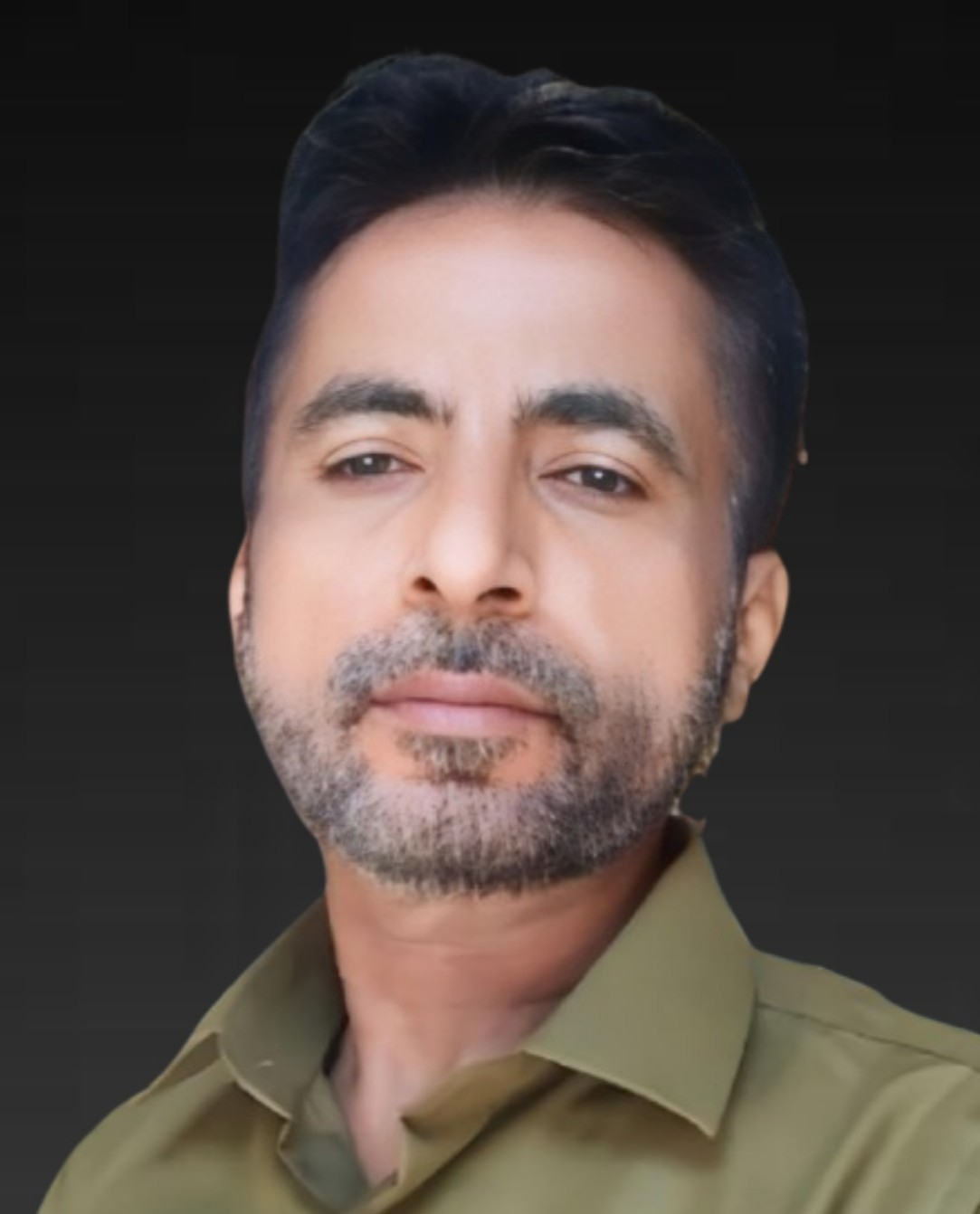حين جاء الطاعون على ظهر حصان
في اليمن، لا تحتاج إلى آلة زمن لترى القرون الوسطى، يكفي أن تفتح كتاب سيرة الهادي لتكتشف أن هذه البلاد كانت مختبراً مفتوحاً لتجارب سياسية ودينية بمسمى الإمامة. المشروع بدأ حين قرر يحيى بن الحسين - القادم من الرس - في القرن الثالث الهجري أن اليمنيين بحاجة إلى "إمام" يعلّمهم الوضوء .. دخل البلاد ومعه مشروع سماوي، لكن بنكهة عسكرية. كان الرجل يحمل السيف في يد، ونسخة من كتاب الأحكام في اليد الأخرى، وكأنه يقول لليمنيين "إما أن تحفظوا المتن أو أشرحه على جلودكم."
المؤرخون وصفوا تلك اللحظة بأنها "انكسار سياسي طويل المدى". نحن نعرفها باسم آخر : تأسيس أكبر شركة عائلية لإدارة الحكم في الهضبة. كان شعارها الرسمي "الإمام من آل البيت" أما ترجمتها الحقيقية فكانت "السلطة في بيتنا، والبقية خدم." .. كلما مات إمام بدأت بطولة مصارعة حرة بين أبناء العمومة، الفائز يصبح إماماً، والخاسر يكتب كتيباً عن فضل الصبر.
يحيى الرسي أو "الهادي"، لم يكن فقط مؤسس الإمامة، بل كان المؤسس الأول لفكرة أنّ اليمنيين "كفار" حتى يثبت العكس، وأنّ إمامته من الله، ومن رفضها فمصيره الحرق أو النفي أو تعليق جثته منكسّة على الأشجار، كما فعل ببني الحارث حتى أنتن الهواء وأُصيب الناس بالقرف قبل التوبة. الرجل لم يكن داعية دين بقدر ما كان مهندس خراب بارع .. يقطع الزروع، يحرق الكروم، يهدم القرى، ويعطل حياة الناس حتى يصرخوا ويقولوا "رضينا بالإمام"، وكأن الخراب كان هوايته المفضلة بعد صلاة الفجر.
ابنه أحمد ورث منه كل شيء السيف، العمامة، ودفتر الحسابات المفتوح على دماء اليمنيين .. صار الحكم ورشة مفتوحة لنزوات السلالة، وصارت الحروب بين أبناء العمومة موسماً سنوياً، ضحيتها الفلاح الذي لا يعرف لماذا يقاتل ولا كيف انتهت قريته رماداً، سوى أن أبناء البيت الرسي اختلفوا على المقعد الخشبي الذي يسمونه "الإمامة".
ثم جاء عبدالله بن حمزة، فقرر أن الشعب لم يتعلم الدرس جيداً. فرقة المطرفية تجرأت وقالت إن الإمامة تصلح لأي رجل كفؤ، فحوّل صنعاء إلى محرقة جماعية: مائة ألف قتيل في ثلاثة أيام، نساء سبين، رؤوس علّقت على الأبواب، والقرى تحولت إلى أطلال. كتب مؤرخو السلالة عن هذه المجزرة بوصفها "عين الصواب"، وكأن إبادة المخالفين صارت مادة في فقه السلالة.
وفي القرن العاشر الهجري، دخل شرف الدين وابنه المطهّر المسرح كأبطال لـ “المسرحية الدموية” في خولان وصعدة، حيث هدمت القرى وقطعت الأيدي والأرجل، وجرى التنكيل بالأسرى وكأن التاريخ كان بحاجة إلى درس تطبيقي في فنون الرعب. حتى شعراؤهم، بكل فخر، نظموا أبياتاً تمجد هذه المجازر وكأنها فتوحات، ولم يسلم الشعر من دم الضحايا.
ومع كل إمام جديد، كانت البلاد تدخل في دوامة حرب أهلية جديدة. ليس بين الهادوية وغيرهم فحسب، بل بين أبناء العمومة أنفسهم .. اليمني العادي كان يجد نفسه مجبراً على القتال في حرب لا يفهم سببها سوى أن "فلان بن الإمام يرى أن له الحق أكثر من ابن عمه"، فتتحول القرية إلى ساحة معركة ويصبح موسم الزراعة موسم دفن.
حتى حين اكتشف العالم الكهرباء واخترع الطائرات، كان الإمام يحيى يحكم اليمن كما لو أن الزمن توقف عند القرن الرابع الهجري. لا مدارس إلا ما يقرره، لا صحف إلا ما تمدحه، لا تجارة إلا عبر خزانته .. وعندما تمرّد الزرانيق، لم يكتفِ بقتالهم، بل سمّم شيوخهم واحداً تلو الآخر وكأنه يصفي حساباً شخصياً. أما ابنه أحمد، فقد كان يفضل أن يحرق بيوت خصومه بمن فيها بدلاً من أن يدخل في حوار سياسي، وكأن الحوار عنده بدعة.
وحين نصل إلى الأحفاد الجدد، نكتشف أن كل ذلك لم يكن سوى الموسم الأول من المسلسل. نفس خطاب الاصطفاء، نفس شهوة الدم، نفس الشعار العتيق، لكن مع مؤثرات صوتية من قناة المسيرة.. الإمامة لم تكن يوماً نظرية سياسية بل برنامج تصفية شامل لليمنيين، مشروع إعدام بطيء ممهور بختم السماء، وملف جرائم مفتوح منذ القرن الثالث الهجري وحتى آخر مقطع فيديو على تطبيق X.