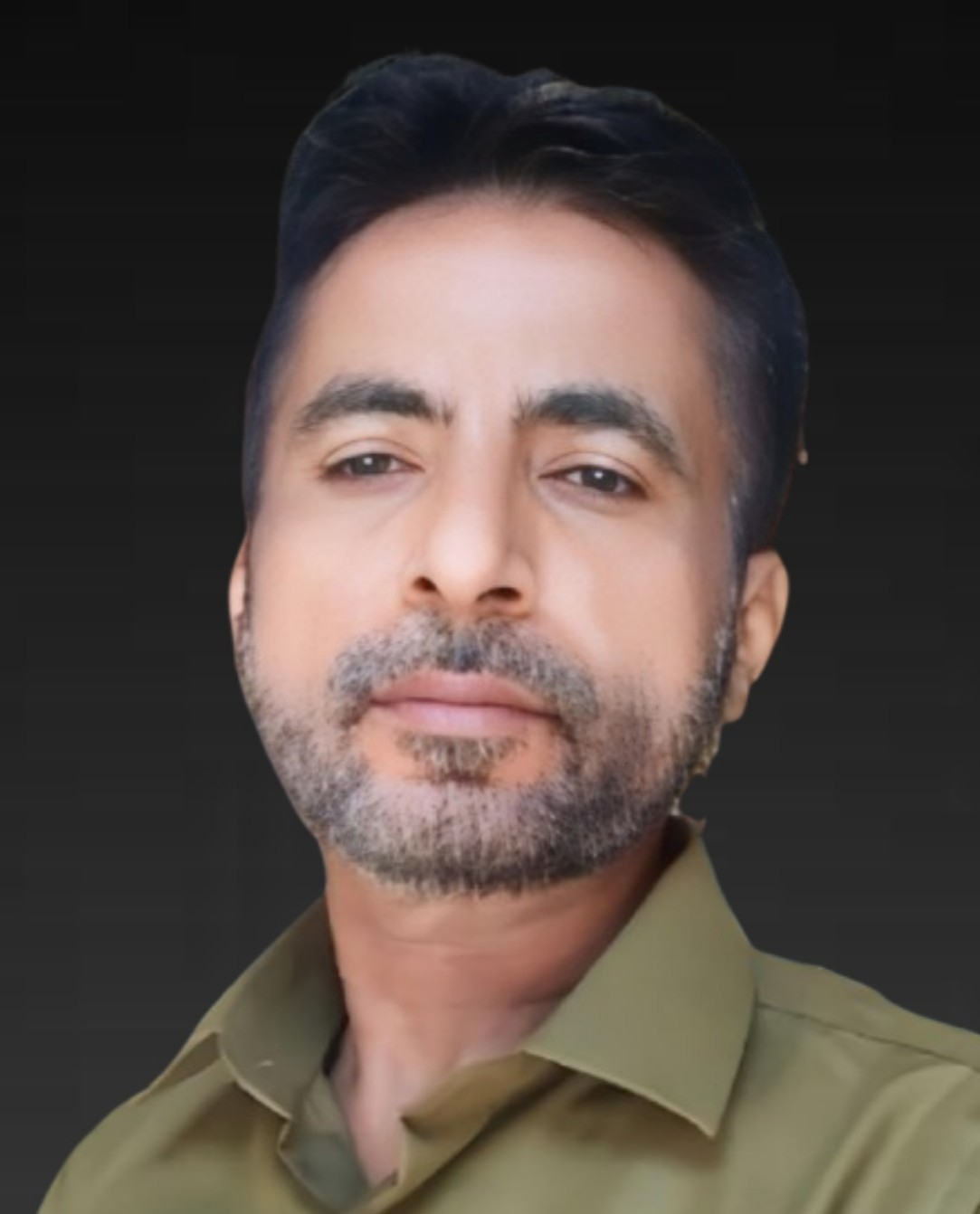الحكاية التي ظلّت تكتب نفسها بالرمز
لو كان للتاريخ هواية مفضلة، فهي أن يخبئ بعض الجماعات في خزانته، لا يخرجهم إلا لمامًا، ثم يترك المؤرخين يتجادلون أكانوا طائفة دينية، أم تنظيمًا سريًا، أم جماعة فلسفية مغلقة على أعضائها. الإسماعيليون من تلك الفرق التي اختارت أن تكون حاضرة بالهمس أكثر من الحضور بالهتاف.
الحكاية تبدأ مع انقسام في البيت الشيعي ذاته، حين وقف بعض الأتباع عند إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، ذاك الابن الذي مات شابًا قبل أن يتبوأ الإمامة، لكن موته لم يكن نهاية بل بداية حكاية أخرى.. فريق من الشيعة رأى أن الإمامة انتقلت إلى إسماعيل بالوصية، حتى لو غيّبته المنية. من هنا بدأ "السر" ينسج خيوطه، إمام غائب، إمام مستور، وإيمان بأن الحقيقة الكبرى ليست في العلن بل في الغياب، وأن الوارث الغائب قد يملك شرعية تفوق من جلس على الكرسي.
وبينما كانت الخلافة تتنازع على السيوف، قرروا أن يقيموا إمامةً من نوع آخر، إمامة الفكرة، إمامة التأويل.. وحين خرجت الدولة الفاطمية من رحمهم، أثبتوا أن الغموض يمكن أن يتحوّل إلى سلطة، وأن الفلسفة إذا تلبّست بعباءة العقيدة قد تصنع إمبراطورية تمتد من المغرب إلى القاهرة.. منذ ذلك اليوم باتت الطائفة الإسماعيلية تشبه جملة ناقصة في كتاب العقائد، كأنهم أبناء "مستقبل مؤجل" لا يُكتب على الورق، بل يُعاش بالتأويل.. لا يكتفون بظواهر النصوص، بل يتعاملون مع القرآن كما يتعامل فنان مع لوحة، يدخل في ألوانها، ثم يبحث عما وراء الخطوط.
قدّموا أنفسهم للعالم عبر "الباطن" حيث المعنى يتوارى خلف المعنى، والنص يتدلّى من نص آخر كستارة مسرحية لا تكشف إلا لمن يعرف الإشارة، حيث كل حركة إشارة، وكل كلمة ظلّ لمعنى آخر، فالحقيقة ليست ما يُقال بل ما يُخفى، والإسماعيليون فهموا ذلك باكرًا فبنوا فكرًا يقدّس الكتمان أكثر مما يعشق التصريح.
قرأوا الفلسفة اليونانية كما قرأوا الفقه الإسلامي، وأدخلوا الهرمسية إلى الموروث الفاطمي، حتى صار مذهبهم أشبه بحديقة من الرموز، كل وردة فيها تشير إلى ما هو أبعد من عطرها، لا جنة عندهم كما في وعظ الخطباء، ولا نار تشتعل لإرهاب العوام، بل درجات من المعرفة كالسلالم الصوفية ترتقي فيها حتى تبلغ "العقل الكلي"، ذاك السر الذي لا يهدد ولا يَعِد بل يكشف. لذلك ارتبك الفقهاء أمامهم.
هل الإسماعيليون طائفة مسلمة أم فلاسفة متنكرون في عمائم، أم مجاز شعري هارب من دفتر التاريخ؟ إنهم هذا المزج الماكر بين السياسة والعرفان، بين الخيال الميتافيزيقي والواقعية الصارمة. ولهذا ظلوا عصيّين على التصنيف، لا يستقرون في خانة محددة، لا هم سنّة ولا شيعة بالمعنى المدرسي، ولا هم خارج الإسلام بالمعنى اللاهوتي.. إنهم الحدّ الفاصل بين "الداخل" و"الخارج".
حين كان الخلفاء يرسمون خرائط الفتوحات بالدم، كان الإسماعيليون يرسمون خرائطهم بالحيلة، يرسلون دعاتهم في الأسواق، في القرى، بين العابرين، كمن يزرع بذورًا في تربة لا يعرف صاحبها أنها خضعت للزراعة. لذلك كان تاريخهم مليئًا بالهمس، بالسرية، بالانتظار الطويل.
السرّ يزداد قوة كلما لم يُكشف، ولعل هذا ما جعل الإسماعيليين يعيشون قرونًا كظلّ مراوغ في كتب التاريخ. لا تُمسكهم بسهولة، كلما حاولت تعريفهم تاه التعريف منك.. هم مع الفاطميين لكنهم ليسوا كل الفاطميين. هم شيعة لكنهم ليسوا كبقية الشيعة. هم مسلمون لكنهم ليسوا نسخة مألوفة من الإسلام.. هل هم "طائفة" أم "فكرة"؟ الأقرب أنهم تجربة باطنية مشتهاة، لم يرد لها التاريخ أن تكون واضحة.
الإسماعيليون، أو أبناء الإمام الغائب، أو القرّاء الذين لا يكتفون بالسطور.. هم ببساطة، الحكاية التي ظلّت تكتب نفسها بالرمز، ثم تركت للعالم أن يحار بين أن يصدقها أو أن يخافها.