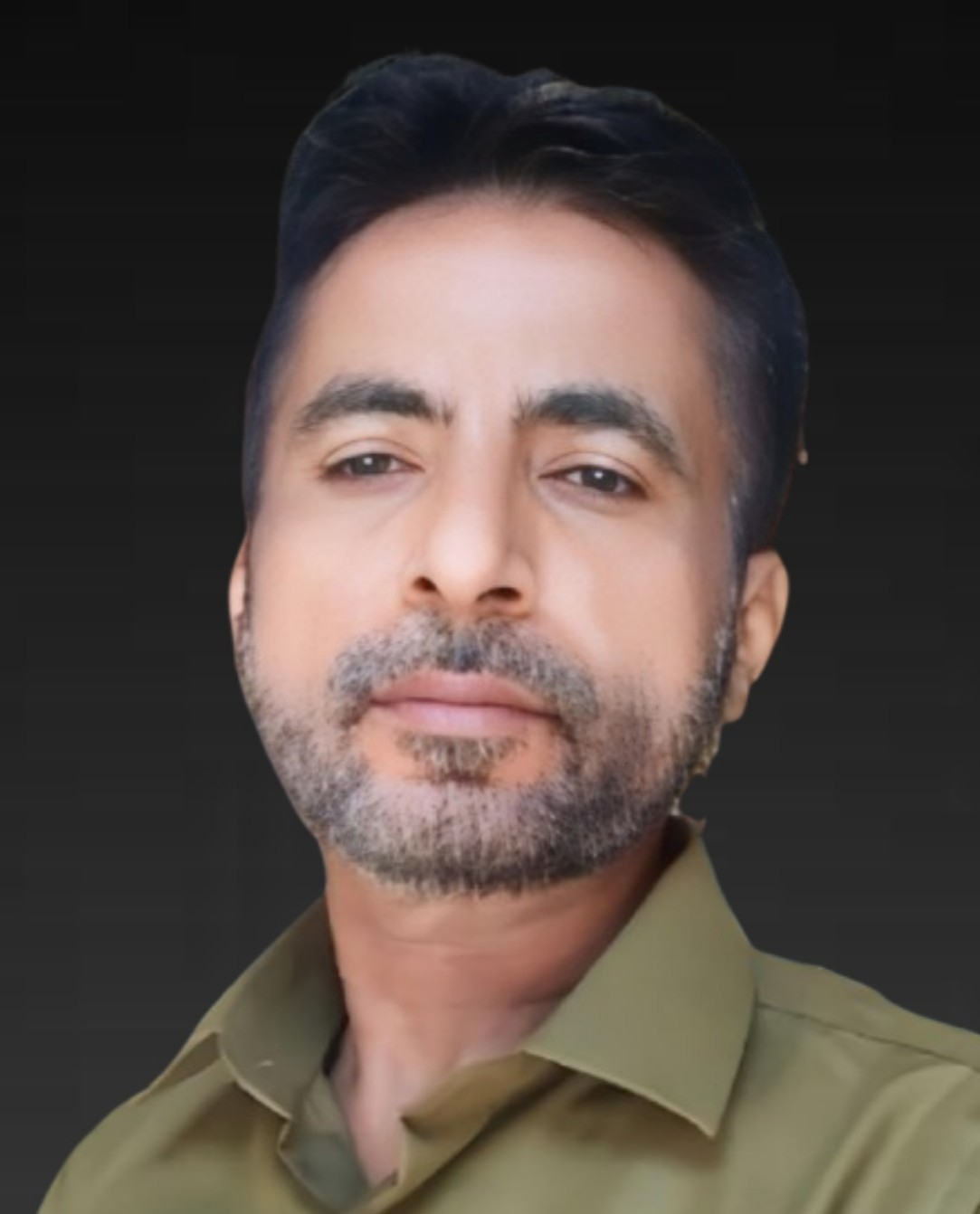مدينة تذكُر أنها كانت شيئًا ما
في بلادٍ يشكّ الناس في كل شيء إلا الخراب، لم تُصب الحديدة بالشيخوخة الطبيعية، بل أُسقِطت عليها السنون دفعةً واحدة، كما تُرمى بقايا الولائم في البحر. مدينة وُلدت مرفأً، وحلمت أن تكون حاضرةً بحرية، فانتهى بها الحال عشةً مهترئة تُطِل على البحر، لكن لا تراه.
ولدت الحديدة لا كمدينة، بل كخطأ طباعي في رواية تاريخية مشوشة. لم يُتح لها أن تهرم كما تفعل المدن العادية، بل ألقيت عليها الشيخوخة دفعة واحدة.
وُلدت مرفأً، لكنها لم تغادر المهد يومًا. بقيت هناك، تتأمل السفن تمر، كما يتأمل العاطل عن العمل إعلانات التوظيف.
من أيام المخا العثمانية حتى بهرجات التحديث الوهمية، تسير الحديدة بقدم واحدة، وتُزلق الأخرى في وحل الجغرافيا. أعطوها لقب العاصمة العثمانية (1849-1873)، فاحتفلت ثم تخلّت عنه سريعًا، كفتاة أُلبست فستان زفاف مُستعارًا، ثم عادت إلى المطبخ قبل نهاية العُرس.
ولأن قناة السويس غيّرت قواعد اللعب، تحوّلت الحديدة إلى ممر دولي للغزاة الجدد. لم تأتِ الإمبراطوريات لتبني فيها شيئًا، بل جاءت لتجرب عليها هواياتها العسكرية.
ومن سوء طالعها أنها وقفت على البحر، لا على نبع نفط. ولهذا لم تأتِ القوى الدولية لتصنع فيها مدينة، بل لتقصف ما تبقّى منها. العثمانيون، البرتغاليون، الإسبان، الطائرات الإيطالية، والبريطانية. إلى عاصفة الحزم، وعمليات حارس الازدهار والذراع الممدودة.
هذه المدينة جُرّبت بكل طرق الإهانة الدولية تقريبًا، إلا الزلزال، وربما هو في الطريق، لكن يبدو أن الطبيعة في طريقها لتجريب آخر أوراقها.
هنا "حارة السور" الاسم وحده كافٍ لتذكيرك أنك في مدينة تعرف أنها كانت عظيمة، ولكنها تنسى التفاصيل عمدًا. الحارة التي كانت يومًا محاطة بسور له أربعة أبواب -باب مشرف، باب النخيل، باب اليمن، باب الستر- تحوّلت إلى متاهة لا سور لها.
بول إميل بوتا ذلك العالِم الفرنسي ذو المزاج اللاتيني، كتب ببهجة عام 1836: "شوارع الحديدة أنظف من شوارع القاهرة"، وأشاد بعمارتها التي كانت تلمع تحت الشمس، وكأن البحر ذاته كان ينحني احترامًا. كان ذلك قبل اختراع البلاستيك، وقبل أن تصبح الأكياس السوداء وسائد نوم لكائنات بلا مأوى.
المباني التي لاتزال صامدة، من الطوب الأحمر المحروق، تقف كحُفَرٍ معمارية في جسد الزمن، تذكّرنا أننا ذات مرة عرفنا معنى المشربيات، والسقوف المنقوشة التي تتدلّى منها بقايا أناقة سابقة، قبل أن يُغشى البصر بالأسمنت والقمامة.
هذه المدينة لا تُهدم فقط، بل تُستبدل بنُسخ رديئة عنها، في كل زاوية، تتناسخ في صور أكثر قبحًا، كأنها تُمارس نوعًا من إعادة التدوير المَرَضي للخيبة.
في الرصيف البحري، حيث كانت السفن تفرغ شحناتها على ظهور الرجال لا الرافعات، تبدو الحديدة تمثيلًا حيًّا لعصرٍ تجاوزها بنيةً ومعنى.
جاء المخرج السوفياتي فلاديمير شنايدروف، عام 1929، التقط صورًا، صنع فيلمًا، وكتب كتابًا، ثم عاد إلى بلاده تاركًا خلفه مدينةً لم تَعِ بعد أنها بدأت الغرق. أما نحن، فأصدرنا فيلمًا واحدًا: فيلم طويل، ممل، بلا نهاية... اسمه "النسيان".
قلعة المدينة، التي بُنيت حامية، تحوّلت إلى سجن. تمامًا كما تحوّلت الثورات إلى جنازات، والوعود إلى نشرات، والسياسة إلى دعابة حزينة. القلعة لا تحمي أحدًا، بل تُذكّرك أن السجن في اليمن غالبًا ما يكون أعلى نقطة في المدينة.
أما الشيخ صديق "الشاذلي"، الذي قيل إنه "حامي الحديدة"، فقد دُفن خارجها. من باب الحذر ربما، أو لأنه أدرك أن من يحمي هذه المدينة سينتهي حتمًا مدفونًا بعيدًا عنها.
الحديدة مدينة أُشبعت بالقصف، هي الميناء الذي صار إشاعة. ذاكرة نصفها محو، ونصفها الآخر صدى لما كان. وعلى الرصيف، يجلس البحر، يتأمل المدينة... ويتساءل إن كانت لاتزال تعرف الفرق بين الزرقة والندم.
إنها مدينة تكتب التاريخ بالماضي التام، وتعيش الحاضر بالمجهول المستمر. كأنها تتقن فنون الانقراض البطيء، وتُجيد استقبال الزوار بالمقابر المفتوحة، والخرائط المطوية، والبحر الذي لا يعود.