حَيَاة في الإدَارَة
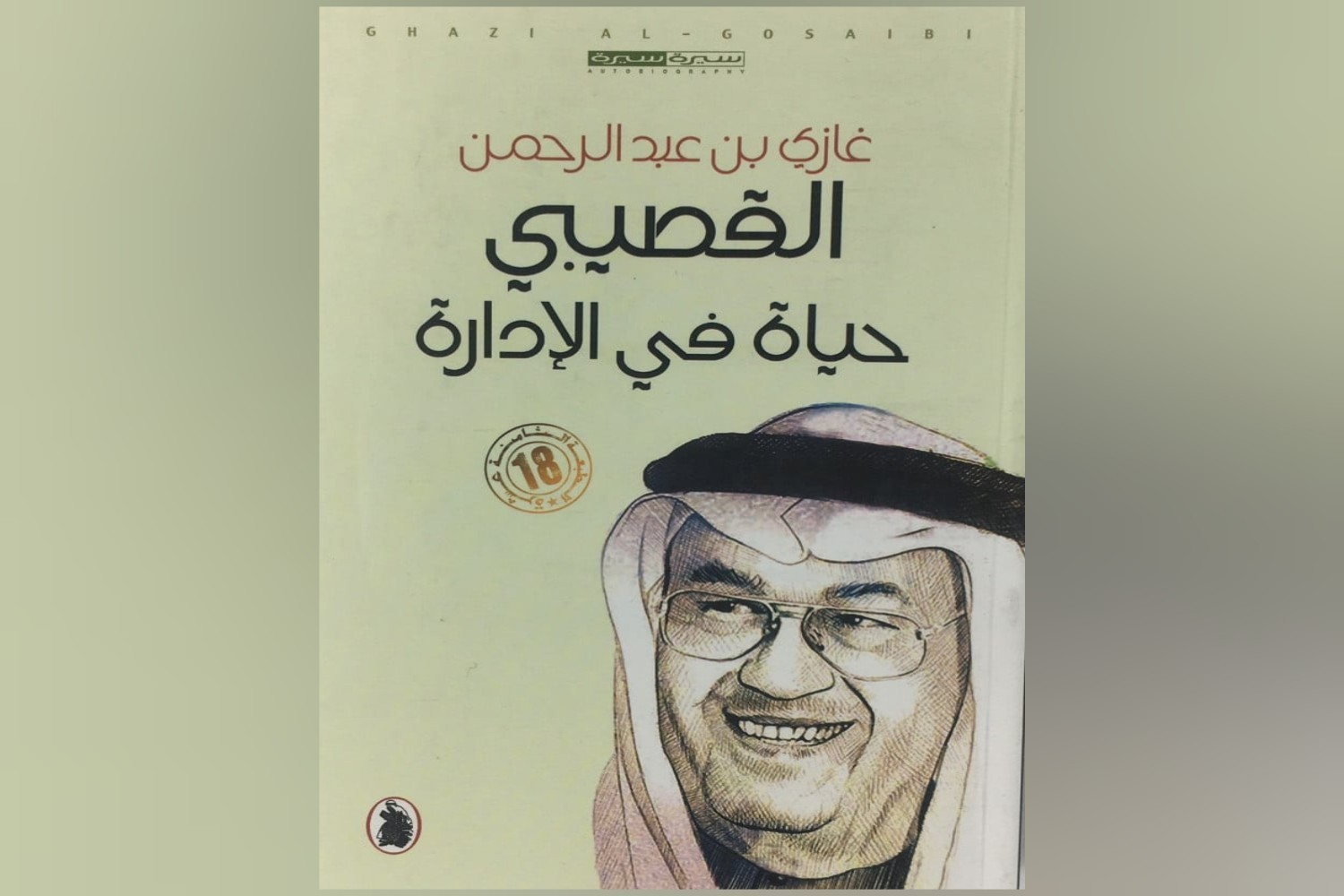
من الكتب الحديثة والقليلة التي قرأتها غير مرة، كتاب "حياة في الإدارة"، للدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي، رحمه الله.
لقد قرأته للمرة الأولى، بطبعته الأُولى عام 2002م، إن لم تخني الذاكرة.. فقد ألفه كاتبه نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم، أيام كان سفيرًا لوطنه بلندن.
ثم عدتُ لقراءته بطبعته العاشرة، وإن لم أتذكر هنا تاريخ تلك العودة!
وها أنا أعود لقراءته للمرة الثالثة، وهو بطبعته الـ18 التي صدرت عام 2020م.
وكتاب عربي حديث، بخاصة مع انتشار "النت" ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومع ذلك، تعاد طباعته خلال عشرين عامًا أو أقل للمرة الثامنة عَشْرة، لا بد من وجود تميز خاص به، شأنه في ذلك شأن الكتب القليلة المُماثِلة.. وكما اكتشفت بعضًا من أسباب إعادة قراءة كتاب "الأيام" لطه حسين، و"بين الصحافة والسياسة" لهيكل، و"لا تحزن" للشيخ عائض القرني، وأمثال ذلك، فقد أحسب اكتشافي لتميز كتاب "حياة في الإدارة"، فرغم عدم وجود فوارق بين طبعات الكتاب حسب فهمي، إلا أنني كلما عُدت إلى قراءته، شعرتُ بجديدٍ فيه، وكأنني لم أقرأه قبلًا! وإن لم يكن الكتاب الوحيد للقصيبي -رحمه الله- وهذا هو ما تميزت به مؤلفاته عامة و"حياة في الإدارة" خاصة، من أسلوب استثنائي سَلس، كونه شاعرًا وأديبًا وروائيًا، ليستغل ذلك كله في نقل خبراته القيادية والإدارية المتعددة في كتابته لهذا الكتاب، وربما ذلك من أسباب الرغبة في إعادة قراءة الكتاب، إضافة إلى استخدامه مفردات سهلة قد يسهل فهمها لدى "الشباب" المَعنيين بهذا الكتاب من خلال إهدائه لهم قبل غيرهم!
لقد ألَّف القصيبي أكثر من عشرين مؤلفًا في مجال الشعر والرواية والنقد والتربية والتنمية والفكر السياسي والدراسات البحثية وغيرها.. وأزعم أنني قرأتُ معظمها، وكلها تنمي الفكر والعقل، بل لا يمل القارئ أمثالي للشعر بالذات!
ولكن، مع عشقي اللامحدود لشعره ولرواياته ولبعض مقالاته، إلا أنني أعتبر كتابه حديث هذه "الدردشة" هو الأقرب لأمثالي! ورغم أن "حياة في الإدارة" ظاهره سيرة ذاتية عن كاتبه، إلا أنه وإن كان قد يكون كذلك، يعتبر أيضًا مجموعة كتب إن جاز التعبير، كونه يتحدث عن التربية والتاريخ والجغرافيا والدبلوماسية، وعن الشخصيات السياسية والتاريخية الخاصة والعامة، بجانب كونه كتابًا سياسيًا بأبهى معانيها، والتي سيجدها القارئ في كل صفحات الكتاب تقريبًا! وقبل هذا وذلك، هو كتاب عن "الإدارة"، بل إنه يُعلم القارئ له "فن الإدارة" بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
لذلك، يعتبر "حياة في الإدارة" كتابًا ممتعًا بحق، وما ذلك إلا لأنه جَمَع بين العِلم والظرافة، بين المزح والجد، بين التساهل والصرامة.. إن تحدث مؤلفه عن جَوَانِب الجِد، أسمع، وإن تحدث عن جوانب الظرافة، أمتَع! وإن ذكر فيه بعض ما قد يُبكي، أدمع، وإن ضَرَب بعض خصومه وهم في الكتاب كثُر، أوجع!
وإن جَدَّ في بعض ما فيه فَعِبْرة، وإن مزح في بعض سطوره فنزهة، كونه مليئًا عِلمًا وظرفًا بحق، فهو كما يقول بعض العرب: "إن أطيب الكلام مَا عُجِنَ عَنبرُ ألفاظه بِمِسك معانيه!".. وأحسب أن ذلك ينطبق على كتاب "حياة في الإدارة". ولا غرابة في ذلك، بخاصة وأن مؤلفه بجانب كونه سياسيًا ومثقفًا معروفًا، فهو قبل وبعد ذلك شاعِرٌ كبير، وبحكم معرفتي بِشعره المُتسم بالحِكَم والرصانة وببعض الغزل البريء جدًا! وحسن التعبير، فسيجد القارئ لكتابه هذا بعضًا من تأثير الشعر على النثر عند الطرح! إنه كتاب نعم الأنيس عند الوحدة، ونعم الصاحب للرئيس وللوزير والوكيل والمدير بوجه عام.

ثم، بعد ذلك كله، أعتبره شخصيًا بمثابة رفيق للقارئ بوجهٍ عام، وللإداري والمسؤول في أية جهة كانت بوجهٍ خاص، كونه يتحدث عن "فن الإدارة" بحق، والتي أوجزها بأن "السلطة والحزم وَجهان لعملة واحدة"، بجانب الاطلاع على بعض أهم ذكريات المؤلف المتنوعة من خلال الأداء الإداري ذاته، والتجارب المريرة والجميلة، المضحكة والمبكية، التي مرَّ بها أثناء مهامه الرسمية!
لذا، أنصح محب القراءة (وإن لم أكن بمواطن النصح) بقراءة هذا الكتاب، بخاصة صانع القرار، أكان زعيمًا أو وزيرًا أو مديرًا أو أي مسؤول إداري أيًا كانت درجته، وفي أية جهة كانت! فهو كتابٌ يُفيد القارئ أيًا كان، ولا يستفيد منه ويزيده ولا يستزيد منه.
وللتذكير ببعض نماذج إدارية من الكتاب، فقد تَعَرَّف المؤلف لِأول مرة على "البيروقراطية" وما تعنيه، حينما بدأ دراسته بكلية الحقوق بجامعة فؤاد -القاهرة حاليًا! (ص21-22). والغريب أنها لاتزال تهيمن على مختلف الجهات الرسمية الخدمية وَغيرها في مصر العزيزة حتى اليوم! وإن لم تكن الوحيدة مع الفارق!
كذلك أعطى المؤلف صورة موجزة عن أيام دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوليه رئاسة "جمعية الطلاب العرب"، بجانب دراسته في لندن، مع ذكر بعض الفوارق الأكاديمية، ثم -وهو الأهم- التعامل الإداري بهذا الجانب بين الولايات المتحدة وبريطانيا بوجهٍ عام.
ثم، عند عودته إلى وطنه وقبوله مدرسًا بكلية التجارة بجامعة الرياض -الملك سعود حاليًا، لم ينسَ ذكر بعض المواقف الظريفة، وبعض ردود الأفعال الغريبة وغير المصدقة ولا المتوقعة له! بخاصة عند حديثه على العلاقة بين المدرس والطالب وبين الأساتذة والأساتذة، مع ذكر الجوانب الإدارية بذلك كله (ص112-113).
ولأن هذه "الدردشة" تُنشر في صحيفة يمنية، ومعظم القراء لها يمنيون، فلا بأس بالتذكير برحلة الدكتور القصيبي -رحمه الله- إلى اليمن، كما جاء ذلك في نفس الكتاب موضوع هذه "الأحرف"، حيث سافر عام 1965م، بعد اتفاق الزعيم جمال عبدالناصر والملك فيصل، رحمهما الله، على وقف الحرب الأهلية في اليمن، وإن لم تتوقف يومها! حيث تم اختياره مستشارًا قانونيًا للوفد السعودي الذي ذهب برئاسة عبدالله السديري، لينقل للقارئ بعض ما شاهده في صنعاء، بأسلوب شيق ومَرِن وعاطفي بنفس الوقت إن صح التعبير. ولتكون رحلته هذه سببًا في اختيار بحثه في العلوم السياسية للدكتوراه من جامعة لندن، على اليمن، كما أكد ذلك! إذ تمحورت رسالته على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول يتناول السنوات الأخيرة من عهد الإمامة، والقسم الثاني يدرس بالتفصيل "ثورة 26 سبتمبر 1962م" التي أطاحت بالإمامة، بينما القسم الثالث والأخير، يتناول ردود الفعل المصري والسعودي بعد قيام الثورة.
أتذكر حينما ترشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكان التواصل عبر الإيميل وغيره بيننا مُستمرًا، طلبتُ منه نسخة من بحثه للدكتوراه، فأكد لي عدم وجود نسخ معه، وأنه يمكن طلبه من جامعة لندن، لكنه أرسل لي بتلخيص للبحث في حدود 25 صفحة، باللغة الإنكليزية (رحمه الله كم كان كبيرًا ومتواضعًا في مجمل حياته كلها). وقبل بضعة أشهر، حصلت على نسخة كاملة ومترجمة للبحث من الزميل العزيز الباحث الدكتور ثابت الأحمدي -رعاه الله- فعدتُ إلى قراءته كاملًا مع التركيز لما بين السطور! ورغم وجود بعض الانحياز، بخاصة في القسم الثالث والأخير، لِوِجهة نظر بلاده حول الثورة اليمنية (وقد يكون معه بعض الحق لذلك!)، مع ذلك قد لا أكون معه في تحليله لبعض أسباب التدخل المصري في اليمن، الذي رغم بعض سلبياته، إلا أنه لولاه بعد الله لما ثبت النظام الجمهوري، إلا أن البحث كان فيه الكثير من الحيادية والتمسك بِطُرُق وأساليب البحث العلمي عند كتابته له.
لقد بدأ حياته العملية مدرسًا بالجامعة، ليُنقل فجأة إلى وظيفة مدير عام للسكة الحديدية، شارحًا بعضًا من وظيفته الجديدة، وما قام به من مهام إدارية غير مسبوقة، وليعرف طريقة "الرشوة" لأول مرة! مع إعطاء القارئ بعض الفارق بين صلاحيته كعميد لكلية التجارة التي لا تكاد توجد، وبين صلاحيات المدير العام التي لا تكاد تنتهي حسب تعبيره (ص141)، وصولًا إلى تعيينه وزيرًا للصناعة والكهرباء في التشكيل الوزاري الذي تشكل عام 1975م، والذي وصفته صحيفة أجنبية بقولها: "إن مجلس الوزراء السعودي من أكثر مجالس الوزراء في العالم ثقافة ومن أصغرها سنًا"، لكثرة الدكاترة المعينين! وأن اسم الوزراء الجدد لدى الشارع السعودي كان "حكومة الدكاترة!" (ص143) (كان عمر القصيبي عندما أصبح وزيرًا 35 عامًا!).
وفي الصفحات 140-262 تحدث بإسهاب عن عمله في وزارة الصناعة والكهرباء، وما كان عليه وضع الكهرباء بالذات عند تسلمه لعمله، إضافة إلى ذكر ما حدث من تطور وازدهار في هذا الجانب، بخاصة إقامة مدن صناعية شِبه متكاملة مع بداية الطفرة التنموية لبلاده! وقيامه بإنشاء العديد من المؤسسات والشركات الصناعية مثل: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي جعل منها عملاقًا صناعيًا يمشي بثقة في العالم مع عمالقة الصناعة (ص234)، و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" وغيرهما.. ثم تحدث عن عمله في وزارة الصحة بالإنابة لمدة عام، ثم وزيرًا رسميًا لها لنصف عام فقط، وعن كيفية تعيينيه بهذه الوزارة التي أحدث فيها ثورة إدارية ظلت ولاتزال حديث الخاصة والعامة، مكتشفًا مواطن الخلل في وزارة الصحة يومها، والتي أوجزها بأمرين اثنين؛ أحدهما: "انعدام الانضباط" والآخر "أن المراكز القيادية في وزارة الصحة لم تتغير عبر أكثر من ربع قرن، رغم تغيير الوزراء المتكرر!" (ص264)، ذاكرًا أن اهتمام وسائل الإعلام به بسبب ما قام به من تطهير بالوزارة وما أحدث من جوانب "اتخذ شكلًا تجاوز الحدود المعقولة والمقبولة"، على حد تعبيره (ص294). مؤكدًا أن الشعبية التي نالها ولَّدت "الأُسطورة"! والحقد عليه من البعض... الخ (ص297).. ورغم تحقيقه لذلك النجاح، بخاصة قيامه بإصدار قرارات طالت بعض كبار موظفي الوزارة، أوجد له مجموعة من الأعداء، وتكرار حديثهم عنه ممن ذهبوا شاكين به إلى ولي العهد وإلى وزير الداخلية، بكونه متصفًا بـ"الطغيان" ومتجاوزًا لمهامه، رغم نفيه لذلك، وأن البعض أحيا بعض المآخذ عليه، عند محاولتهم "اغتيال الشخصية" حينما حاولوا استثارة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء على "الوزير" "الشيوعي" "الاشتراكي"، بخاصة حينما عثروا على مقابلة أجراها في مطلع عهده في وزارة الصناعة والكهرباء... الخ (ص242).. وكذلك ما حدث ضده من بعض رجال الشريعة أو المَشايخ بعد صدور ديوانه "معركة بلا راية" (ص83)، وأن ذلك تكرر ضد فيما بعد أثناء عمله وزيرًا للصحة مع بعض الفارق، وإن كان الهدف واحدًا! فتصور أن الملك فهد بدأ يقلق عليه من الأعداء الذين أخذوا يتزايدون يومًا بعد يوم أثناء عمله وزيرًا للصحة (ص301).
لتكون النتيجة إعفاءه من منصب "وزير الصحة" بعد سنة ونصف! مفضلًا عدم الحديث عن قصة ذلك الإعفاء، كونه "دراما إنسانية معقدة"، حسب تعبيره (ص309)، مكتفيًا بأن السبب إداري فقط، مع أن ذلك الإعفاء ظل حديث الخاص والعام، ومن خلال تفسيرات عديدة داخل وطنه وخارجه، وعنوان بارز لأبرز الصحف الغربية، وأن قيامه بنشر قصيدته "رسالة المُتنَبئ الأخيرة إلى سيف الدولة" هي بالدرجة الأُولى سبب الإعفاء، لأن ذلك اعتبره خروجًا صارخًا على قواعد اللعبة السياسية، والاجتماعية والإدارية في بلاده، مضيفًا أن هذه القواعد لا تُجيز نشر أي خلاف في العلن، فضلًا عن النشر في الصحف، فضلًا عن خلاف مع رئيس الدولة... الخ (ص309).
أتذكر أيام بداية دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، لفت نظري عنوان لخبر منشور في مكان بارز بصحيفة "نيويورك تايمز"، مضمونه: "قصيدة شعرية تفقد وزير الصحة السعودي منصبه". ورغم نشر الصحيفة بهذا الخبر بعض معانيها، إلا أنني لم أفهم مضمون العنوان حتى وجدت القصيدة بعد البحث والاستفسار منشورة في الصفحة الأخيرة من صحيفة "الجزيرة" السعودية، يوم 5 مارس عام 1984م، بعنوان "رسالة المُتنبئ الأخيرة.. إلى سيف الدولة" بـ25 بيتًا.. ومن يقرأ هذه القصيدة وما بين سطورها قد يتفهم سبب الإقالة.
ومن أبياتها مخاطبًا بها الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله:
"أزِف الفراق.. فهل أُودعُ صامتًا
أم أنت مصغٍ للعتاب فأعتِبُ
يا سيدي والظلم غير محبب
أما وقد أرضاك فهو محببُ
لا يستوي قلمٌ يُباع ويشترى
ويراعة بدم المَحَاجِر تكتبُ
أنا شاعر الدنيا تبطن ظهرها
شعري يشرِق عبرها ويغربُ"
إلى غير ذلك مما جاء في تلك القصيدة التي قد يفهم القارئ لها وجود من كان سبب الوقوف ضد رغبته باتخاذ إجراءات "إدارية" لم يُوافق الملك عليها، لكنه -رحمه الله- لم يُوضح ذلك، وإن كان ذلك قد يكون معروفًا للبعض! وما حدث بينه وبين الملك لا يعني خروجه عن حبه لقيادته وعن حبه وانتمائه لوطنه، فذلك معروف عنه في مجمل حياته العملية وفي مؤلفاته الشعرية والنثرية، بل إن نقله في كتابه موضوع هذه "الدردشة" بعض أوجه التوافق والتباين بمجلس الوزراء أيام توليه منصب وزير للقارئ، أو الخلافات بين الليبراليين والمحافظين يقصد الوزراء (ص205)، وحرصه على إطلاع قارئه على كيفية صنع القرار، بجانب كيفية الصرف من الميزانية العامة، وغير ذلك مما جاء في كتابه، وبكل مهامه الأكاديمية والرسمية والدبلوماسية... أقول إن نقل ذلك للقارئ، ولو بصورة غير مباشرة، إنما يُجسد انتماءه الوطني وحبه له قولًا وفعلًا!
إن كتاب "حياة في الإدارة"، مع ما فيه من مواقف خاصة وعامة قد توحي للقارئ أنه مجرد سيرة ذاتية للمؤلف كما قد ذكرتُ آنفًا، وقد يكون كذلك فعلًا، إلا أن جوهر الكتاب هو "الإدارة" ومدى تطبيقها على الواقع.
فلقد ظل يُوجِّه نصائحه للقارئ الإداري، بعد كل حدث يواجهه في حياته المهنية والعملية، وهي كثيرة، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، ودون ذكر أسباب كل نصيحة، كما سردها بكتابه:
أ. "على صانع القرار ألا يتخذ أي قرار إلا إذا اكتملت أمامه المعلومات" الخ (ص53).
ب. "إن على القائد الإداري، ألا يتردد في اتخاذ القرارات الضرورية حتى ولو كانت مؤلمة" (ص138).
ج. "لا يجوز لي مهما كانت عواطفي الإنسانية نحو زميل من الزملاء، أن أبقيه في موقعه إذا كان بقاؤه يعرض سلامة الآخرين للخطر".
د. "الإصلاح الإداري عملية متراكمة متواصلة، والإداري الناجح أيًا كان لا بد أن يجد عند تسلمه لعمله شيئًا من سلفه، وبالتالي أن يبقِي هو شيئًا لخلفه".
وهناك الكثير من النصائح الإدارية التي تستوجب على القارئ الراغب لمعرفتها قراءة الكتاب ذاته.
ثم، أوجز الصفات التي لا بد منها في الوزير أو المسؤول أيًا كانت درجته ومهامه، والمدير في أية جهة كانت، والتي هي "صِفة عقلية خالصة"، والثانية: "صفة نفسية خالصة"، والثالثة: "مزيج من العقل والنفس"، وشرح ذلك في الصفحات 147-149، بجانب طرحه لنماذج ذات صلة بهذه الصفحات، مَرَّ عليها هو نفسه، في الصفحات 150-151.
فالكتاب بكل إيجاز فيه الكثير من المواقف التي دفعت بالكاتب إلى التذكير بنصائح إدارية بحتة، والتي ذكرها المؤلف وبصورة سَلِسَة وسهلة، وهو ما قد يؤكد لنا مدى التوفيق في حُسن عنوان الكتاب بكونه "حياة في الإدارة" بِحق وحقيقة.
إن ما أقوله هنا، ليس ترويجًا للكتاب، فهو في غِنى عن ذلك تمامًا، بخاصة وأن مُؤلفه كان أيام حياته -رحمه الله- كلما نزل له مؤلف أيًا كان أو مقالة صحفية أو إلقاء محاضرة أو حتى لقاء صحفي أو تلفزيوني معه، فإن ذلك من شأنه إيقاظ الركود الثقافي والفكري داخل وطنه وخارجه، ولتظهر تِباعًا لذلك الأقلام المعارضة والمؤيدة، وهو ما حدث عند ظهور الكتاب موضوع هذه الأحرف، الغني عن الترويج، والذي حاولتُ جاهدًا أنقل لقارئ هذه "الدردشة" أهم ما جاء فيه، مع أن كل ما فيه مهم!
أخيرًا، أود التذكير بأن القارئ لـ"حياة في الإدارة" سيجد صورة عظيمة من صور الحياة الزوجية السعيدة والعِشرة الاستثنائية والتفاهم غير المسبوق بين الزوج والزوجة. وهو ما تكرر بغير صفحة من الكتاب، متطلعًا أن يكون الزوج القارئ أو الزوجة القارئة للكتاب كذلك.
ثم أما بعد، للمرة الثانية، أكتب في مجالات شبه بعيدة عن "السياسة"، بخاصة ما يخص وطننا اليمني الذي أصبحت بعض الدول "تَتَداعى عليه كما تَتَداعى الأكلةُ إلى قصعتها"! والذي بات موصوفًا بـ"الرجل المريض"، مع أن العلاج قد يكون موجودًا لدى من كان السبب الأول في حدوث ذلك المرض! وهو قادر على شفائه بعد توفيق الله إذا رغب بذلك!
والكتابة عن ذلك، أو عما له صلة بالمرض، قد تؤدي إلى زيادة المرض وليس العكس! وقد يعم الضرر ولا يخص! حتى كتابة نقد الأوضاع المحلية لم تَعُد تجدي هي الأُخرى! بخاصة مع استمرار المعاناة وحجم الاهتراء الذي أصاب النسيج الاجتماعي والسياسي ولايزال! واستمرار بعض "الكتبة" بنشر كل ما يوسع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
ثم، كيف يمكن لكاتب مهما بلغ من النبوغ وصف مئات القتلى والجرحى وحرب الإبادة المُستمرة بغزة منذ أكثر من 21 شهرًا؟ وإلى درجة خلط الدماء بِكِسرة خبز أو بِشَربَةِ ماء..؟! يحدث هذا على مدار الساعة أمام مرأى ومسمع ومشهد العرب والعجم وبدعم أمريكي جلي..! في الوقت الذي يستمر الوسطاء بتوزيع المهدئات والمسكنات الوقتية وحب الظهور! أو الهروب إلى التنبؤ بقيام الدولة الفلسطينية التي إن قامت قد لا تجد شعبًا بعد أن يكون "نتنياهو" قد ارتوى دماءً وشبع أجسادًا؟! إضافة إلى الفشل والتشرذم العربي واستمرار الحروب والمجاعة في غير دولة عربية بِفعل أمريكي وغربي وفارسي وعَرَبي على السواء حيث الرماح باتت تنال من الجسد العربي من كل جهة.. ولسان الحال يردد قول القائل:
"يهز عليَّ الرمح (ترامب) مُهَفْهَفٌ
لَعُوبٌ بألعاب البَرية عَابِثُ
فلو كان رُمحًا واحدًا لاتقيتُه
ولكنه رُمحٌ وثانٍ وثالثُ"
مع الاعتذار من القاضي أبو بكر العربي، قائل هذين البيتين، حيث غيرتُ كلمة "ظبي" بـ"ترامب"!
ولكن رغم كل ما سبق ذكره، فإن من يحمل بريد القلب وطبيب المنطق وسفير العقل -أعني القلم- أمثالي، لا يجب عليه السكوت على الباطل، أيًا كان.
ولذا، فإن التوقف على الكتابة في الجوانب السياسية وما في حكمها، قد يكون توقفًا مُؤقتًا! بخاصة ما يخص الوطن.. ولأن التعبير عن الوضع القائم فيه عبر القلم الذي لا يملك أمثالي غيره، قد يُعد "أضعف الإيمان" أيًا كانت نتيجة ذلك.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.




