حَلَزونات نقدية
*حسين حسن السقاف
في مساءٍ جميل جمع بين ألق المكان وروعة الزمان والأوان، رتّب مشكوراً اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بحضرموت أمسية لأتحدث فيها عن باكورة أعمالي الروائية. كانت هذه الفعالية باستضافة رئيس دار الكتاب الذي أقام معرضاً للكتاب في مدينة المكلا الجميلة، حُدِّدَت الساحة الشرقية لقصر السلطان القعيطي الأثري، موقعاًً لعقد أمسيتنا التي كانت في الهواء الطلق، حيث كان القمر -بكامل نضوجه وحسنه وبهائه- يطل علينا بين الفينة والأخرى من وشاحه الخفيف، ويبدو حيناً ومن حوله وصيفاته. في حين تهب علينا نسمات البحر الندية واللطيفة من جهة الجنوب، وتتراءى لنا من الجهة المناظرة قمة الجبل وعليها القلاع المتوهجة بضوئها. رُصَّت في الصف الأول الكراسي البيضاء لتبدو كأسنان لبنية جميلة، افترشت هذه المقاعد أديماً أخضر نبت من تلك الأمطار الربيعية الكثيفة التي أنبتت السهول والآكام.
حضرنا قبل الموعد بربع ساعة تعرفت خلالها على بعض الكتاب والنقاد الذين أهديت أحدهم روايتي الثانية.. كان حديث غالبية الحاضرين -عن روايتي الأولى- إيجابياً، مما شجعني على التحدث في هذه الأمسية. غير أنني لم أطل في حديثي لهم، قلت لهم بأنني قد أتيت مستفيداً ولم آتِ مفيداً... وكان حسبي في ذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع من كان موجوداً قد قرأ روايتي.
فُتح البابُ لمداخلات وملاحظات الأدباء والنقاد والمثقفين ليقولوا كلمتهم في روايتي، كان حديثهم مهذباً يليق بمجلس يحوي هذه النخبة من المتأدبين. لقد استفدت من ملاحظاتهم وسررت بتحليهم بهذه الروح العالية. غير أنه قام أحدهم وهو الذي أعطيته روايتي الثانية التي ما زال ممسكا بها، بدا هذا طويل القامة واليدين اللتين كان يلوح بهما يمنة ويسرة في شيء من الانفعال النسبي، حتى بدت هاتان اليدان كمجدافي قارب فزع إلى الساحل من عاصفة ممطرة. وبدتا حيناً آخر كتوأم ماسح زجاج السيارة، وكان لم يزل ممسكاً بروايتي التي أهديته. حتى ظننت أنه سيقذفني بها، وكان قد تهيأ واستل مسطرته ومقاييسه ليقيس أو ليحدد ملاءمة روايتي بعدته النقدية التي تحمل نظريات ومذاهب نقدية غربية وشرقية، كان يرشقني بوابل من نظرياته، ويكثر من تلك الأسماء السلافية والبلغارية والفرنسية التي تأتي على وزن كلاشنكوف ووسكي وغيرها من الأسماء التي أجد نفسي بخيلاً عليها بصرف (كيلو بايت) واحد من ذاكرتي لمعرفتها. كان الناقد يتحذلق في لفظها، وكانت كثيراً ما تخرج من فيه هذه الأسماء حتى خلتُ أن فمه في حالة إنزال مظلي لجنود يحملون تلك الأسماء.
بعد أن فرغ من نقده -الذي لا يخلو من ملاحظات إيجابية سبقه بها من قام قبله- عزم على الجلوس على مقعده، غير أنه عاد ثانية ليقف كمن استذكر شيئاً، عاد لينتقد روايتي الثانية التي أهديتها له قبل دقائق.. لعله كان يتقالها حتى وصفها بأنها ليست رواية، وذكر أن لها اسماً إسبانياً آخر -لا يحضرني-.
قال لي أكثر من واحد ممن حضروا: لقد أتحفتنا بصبرك وتحملك ذلك الناقد أكثر مما أتحفتنا بروايتك وأُمسيتك. كيف لا؟ عليَّ أن ألتَمس له سبعين عذراً: لعله ممن ينتقد لغرض النقد، أو لعله لا يعرف إلا تلك الحلزونات النقدية ليُطبِّق المثل القائل "فتَّح وشاف الديكـ". ولعل تلك النظريات تُمثِّل نظَّارته التي ينظر من خلالها إلى كل ما يقرأ، أم لعله لم يقرأ من الروايات ما يكفي لصقل وتهذيب ذائقته الأدبية والنقدية، إن ثمة ذائقة سمحت بها نظَّارته، كان ينتقد صغر حجمها وقلة ورقها وخماصةِ بطنها وكأنه في سوق المواشي، رغم أن روايتي موضوع نقده الخارجة عن موضوع الأمسية -بحسب ميزانه- أسمن من كثير من الروايات التي أسوق هنا فقط ما قرأته منها في مقتبل شبابي. بل إن بعضها لكُتاب (نوبليين) مثل رواية "عرس الزين" للطيب صالح، ورواية "ثلوج كلمنجارو" للأمريكي أرنست همنغواي، ورواية "وداعاً مستر تشيبس" للإنجليزي جيمس هيلتون، والتي ترجمت إلى 27 للغة، وصُوِّرت سينمائياً، وكذا رواية "قطار في الجليد" لليوغسلافي ماتو لوفاك، ورواية "عودة الورد الإسباني" لفرنر برجن جرون... وغيرها من الروايات التي لم يطَّلع هذا الناقد على شيء منها.
أقول كل ذلك ليس دفاعا عن روايتي التي وصفها الدكتور عبدالعزيز المقالح بما لم يصف به رواية أخرى على الإطلاق، لا أحسب النجاح في ذلك لي بل لمن أسترشد بملاحظاتهم أيضاً، وما يؤكد نجاح الرواية هو نفاد الطبعة الأولى من المكتبات في شهرها الأول، مما أحرجني أمام الأصدقاء الذين لم أستطع أن أوفر لهم نسخا منها، الأمر الذي دفعني إلى طباعتها بكميات كبيرة. لقد سمعتُ عنها كلاماً كثيرا يناقض ما قاله ذلك الناقد، لقد سمعت ما قرَّت به عيني من هؤلاء الذين أعرف بعضهم ولا أعرف أكثرهم.
كثيراً ما يُسمعُني شابٌ بأنه قد قرأت روايتي من الغلاف إلى الغلاف في جلسة واحدة، وأسمع ذلك من البقال والمقوِّت والإسكافي والطالب، ليقولوا لي بأنهم باتوا ليلةً ما مسهَّدين بسبب روايتي التي يتهمونها بسرقة نومهم.. وما زال بريدي الالكتروني يعج بتلك الرسائل التي تُثني عليها.
تعرفت صدفة على أحد الأساتذة الجامعيين، وفرح بي كثيراً، وقال: إننا في تعز نتداول روايتك حتى إنها فقدت جناحيها لتصير متنا بلا حواش.. تصور لقد بلغ الأمر ببعض الشباب أن قاموا بإعادة طباعتها ليقسِّموها إلى حلقات في أحد المنتديات الفلسطينية.
انشغل الناسُ في العاصمة صنعاء بالحديث عن تلك العملية الإرهابية التي استهدفت أحد الدبلوماسيين صباح ذلك اليوم الذي -عند حلول مسائه- استقللتُ سيارة للأجرة في شارع القيادة في هذه المدينة الجميلة، وعلى خلفية هذه الحادثة كان السائق يحدثني بأن والده في حجَّة أخبره بأنه قرأ قصة جرت لأحد أطفال حجَّة، وطفق يسرد أحداث روايتي "قصة إرهابي".
إزاء كل ما تقدم، فإنه يحضرني الجدل القديم الحديث في الآن نفسه، ألا وهو: هل الفن من أجل ذاته أم أنه من أجل الناس؟ وتجدني متشبثاً في ذلك بأن جميع أجناس الأدب وفنونه قد صنفت ضمن العلوم الإنسانية، وإن لم تكن هذه الآداب من أجل الناس، فعلينا أن نصنفها تصنيفاً مغايراً. نصنفها مثلا بالعلوم النقدية.
إذا كان لكل مهنة آدابها وأخلاقياتها التي يجب أن يتَّبعها ويتخلق بها منتسبوها، فإن الناقد هو الأولى باحترام مهنته، ولعل إهدائي الرواية لهذا الناقد يذكرني بما أورده جدي ابن عُبيدالله في كتابه "إدام القوت"، وهو أن أحد شيوخ القبائل الحضرمية في قرية "جِفلـ" قد منحه السلطان مهرة عربية جميلة، فعندما انشق هذا القبيلي وقرر محاربة السلطان، أول ما صنعه هو إعادة المهرة إلى السلطان، حتى لا يحاربه بمهرته. قارن ابن عبيدالله ذلك القبيلي بالشريف حسين حينما أكرمته الدولة العثمانية ليرد جميلها بتسليم النساء التركيات -المسلمات اللاتي فزِعنَ إلى التشبث بستائر الكعبة ليقدمهن الشريف سبايا للإنجليز... كان أولى بذلك الناقد أن ينتقد الرواية موضوع الجلسة، لا أن يتجاوزها إلى الرواية التي أهديته، ليكون في ذلك مثل القبيلي صاحب قرية جفل.
للأدب جمالياته الفائقة الألق والعدد التي يستنبطها أولو الذائقة الجمالية، وهي أوسع من أن تُختزل في قوالب أو (فورمات) حلزونية صنعها أو قالها فلانٌ من الناس، وهو -أي الأدب- نتاج تراثي تراكمي تصنعه الأجيال المتعاقبة، ولا يمكن عزل ماضيه عن حاضره، ولا يمكن لهذه النظريات الضيقة الأفق أن تحتويه. بل على الناقد أن يسعى إلى تطويره لا وأده.. والرواية من أرقى الأجناس الأدبية قاطبة لتصبح اليوم ديوان الشعوب في كل مكان، بل وأصبحت ديوان العرب، حتى إن المفكر دافيد هربرت لورنس كان يقول مقولته الشهيرة "إني أعتبر نفسي، لكوني روائياً، أرفع شأناً من القديس، والمعلم، والفيلسوف، والشاعر. فالرواية هي كتاب الحياة الوحيد الوضاء...". لعل الناقد المسكين استبدل نونه بحاءٍ ليرى أن حضرموت أو الساحة اليمنية لا يتسع مشهدها الروائي لروائي جديد، لذلك فإنه لا يسعني إلا نصحه بالخروج من قوقعته ليعيش في فضاءات أكثر رحابة، وليعيش بقلب ينبض بدماء دافئة لا دماء باردة تضطره المبايت الشتوية.
هناك الكثير من النظريات التي سادت ليس لجدارتها بل لملاءمتها (لأيديولوجيات) ومصالح استعمارية، ثم بادت هذه النظريات لكونها جسماً غريباً مفروضاً على الواقع، ولعلي أذكر نظرية النشوء والارتقاء لتشارلز دارون، التي بنيت عليها العديد من النظريات في نواحٍ مختلفة من الحياة. ولعل نظرية الاشتراكية العلمية ليست ببعيدة عن ذلك.. وبهذا الصدد فإن الناقد الأمريكي ستيفن مورفي ألَّف مؤخراً كتابا موسوعياً عظيم الحجم كان نتاجاً لأكثر من عقد من الزمن قضاه في الجمع والتحليل للروايات التي أحضرها من أفجاج عميقة من العالم، وقف في كتابه بشكل عملي على التاريخ الحقيقي للرواية، ليقلب به المفاهيم عن تاريخ الرواية، وليصنع بذلك ثورة عظيمة في عالم النقد، بيَّن فيه (ستيفن) للنقاد أن الروايات الرائدة ليست كما ضلله مدرسوه في الجامعة بأنها الرواية الإسبانية "دون كيشوت" لميجيل سرفانتس في القرن ال17، ولا الرواية الإنجليزية "روبنسون كروزو" لدانيال ديفو، وأن الروايات الأقدم تعود إلى ما قبل ذلك بكثير، وذكر أن من الروايات الأوائل رواية "سنوحي" المصرية و"ألف ليلة وليلة" و"حي بن يقظان" لابن الطفيل، فما كان من النقاد إلا أن أجمعوا على أن عمله كان تطبيقيا وموسوعياً.
لا يسعني إلاَّ القول: "أصلحني وأصلحه الله"، فقد كان كلانا متطرفاً، كان متطرفاً في حمله على روايتي دون مبرر، وكنتُ أنا وما زلت متطرفاً في حبي للكتابة ولشخوص رواياتي وقصصي رغم عدم مبارحة سياط الكتابة جسدي، هذه السياط التي أستعذب عذاباتها المبرحة. لقد وصل بي الأمر إلى أن يهجرني النوم غيرةً منها.. ماذا أصنع لقد تملكني حُبها.. لا أخفيك أنني أتوق إلى شخوص روياتي كما أتوق إلى أفراد أسرتي.. لذلك تجدني أعود إلى البيت باكراً.. وإذا ما أطفئت الكهرباء في حينا ألتمس النورَ في حيٍّ آخر، ليس هرباً من الحر والظلام، ولكن لمواصلة السمر -الهزيعي- مع رفاقي الذين يعيشون بين أسطر قصصي ورواياتي.. إنها شهوة الكتابة.. إنها جنون الكتابة وسطوتها.. وقديما قيل: ومن الحب ما قتل.




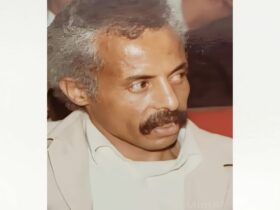

على شبكات التواصل