شهقة الأنفاس الأخيرة
* منصور هائل
أصبح اجتماع وتكالب الخصوم من مختلف المشارب والمضارب والاتجاهات والجبهات على استهداف رأس النظام يستحضر صورة الصومال بإلحاح وقوة، وكما كانت عليه في أواخر أيام حكم الدكتاتور محمد سياد بري الذي كان يرمق مخازن السلاح بغبطة الخبير المستغور والسابر للدخائل الخفية، والمحركات السحرية لسيكولوجيا الجموع التي احتشدت وتخندقت بقصد خلعه من القصر الجمهوري بمقديشو، ولكنها لم تصل إليه فقد كان الدكتاتور العتيد صاحب الضربة الاستباقية التي أضاعت على الثائرين طريق الوصول إلى القصر الرئاسي عندما فتح أبواب مخازن السلاح عشية اعتزامه مغادرة القصر الجمهوري في ليل 26 يناير 1991 كأي حاطب ليل. وتبين أن خبرته الوحيدة قد انحصرت في انشحاذ حدسه وتقديراته لاتجاه حركة ذبذبة الحشود الهائجة، والرؤوس الحامية التي كانت تندفع إلى القصر الجمهوري وترجع من محيطه إلى مخازن الأسلحة المفتوحة التي تكدست فيها ترسانة ضخمة تكفي لتدمير الصومال ألف مرة. ذلك لأن خصوم وأعداء الدكتاتور كانوا لا يتوفرون على السيناريوهات البديلة لعهده الذي شارف على الأفول، وكان يلفظ آخر أنفاس خريفه، ولم يخطر على بال أحد أن مكر التاريخ سيقول كلمته، وأن الدكتاتور سيدير الساحة وهو بعيد عن القصر الرئاسي والصومال، وسيحتفظ بدوره وإدارته من موقع الخبير بهندسة الحروب الأهلية المؤجلة والمحتملة والقادمة. وكان محمد سياد بري هو الشخص الوحيد الذي تمكن من اختطاف مفتاح المستقبل الذي لا يعقل لبلاده، وتمكن من رسم خريطة طريق الصومال في قابل الأيام والأعوام التالية لرحيله وحتى يوم الناس هذا. وبرهن على أنه داهية في الدمار حتى وهو بعيد عن كرسي النار، وداهية في مراكمة عوامل وشروط حفلات الانتحار الجماعي في الصومال، وفي تجزئته إلى شمال وجنوب وشرق وغرب، لأن الوحدة التي قامت مطلع ستينيات القرن الماضي، على أجنحة المشاعر والانفعالات الفوارة، والنوازع الفورية والإرادية، كانت كفيلة بأن تفضي إلى تهميش وإقصاء الشمال من قبل فئة قليلة بل جزء من قبيلة ثم عائلة عاثت فساداً في الصومال وهمشته وأفضت به إلى ما نرى اليوم من خراب عظيم. وكأن إيقاع الرواية الصومالية وحبكاتها ينسبك ويتكرر فوتوغرافياً وحرفياً وميدانياً في اليمن، حيث تستعاد وتحيى طقوس فلكلور حروب العصبيات الأولى بكامل مفرداتها من أزياء ورقصات وخناجر وسيوف وبنادق وذخائر ومباخر، وتسري قعقعة السلاح في الأرجاء، وتتواتر أخبار توزيعه من قبل المراجع العليا على جحافل القبائل وعلى الكثير من الواجهات والجبهات، ويعلن الفضلي عن اعتزامه توزيع السلاح لأتباعه وأشياعه، وتنبري قيادات القاعدة للتلويح بقنابلها ومتفجراتها، وتتطاير دعوات «الكفاح المسلح» من هنا وهناك ومن جهات لا حصر لها، ويغتنم الحوثيون كميات هائلة من الأسلحة من معسكرات الجيش اليمني ومن الجيش السعودي الذي دخل المعركة وهو مدجج بآخر التقنيات، وشكل مدداً إضافياً للحوثيين بأسلحة لم يكونوا يحلمون بها، ومن أسواق الأسلحة العامرة بمختلف أنواع السلاح الذي ازدهرت تجارته بالتلازم مع استعار الحرب، وانفجار الجديد والمزيد من بؤرها. ويحدث كل هذا تحت سمع وبصر دول الجوار والمجتمع الدولي. والمؤسف أن تدخل الخارج جاء ليصب في مجرى إحراق السهل كله، ومن هذه الزاوية فحسب يمكن النظر إلى مغامرة التدخل العسكري السعودي والتورط في مواجهة الحوثيين، ومقامرة التدخل الأمريكي في المشاركة والتوجيه للضربات التي استهدفت ما يزعم أنه «القاعدة»، وأخطأت الحساب في المعجلة بأبين، وأثارت هياج قبائل باكازم وغيرها من قبائل شبوة وأبين وردفان والضالع ولحج، وأخطأت التصويب في شبوة لتستنفر هياج قبائل العوالق، وتمثل خطأها الفادح بل خطيئتها الكارثية في التوقيت الحقير لغاراتها التي استعجلت عقد ضفيرة ما يشبه «العصبية الجنوبية» الجامعة، وفي تشديد الضغوط على نظام صنعاء الهش لكي يخوض حرباً على تنظيم القاعدة، وكانت بذلك كمن يطلب المستحيل من نظام لا يستطيع القفز فوق ظله، وغير مؤهل حتى للانتحار الأنيق أو الانفجار الرشيد في داخله وبما فيه وعلى من فيه. وكثيرة هي المقاربات الصحفية والسياسية التي تحذر من تبعات وعقابيل ما يحدث اليوم في اليمن، وتتقاطع معظم الآراء الإقليمية والدولية عند نقطة أهمية التدخل الإقليمي والدولي لتدارك اليمن من الهلاك في قعر الانهيار. والأعجب أن مثل هذه المناشدات تصدر عن بعض الفاعلين في المنطقة، وكأن المقصود منها كائنات فضائية أخرى غيرهم، ما يشير إلى أن فريق الإسعاف الخارجي لن يصل إلا بعد أن يموت المريض، رغم أن «الجميع» يدرك ويدري أن الأمور بين الفرقاء الداخليين قد وصلت إلى انسداد محكم، وليس ثمة بارقة تلوح في الأفق لاختراق الجدار السميك لهذا الانسداد الناتج عن فشل وانعدام أهلية ومؤهلات إدارة الحوار الناجح لدى فرقاء طالما أدمنوا تسول الحلول والوساطات من الخارج كأشقياء قصّر اعتادوا وأدمنوا تسول المساعدات والإعانات الخارجية على مر الزمن ومن عهد سيف بن ذي يزن الذي استنجد بالفرس من أجل طرد الأحباش، ليستقر في الذاكرة اليمانية الجمعية كأيقونة وبطل وطني لمجرد أنه استبدل استعماراً بآخر.




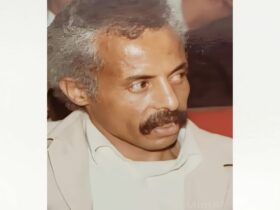

على شبكات التواصل