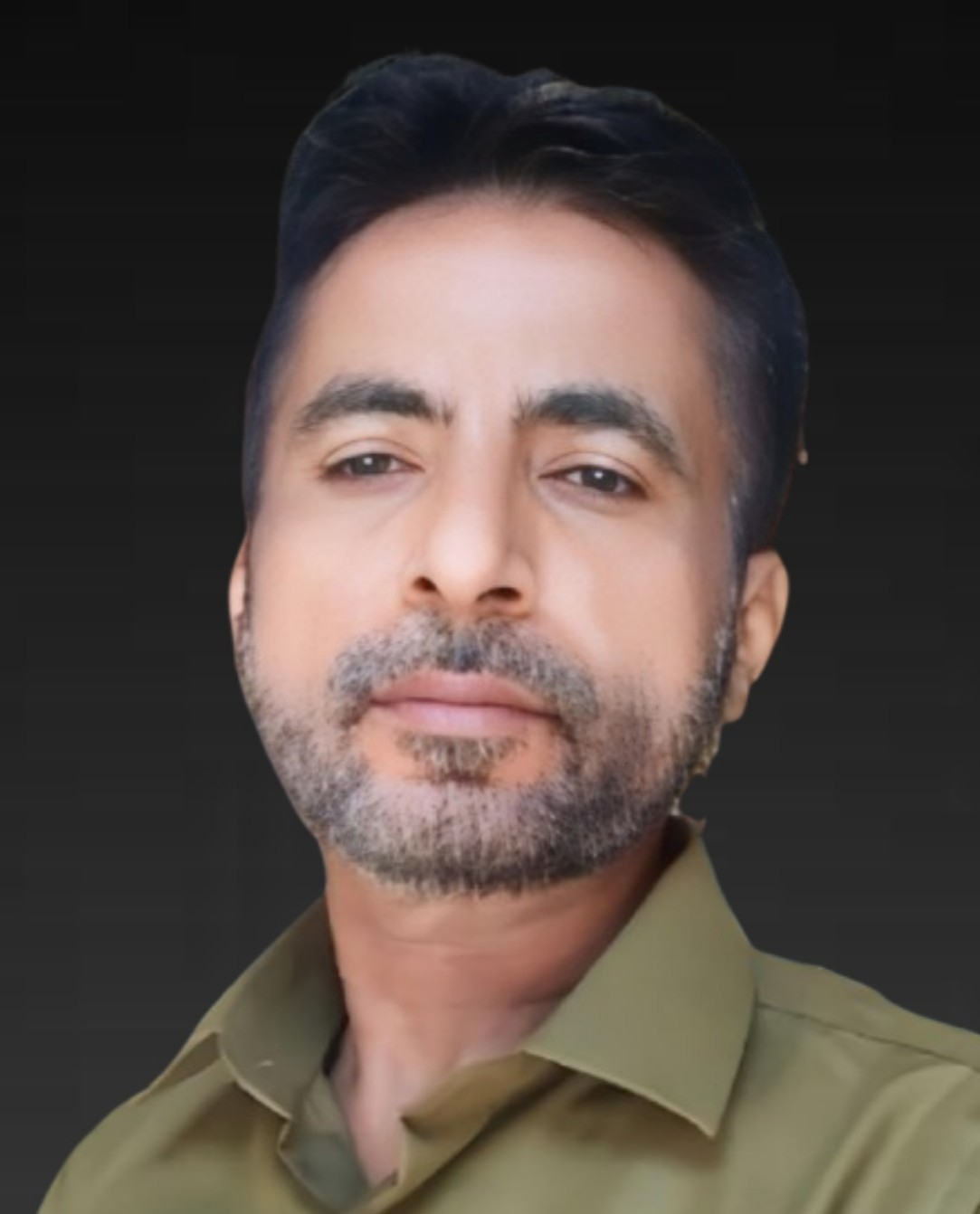الزيدية.. نصٌّ ثوري بدم سلطوي
ليست الزيدية مذهباً بالمعنى الفقهي فقط، بل مشروع طويل من سوء الفهم الجميل. جماعة أرادت أن تُصلح بيت الإسلام من الداخل، فإذا بها تبني بيتاً موازياً. مذهب يبدأ بالإمام زيد بن علي، الرجل الذي خرج على هشام بن عبد الملك طلباً للعدالة، فانتهى مؤسساً لتاريخ جديد في التمرد الديني المزخرف بالورع.
لكن الزيدية، وهي تُنسب لثائر، لم تبقَ ثائرة. تحوّلت عبر القرون إلى سلطة تتكئ على نسبها، إلى الفكرة الأولى دون أن تشبهها. صارت الثورة عند بعض فروعها تراثاً يُتلى في الخطب لا فعلاً يُمارس في الشوارع. وهكذا تحوّل المذهب الذي بدأ بالسيف إلى مدرسة في التبرير، ومنهج في إنتاج إمام عادل يبرر ظلمه بالمستقبل الموعود.
ليست كلها كذلك، ففي تراثها بقايا من عقل ثائر وضمير يبحث عن الإنصاف، لكن السياسة ـ كعادتها ـ كانت أسرع من الفقه وأقوى من الورع.
نعم، الزيدية أقرب المذاهب الشيعية إلى السنة، لكنها أبعدها عنهما في الوقت نفسه. هم يعترفون بخلفاء الإسلام الراشدين، لكنهم يصرّون على أن الحق كان في بيت علي. ويؤمنون بالإمامة، لكنها ليست وراثة مغلقة بل اجتهاد مسلح، أي أن كل من حمل السيف ضد الظلم صار مرشحاً لدخول السماء من بوابة السياسة. فكرة نبيلة على الورق، لكنها في التاريخ أنجبت من ظن أن الله قد فوضه بإقامة العدل بالسيف حتى لو كان هو الظلم نفسه.
يقدّسون الإمام العارف المجاهد كفكرة، لكنهم حين يجدونه فعلاً يختلفون عليه حتى يتبخر. يطلبون من الإمام أن يخرج، فإذا خرج سألوا إن كان مؤهلاً للخروج. يريدونه شجاعاً، فإذا حمل السيف سألوه عن فقه الجهاد. يريدونه من نسل فاطمة، فإذا جاء فاطميًّا حاكموه بنسبه. كأنهم أرادوا ثورة مؤجلة إلى إشعار آخر.
في الفكر الزيدي النصوص ليست مشكلة بقدر ما هو التفسير، فهم لا يغرقون في الغيب كالإثني عشرية ولا يجفّفون الروح كالسنة، بل يقفون في المنتصف المريح. متدينون بعقل سياسي وعقلانيون بتقوى مذهبية. ولهذا بقي مذهبهم مثل حلٍّ وسط بين الغلو والتقشف، بين الإمام الإلهي والخليفة الإداري. غير أن هذا التوازن الجميل سرعان ما انقلب إلى ارتباك مزمن كلما تحولت الفكرة إلى دولة.
وحين تحولت صعدة إلى محراب سياسي، أعادت بعض التيارات الزيدية إنتاج نفسها كنسخة مشوشة من الماضي. صار الإمام العادل شعاراً لمشروع عائلي، وصار الخروج على الظلم مبرراً لاحتكار السلطة. كل معركة تُلبس عباءة الطهر، وكل خصم يُنزع عنه وصف الإيمان. وكأن الثورة الزيدية القديمة لم تكن ضد ظلم الحاكم، بل ضد فكرة أن يكون الحاكم من سواهم.
الزيدية اليوم تبدو كمرآة تنكسر كلما حاولت رؤية وجهها. هي مذهب فقهي وسياسي وتاريخي وثوري، لكنها في لحظة الحقيقة تتحول إلى خليط مربك من حنين الإمامة ومراهقة الثورة وعصبية السلالة. يتحدث بعض أتباعها باسم علي، لكنهم يكررون أخطاء معاوية. يرفعون راية العدالة وهم يضربون بها رؤوس خصومهم، ويستدعون التاريخ ليغطوا به عورة الحاضر.
في مدارسهم يُدرّس الإمام زيد كبطل خرج ضد الظلم، بينما في واقعهم السياسي كل خروج يُعدّ خيانة. في كتبهم الحرية أصل، وفي واقعهم الطاعة عبادة. وبين الحبر والسيف تسكن الزيدية الحديثة، نصٌّ ثوري مبلل بدم سلطوي.
من يقرأهم بإنصاف يكتشف أن الزيدية كانت يوماً بذرة جميلة حاولت أن تزرع العدالة في تربة الاستبداد. لكن حين نمت التفّت على نفسها حتى خنقت أغصانها. صارت الثورة التي تكره الثورات، والفكرة التي تخاف من أفكارها، والعقيدة التي تحب الجدل أكثر مما تحب الحقيقة.
الزيدية هي التجربة التي حاولت الجمع بين السيف والعدل، فانتهت تُمسك مقبض السيف وتنسى العدل. مذهب أراد أن يكون ثورة ضد التسلّط فإذا ببعضه يصبح دليلاً عليه.
ربما كانت الزيدية أجمل فكرة ثورية فقدت البوصلة حين استبدلت "الحق في الخروج" بـ"الحق في الحكم"، وجعلت من التاريخ ديكوراً طويلاً لعرش قصير. إنها واحدة من تلك المفارقات التي أحبها التاريخ لجماعة بدأت بالتمرد على الإمام الظالم وانتهت بإعادة اختراعه.