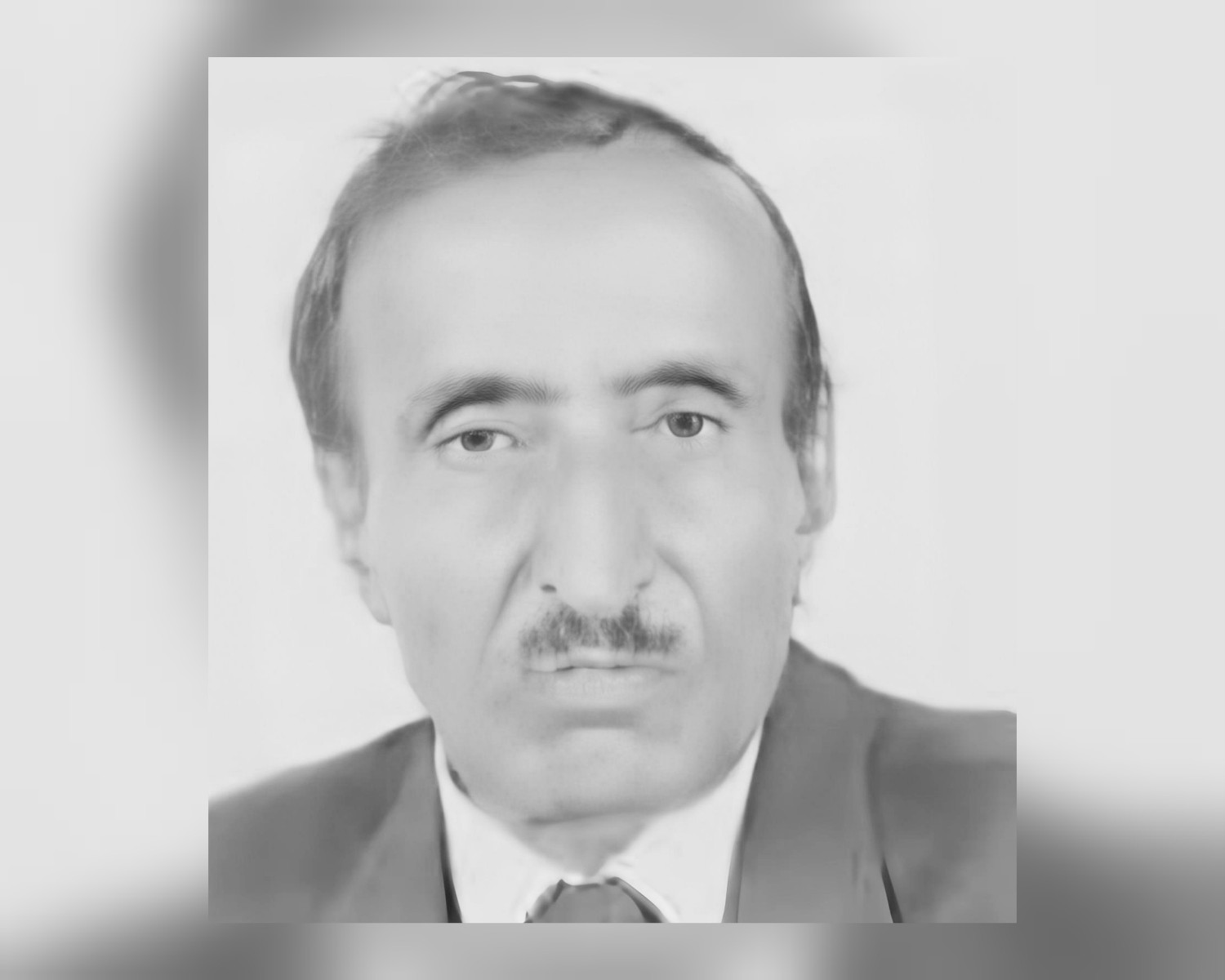في ذكرى رحيله العاشرة
عبد الكافي الرحبي.. فضاء التعدد المشمس

ما تُبينه تجربة الكتابة عند عبد الكافي الرحبي (1957 ـ 12 أكتوبر 2015) لمتفحصها أن ثمة مثقفًا متنوعًا، تُظهِر مهاراته جملة الاشتغالات النقدية والبحثية والدرسية التي قام بها على مدى ثلاثة عقود، ملامسًا ـ وبوعي مختلف ـ العديد من القضايا والموضوعات الفكرية والتاريخية والأدبية، الحاضرة كمكونات في البنية الثقافية للمجتمع، والمؤثرات العميقة فيها، التي أحدثتها عملية التثاقف القرائي، الذي خاضته النخب الثقافية والتنويريون اليمنيون على مدى الستين عامًا الماضية، والتي قارب إسهاماتها تلك من أكثر الزوايا جدة وعقلانية.
التكوين المعرفي الصلب على يد نخبة من علماء الاجتماع والفلسفة الكبار في جامعة صنعاء، وكذا المحيط الثقافي الذي انغمس فيه، إلى جانب خياراته السياسية وانحيازه لليسار منذ منتصف السبعينيات، أسهمت جميعها في تكوين الشخصية الرائدة للباحث المجتهد وكتاباته، التي كانت تجد في مساقات التنوير والعقلانية سهمها الواضح، لتفضي في النهاية إلى هذا التطييف الكتابي، الذي أبانَه كتابه الأول "أعمدة الشمس" (2003)، الذي شكّل بمستوعباته النصية المتعددة مفتاحًا مهمًا لخارطة انصرافات الكاتب المتنوعة تلك، وعزّزها باقتدار عالٍ كتابه الثاني "فضاء الخطاب النقدي"، والذي صدر بعد وفاته بقليل (ديسمبر 2015).
(1)
الكلي الثقافي، بمفرداته الأدبية حينًا، ومشغلاته الاجتماعية والتاريخية والسياسية حينًا آخر، كان العنوان الأبرز للتجربة الكتابية في كتاب "أعمدة الشمس"، الذي توزعت مادته على المقالة الفكرية والمادة البحثية والنص النقدي والتحليل الثقافي للمادة التراثية، والنص التثاقفي في الموضوعات السيارة والمستوطنة أيضًا.
"الثقافة الواحدية" كمادة مفتتحة للكتاب، هي المقالة الأوضح في تتبعها لمآلات فرض الواحد والمتشابه، بالقوة أو التعصب الفكري، وإلغاء الآخر، وأثرها السلبي في تطور المجتمع، ووجدت في السياقين السياسي والثقافي لمرحلة ما بعد تبدلات نظام الحكم في الستينيات أنموذجها الحي. فحين لم تتح طبقة الحكم المتعاقبة، تارة باسم الثورة، وأخرى من باب التحصين، للتنوع والتعدد أن يأخذا مداهما ويعبّرا عن حضورهما الفكري والسياسي الطبيعي، أنتج المجتمع دكتاتورية الغلبة والاستئثار، وتماهى معها إلى درجة الرضوخ الفج، والقبول بقواعد صناعة الحاكم الفرد والفئة المستأثرة، وأفضت تراكماتها القاتلة إلى ما نعيشه الآن في عين الكارثة، بسبب استباق السياسي للثقافي، والإقصاء المتعمد لدور المثقف الرائد باعتماد سياسة زجه في النفق المظلم، وحرفه عن دوره التنويري القادر على نقد ركام الزيف والمسخ الفكري وديكتاتورية الحكم.

في "البنيوية... الإنسان والتاريخ" يدرس الرحبي الظاهرة الإشكالية للبنيوية كمدرسة فكرية، تبلورت في ذروة الحرب الباردة، كتيار بدأ في الانتشار وغزا الكثير من العلوم الإنسانية، كي يعمم نفسه على أشكال المعرفة وحقولها، وقد ذهب منظروها إلى إعلان القطيعة مع النزعة التجريبية والنزعة التاريخية، متجهين إلى الوعي، محيلين إياه إلى بنية، بهدف الكشف عن عناصر الثبات في العقل الإنساني، تحت مزاعم الوصول إلى الدقة في العلم المنضبط للعلوم الإنسانية كما في العلوم الطبيعية.
الظاهرة التي قالت بموت الإنسان، ستجد من يعبّر عن نزعاتها الإشكالية في حقول المعرفة بإسهامات كبار المفكرين والنقاد في القرن العشرين، فهي ـ كما يذهب محمد العباس في مدونته ـ "اشتغال على درجة من التشظي، كما يتأكد ذلك من خلال تأمل الأسماء الفاعلة في هذا الحقل المعرفي بتبايناتها المختلفة: الماركسية عند لوي ألتوسير، والإبستمولوجية عند ميشيل فوكو، والسيكولوجية عند جاك لاكان، والأدبية عند رولان بارت، والأنثروبولوجية عند ليفي شتراوس، والألسنية عند سوسير، والرياضية عند مدرسة البورباكي."
الدراسة ستعنى كثيرًا بنتاجات كلود ليفي شتراوس، أحد الآباء الكبار للبنيويين في هذا السياق، وهي ـ فيما ستعنيه لنا ـ تلك الإحالات بالغة الدلالة لاشتغالات الرحبي بموضوع الدراسات الاجتماعية، الذي هو الجزء الخالص في تخصصه العلمي.
المادة التي ستذهب بنا إلى مفردة ثالثة في انصرافات الرحبي، وهي مقارباته النقدية للموضوع التراثي، وستتوقف أمام تلك المفارقة بالغة الدلالة في رؤيتين متعارضتين للجاحظ بشأن الكتابة. فقبل أن (يتعزّل) كان الجاحظ يرى في الكتابة العدو الأول للعقل، مُعليًا من شأن المشافهة، شأنه شأن فلاسفة اليونان الأوائل مثل سقراط، "الذي عُرف عنه ذمه واستهجانه للكتابة، ظنًا منه واعتقادًا بأنه ينزه الحكمة من دنس التدوين"، ويقترب أيضًا من الزاوية الأكثر قتامة في رأي فقهاء عصر الانحطاط من شافعية واثني عشرية في مسألة الكتابة. ومرجع ذلك عندهم أن المشافهة والسماع من أهم ركائز الموروث العربي الإسلامي في السرد القائم على الرواية والسماع.
الكتابة بهذه الرؤية تغدو العارض، أما المشافهة فهي الجوهر، الذي يمثل عين الحكمة وتنزيهها، وأن الأولى لا ترقى إلى مرتبة الشرف الرفيع، وتبعًا لذلك فالخط يمثل الدنيئة، وكان يرى للكتاب طبائع لئيمة، وأن أنبلهم أخسهم، وهم والعوام سواء، لأنهم أشرار خلق الله (ص51).
الرؤية التي أسست فكريًا وثقافيًا للشفاهية عن طريق الرواية والسماع وازدراء الكتاب والكتابة، كما يقول المؤلف، سوف ينقضها الجاحظ بعد أن تبنى أفكار المعتزلة وآراءهم الكلامية ومنهجهم في التفكير، وسيكتب عن أفضال الكتابة ومميزاتها وأهميتها العلمية والثقافية في ترسيخ الفكر والمعرفة، وما تتركه من تأثيرات عميقة على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية من تطور، بما في ذلك صفاء النفس وشفافيتها (ص53).
عقد التسعينيات بعواصفه العاتية، التي اجتثت الكثير من المسلمات والمفاهيم التي صمدت طيلة فترات الحرب الباردة، جعل الكثير من المشغلين بحقول الدراسات الإنسانية، مثلهم مثل المشتغلين في حقول المعارف السياسية والاقتصادية، يعيدون النظر في الجهاز المفاهيمي للمصطلحات الراكدة وعصبها المتيبس.
أتذكر أن التفاتات المشغلين بحقول النقد الأدبي، مرة أخرى، لمفهوم الريادة الشعرية، خلقت العديد من السجالات، وهنا كان عبد الكافي واحدًا من النقاد المعدودين، الذين أولوا الموضوع عناية مختلفة، فكتب موضوعًا متميزًا حول صناعة الريادة، التي اعتبرها أقرب إلى صناعة النجومية منها إلى دراسة التحولات الثقافية والاجتماعية، التي شهدتها البلدان العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ودخلت معظمها ما عُرف بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.
لهذا، فالريادة عند الرحبي هي ظاهرة اجتماعية إبداعية تاريخية، حتمتها ضرورة التغيير في البنية والشكل في مجال الشعر، انسجامًا مع تطورات العصر ومؤثراته، والارتقاء بالبنية الجمالية الشعرية، كي تستوعب الثراء والتنوع في الحياة والمعرفة، وإعطاء الفضاء التخييلي مداه واتساعه الجمالي والإبداعي في القدرة على صياغة موضوعاته وإشاراته الرمزية من خلال التشكيل اللغوي، بدلالاته الجمالية التي كشفت عنها القصيدة الجديدة منذ أواخر الأربعينيات: "صناعة الريادة... وهم أم حقيقة؟!" (ص61).
في هذا الكتاب، عمل الرحبي على إجلاء الغبار عن واحد من المفكرين اليمنيين وأكثرهم دأبًا وعلمًا، وهو العالم اليمني في مجال الفكر العربي الإسلامي الدكتور حسين بن فيض الله الهمداني، الذي أفاد خلال النصف الأول من القرن الماضي الكثير من الباحثين الذين درسوا الفرق الإسلامية، بالذات ما يتعلق بفكر وتكوين فرقة الإسماعيلية، حيث مثّل مرجعية فكرية وتاريخية، وأفاد بعلمه الغزير العشرات من الطلاب في جامعات الهند وألمانيا ومصر، التي عمل محاضرًا فيها منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي حتى وفاته في العام 1962م.
ولأنه لم يحظَ بقدر كافٍ من الاهتمام والبحث الذي يستحقه إلا فيما ندر، كان على الرحبي، المثقف الملتزم، أن يُجلي عنه غبار عدم الاهتمام هذا، ومنه التعريف به كأول أكاديمي في الجزيرة العربية والخليج، على عكس ما ظنه الجميع بأن المرحوم الدكتور محمد عبده غانم هو أول خريج، حسب ما درجت عليه العديد من الكتابات التي ذهبت في تأكيد مثل هذه القضية.
وحسب الكاتب أيضًا، تبرز أهمية هذا المفكر والعالم الجليل بأنه كان يجيد العديد من اللغات الحية، ولغات قديمة عديدة، وهي سمة يتصف بها العلماء والمفكرون البارزون الذين أفنوا حياتهم في البحث والدّرس، وأفادوا البشرية بعلمهم (ص63).
وكشف الرحبي في مقالته هذه عن معلومة مهمة جدًا، وهي أن المفكر العربي الكبير الراحل عبد الرحمن بدوي، وفي طور تأليفه لكتاب "من تاريخ الإلحاد في الإسلام"، استفاد من ذخيرة الهمداني المعرفية والكتب المخطوطة المتوفرة في المكتبة المحمدية الهمدانية، فقد مده بعديد مخطوطات انبرت تدافع عن الإسلام في وجه تيار الزنادقة، ومنها المجالس المؤيدية لمؤلفها المؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الشيرازي، داعي الدعاة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، والتي ظنّها الجميع مفقودة منذ زمن طويل، ووجدها بدوي ـ كما قال ـ في مكتبة الهمداني، إلى جانب مخطوطة لأبي حاتم الرازي بعنوان أعلام النبوءة (ص55 و56).
في العام 2000، نشر عبد الكافي الرحبي مادة مهمة بمناسبة الذكرى المئوية لصدور كتاب المفكر النهضوي الكبير عبد الرحمن الكواكبي، أسماها كما تظهر في الكتاب أيضًا "الثقافة ومحنة الاستبداد"، وفيها اقترب من واحدة من أسمى إسهامات رواد التنوير التي وئدت، حتى تتعبد طرق الاستبداد لنخب الحكم، تحت شعارات وطنية ودينية زائفة، حذّر من ويلاتها في كتابه الرائد "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد".
في هذه المئوية قال الرحبي:
"من أكثر من قرن، ونحن نراوح ما بين الحرية والديمقراطية، وما بين الاستبداد المطلق للسلطة الحاكمة، وهيمنتها الكليانية على الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، تحميها منظومة من الرؤى والمفاهيم، يعمل على صياغتها باجتهاد مثقفون سياسيون يكرسون التخلف ويعيدون إنتاجه" (ص71).
دور المثقف الساند والمُبرر للاستبداد، كما يتجلى هنا، هو المعضلة الحقيقية والمعيق لمشروع التنوير الذي نادى به الكواكبي ورواد مشروع النهضة، فإن لم تتخلق حاضنة واعية بمشروع الحرية، يكون نواتها المثقف والثقافة المتحررة من التبعية وتغوّل السلطة وقهرها، فكل شيء سيذهب أدراج الرياح. فالخوف والخضوع يتيحان للاستبداد مصادرة حرية الأفراد والشعوب معًا، ويقودان إلى إنتاج سلطة قاهرة مستبدة منغلقة على ذاتها، لا تعترف بالثقافة والمعرفة إلا إذا كانتا امتدادًا لها (ص76).
(2)
كتاب "أعمدة الشمس"، الذي اختتمه الرحبي بموضوع "العولمة وتسليع المعرفة والثقافة"، افتتح كتابه "فضاء الخطاب النقدي" بما هو بديل عن المقدمة، بالقول:
"في عصر العولمة والقرية الكونية، ما من شك أننا نعيش على هامش الثقافة والفكر، بل في خارج العملية الإبداعية بشقيها المادي والروحي، والمتأمل لواقع الحال في بلادنا سيكتشف أن الوضع مزرٍ وبائس، عما كان عليه الحال في السبعينيات والثمانينيات، التي شهدت انتعاشًا فكريًا وثقافيًا، في شتى المجالات المعرفية، بما في ذلك الحوارات الفكرية والثقافية." (ص3)
الانحدار نحو الخراب، في هذه البلاد كما شخصها الرحبي، بدأ بهذا التراجع المخيف للموضوع الثقافي، الذي استتبع التراجعات في الفضاء العام للمجتمع. فما أُنجز قبل أربعة عقود، وفي ظل الانغلاق وسطوة الأجهزة، أهم بكثير مما أُنجز في عصر العولمة والفضاء المفتوح.

لهذا كان لزاماً أن يكبر السؤال المهم والمختزل في: "هل ما كان يُطرح من إشكاليات ثقافية وإبداعية، تعبير عن عمق فكري ومعرفي أصيل، متجذر في الواقع، ومؤطر في مؤسسات ومراكز علمية، أم كان سطحياً وهشاً يعكس وجاهة ثقافية ونبالة نخبوية منفصلة عن واقعها؟!" (ص5).
في موضوع (ديكتاتورية النص.. مستودع الطاعة)، يسجل الرحبي موقفاً واضحاً من موضوع الشهرة والنجومية التي جعلت بعض الكُتّاب لا يتورعون عن تسجيل مواقف سريعة متناقضة حيال قضايا فكرية وثقافية، متكئين في ذلك على حضورهم الإعلامي الضاج، الذي يتحول بإسناده هذا النجم إلى نص قامع متعالٍ، مهمته الرئيسية وأد كل نص إبداعي نقيض. فيخلق مقابل مقدسه الشخصي مدنّس الآخر، هذا المدنس يُختزل في كل مرة عند القارئ الحصيف بعملية الخروج من مستودع الطاعة، وعدم الرضوخ لهيمنة ديكتاتورية النص المتعالي، والخروج عند الرحبي لا يتم إلا بامتلاك مفاتيح التفكير الإبداعي الحر.
في موضوع (النقد الأكاديمي والإبداع)، يدرس الرحبي ظاهرة غياب النقد الأكاديمي الصارم عن العملية الإبداعية، بسبب ابتعاد النقاد أنفسهم، بمن فيهم أساتذة الجامعات، عن تطوير ملكاتهم ومتابعة المتغيرات المتسارعة على منظومة المفاهيم والمقولات المنهجية والنظرية للمذاهب الجمالية والأدبية الكبرى (ص14).
لهذا فالمصطلح النقدي الحديث غائب عن الساحة النقدية الإبداعية في بلادنا، ولا نكاد نلمس أو نحس بوجوده، وإن وجد فبصورة شاحبة. وبالمقابل يتغير ويتطور بشكل نوعي لدى النقاد العرب، خصوصاً في منطقة المغرب العربي، بسبب وجودهم على تماس وتثاقف مع المنجز النقدي ونظرياته النقدية في الغرب (ص17).
في موضوع "التناص ووهم الأبوة في الإبداع"، يقوم الرحبي بتحليل ظاهرة التناص من زوايا الإنتاج والتلقي، معتبراً أن الظاهرة تعبير مكثف عن الإحلال والإزاحة في جدلية العملية الإبداعية. فالنص لا يتخلق من فراغ، لكنه يُنتج في عالم مليء بغيره من النصوص، غير أنه يحاول في كل مرة أن يحل محل هذه النصوص بإزاحتها، إما بالتطابق أو الانفصال أو النفي الكلي. أما أهمية التناص في الدرس النقدي، كما يرى، فتكمن في دحض وهم الأبوة الروحية في الإبداع وتخليصه من هذا القيد الكابح (ص23 ـ 24).
في استعراضين متعاقبين وشاملين، قدم الرحبي للقارئ جهدين متميزين لناقدين كبيرين يمثلان مدرستين نقديتين مختلفتين: الأول هو المصري صبري حافظ في كتابه الصادر عام 1996 بعنوان أفق الخطاب النقدي ـ دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، وهو كتاب ـ كما يقول ـ يتناول الخطاب النقدي الحديث، الذي يدور حول مناطق الإبداع الأدبي والجمالي والمعرفي اللصيق بصناعة وإنتاج الرساميل الرمزية، التي تبدأ برأس المال الاعترافي وتنتهي بكل أشكال الهيمنة الرمزية في المجال الثقافي/ الأدبي (ص27).
أما الثاني، فهو المغربي عبد الفتاح الحجمري في كتابه الصادر في ذات العام بعنوان عتبات النص.. البنية والدلالة، وبواسطته أبرز الرحبي ما للعتبات من وظائف في فهم خصوصية النص وتحديد مقاصده الدلالية، وما ترسمه من أهمية في تعيين طرائق اشتغالها وطبيعة العلاقة التي تقيمها مع أشكال متنوعة من الخطابات والروابط الفكرية، وبين مكونات النص ضمن بنية دلالية شمولية تراعي شروط إنتاج الخطاب وتداوله (ص36).
في موضوع (السابق في الإبداع... اللاحق في التراث)، ينجز الرحبي قراءات في الموضوع السردي المعاصر، المتكئ على مبذولات التراث وفضاءاته، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى إنتاج نصوص شديدة الخصوصية والتفرد، على نحو رواية الأمريكي مايكل كرايتون أكلة الموتى، التي نهضت كفكرة على تفاصيل مدونة ابن فضلان وسفراته إلى ملك الصقالبة ممثلاً للخليفة المقتدر، إلى جانب سرد تفاصيل رحلته الطويلة إلى بلاد الروس والبلغار والأتراك والبلاد الباردة "اسكندنافيا"، في وقت كانت تعيش فيه هذه البلدان حياة بدائية، ولم تدخل بعدُ لحظة التدوين "القراءة والكتابة".
في موضوع (التلقي المبدع)، طرح الكاتب جملة من الأسئلة الحادة حيال ظاهرة الكتابة الإيروتيكية التي شاعت في التسعينيات، وامتُح فيها عديد الكُتّاب والفنانين من موضوعات الجسد في التراث العربي أفكاراً لكتاباتهم ورسوماتهم، فقال:
"هل الموروث هو الأنسب لإنتاج النصوص الأدبية، وأن الراهن لم يعد قادراً على مدّهم بموضوعات جمالية وفنية تعبّر عن وجدانهم؟! أم أن الواقع قد بهت، ولم يعد ثرياً ومتنوعاً بالموضوعات التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم الإبداعية؟!"
لكن، بمقابل ذلك، أمكنه التوقف أمام تجارب إبداعية لافتة تتقاطع وتتناص مع نصوص تراثية أُنتجت منذ قرون عديدة، لتقدّم نفسها كحالات كتابة تجريبية عالية الدهشة في وقتنا هذا، تطلب إعادة إنتاجها جهداً فنياً وتراكيب لغوية من حيث التوزيع الطوبوغرافي للكتابة كرؤية جمالية بصرية. ومنها كتاب (أخبار المجنون) للشاعر قاسم حداد، و**(كتاب الحب)** للشاعر محمد بنيس، ورسوم الفنان العراقي ضياء العزاوي.
(**)
هذه الإطلالة على منجز عبد الكافي الرحبي النقدي، الملموم بعضه في كتابين، تعطي القارئ صورة ـ أردتُها قريبة ـ عن قلم نقدي شديد الخصوصية والتأثير، سيتوقف أمام "رسالته" دارسو ومتتبعو تجارب النقد الأدبي في اليمن طويلاً، لانفتاحاتها وتعددها الأسلوبي والجمالي.