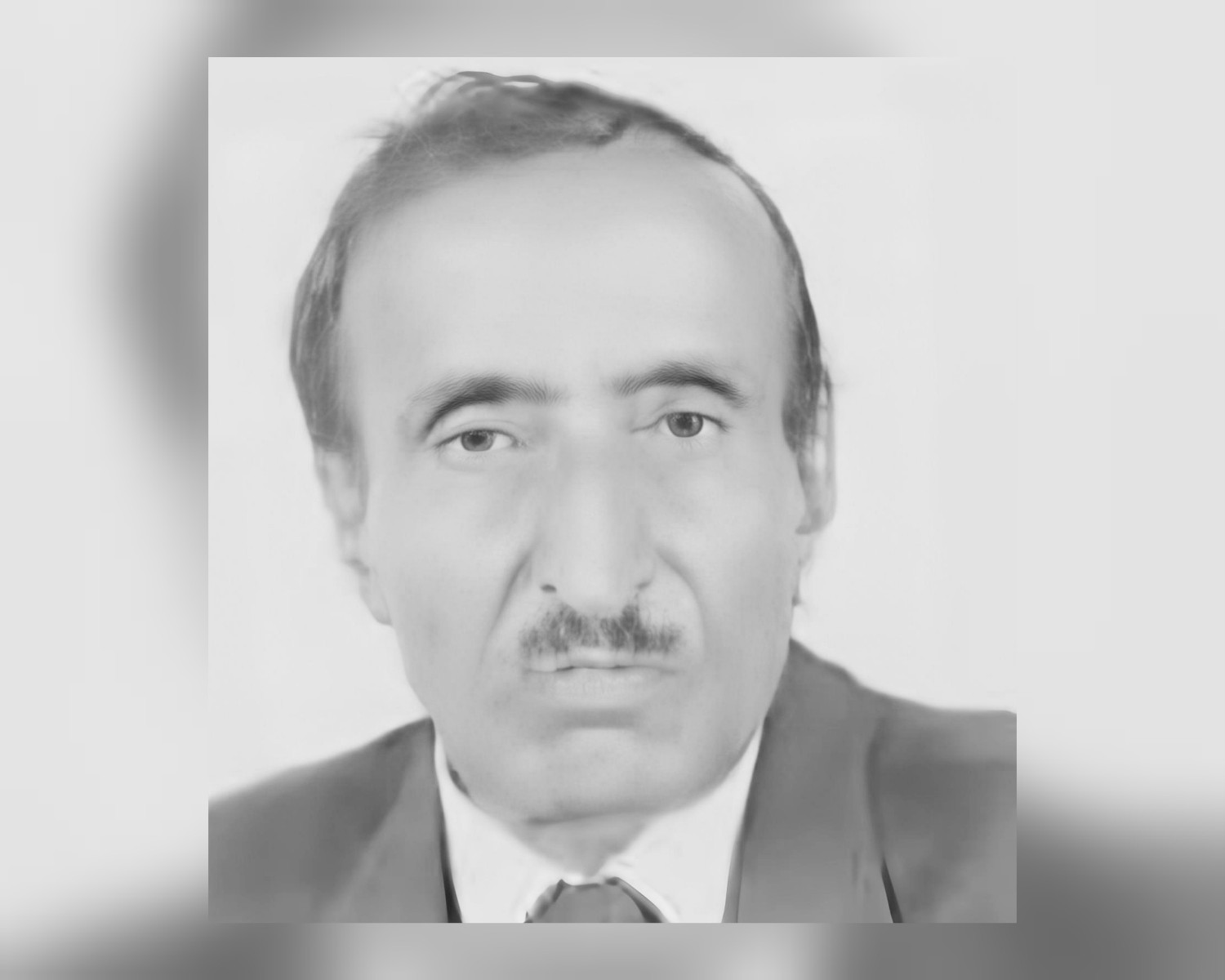أحمد محمد نعمان.. بين المقابلة والمذكرات والسيرة.. قراءة فكرية سياسية(4-4)
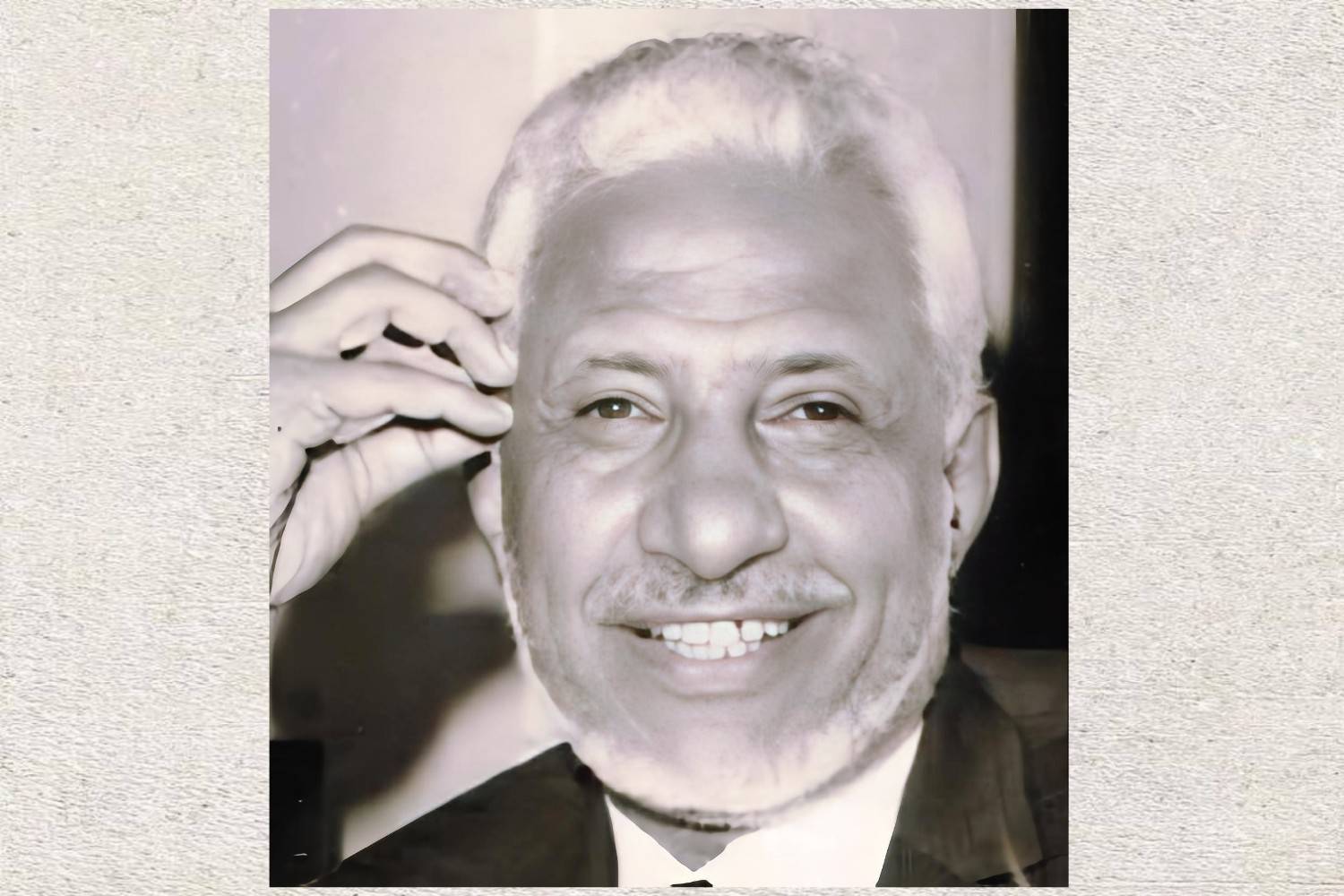
-ب-
"حركة الأحرار" وصعود الحركة السياسية والوطنية التحررية اليمنية
التاريخ السياسي اليمني المعاصر، يقول لنا إن ثورة 26 سبتمبر 1962م، جاءت بعد محاولات إصلاح عديدة للنظام السياسي/ الاجتماعي الإمامي الحميدي المتوكلي، بداية من الوعظ الديني، والنصح والإرشاد، منذ نهاية الثلاثينيات إلى بداية النصف الثاني من الأربعينيات، ولم تكن حركة 1948م الدستورية، سوى محاولة أخيرة لإصلاح نظام الحكم الإمامي، حتى كان انقلاب 1955م، المشترك بين بعض إخوة الإمام، وكبار ضباط الجيش، دون الدخول في تفاصيل قضية الحوبان، حتى الدخول في لعبة "ولاية العهد"، وهي صناعة مشتركة -كذلك- بين الأحرار، والإمام أحمد من تحت الطاولة من قبل الإمام أحمد، وجميعها لم تجد ولم تقد إلى شيء سوى تأكيد الاستمرار في الحكم بالطريقة القديمة، بل وأسوأ، في انتظار نتائج جديدة ومختلفة، دون جدوى. وجاءت ثورة 26 سبتمبر 1962م، تعبيرًا عن إرادة قوى حية صاعدة.. تعبيرًا عن إرادة شعبية بالتغيير وبالثورة، على طريق تحطيم النظام السياسي/ الاجتماعي الإمامي، باعتبار الثورة الطريق الوحيد والأخير للإصلاح والتغيير، وهو ما كان.
ذلك أن رؤية الأحرار للتطور والتقدم الاجتماعي، كانت تكاد تكون رؤية مثالية ساكنة، رافضة للتغيير السياسي/ الاجتماعي الثوري، وهذا الأمر ينطبق بدرجات متفاوتة، على معظم رجال حركة الأحرار، باستثناء شباب الأحرار: الفسيل، اللواء الأكوع، محمد أحمد نعمان، صالح الدَّحان اليساري، وعلي محمد عبده... وغيرهم، الذين نجدهم أكثر اقترابًا من الفكر التغييري الثوري، وبعضهم رفع شعار الجمهورية مبكرًا.
ولذلك وجدوا أنفسهم بعد قيام الثورة وفي سياقها متصالحين إلى حد بعيد معها بدرجة أكبر وأعمق، بل وجزءًا أصيلًا من بنية النظام الثوري الجديد، مع ملاحظات حول هذه المسألة أو تلك القضية، مؤكدين على تعقيدات المشكلة اليمنية، في أزمتها التاريخية المستمرة، دون حل جذري حتى اليوم.
إن حركة الأحرار نشأت ووجدت، كحركة معارضة للإمامة، وانصبت جهودها الفكرية والسياسية والعملية/ النضالية في هذا الاتجاه من المطالبة بحكومة ونظام ملك دستوري "إمامة ملكية دستورية"، حتى العمل في هذا الاتجاه من خلال فكرة "ولاية العهد"، ولم يتجاوز سقف حركة الأحرار هذا البعد والمحتوى والعمق من الرؤية، وكل ما عدا ذلك تفاصيل وهوامش على ذلك المتن، وبقيت كذلك حتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، وهنا علينا أن ندرك ونفهم أن مصطلح ومفهوم "حركة المعارضة اليمنية"، تحت قيادة وزعامة حركة الأحرار، تدخل ضمنه العناصر شبه الإقطاعية المستنيرة والمطالبة بالإصلاح من داخل الطبقة/ الأسرة الإمامية المستنيرة، وهو ما تأكد في صورة التحاق سيف الحق إبراهيم بالحركة في عدن، وبعدها التحاق بيت الوزير على رأس قيادة حركة 1948م، في سياق قيامها والإعلان عنها وهي بهذا المعنى والمفهوم في حينه، مطالبة بـ"إمامة ملكية دستورية"، بدلًا عن "الإمامة الوراثية"، خارج شروط المذهب الزيدي الهادوي. وفي أي سياق تجد اسم أو مصطلح "حركة المعارضة اليمنية"، فإن المقصود بذلك، هو حركة الأحرار في معارضتها للإمامة، لا أقل ولا أكثر.
وحول الأحرار، وثورة 26 سبتمبر 1962م، يكتب د. عبدالعزيز المقالح، في مقدمته لكتاب جار الله عمر، التالي:
"كان الأحرار الدستوريون في بلادنا يحلمون بنظام ملكي دستوري، إلا أن ثوار سبتمبر وأكتوبر كانوا أكثر طموحًا حين ارتفعت أحلامهم إلى النظام الجمهوري بوصفه التجسيد الكامل للنظام الدستوري غير الخاضع للتوريث والتأبيد"(7).
أي الموقف الرافض لإعادة إنتاج الإمامة، في صورة "ولاية العهد" للبدر، أو لغيره من الأسماء الإمامية، كما كان يفكر ويتصور الأحرار إلى قبيل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.
فالزبيري، في روايته "واق الواق"، 1960م، القاهرة، يقدم لنا نموذجه الأيديولوجي والسياسي التاريخي للحكم، ولنظام الحكم الذي يستمده من استعادته لصورة "مجالس الحكم" في دول اليمن القديم، بعد أن اختصر الشعب اليمني في كل البلاد اليمنية، في "حاشد" و"بكيل" باعتبارهما جناحي اليمن، وهو الذي طالب في مؤتمر "عمران" 1963م، الذي رأسه، بضرورة قيام ودعم تأسيس "جيش قبلي من (28 ألف قبيلي مسلح)"، في مقابل وموازاة جيش الدولة الرسمي(8). وهو ما تم رفضه، وكان أحد علائم ومؤشرات الصراع السياسي المبكر، في صورة ظاهرة، المؤتمرات القبلية الأولى، والذي ظهر لاحقًا، في رأس القيادة الجمهورية.
وهي، في تقديري، حركة ارتدادية للخلف، كما وردت في نصوص مؤتمر "خمر" 1965م، في صورة "حزب الله"، وفي صورة مؤتمر " الطائف"، ارتدادًا عما قدمه الأستاذ أحمد النعمان، والشهيد محمد محمود الزبيري، في دستور "مطالب الشعب" عام 1956م.
مع أن الأحرار حتى وهم يقدمون دستورهم في "مطالب الشعب" عام 1956م، وهي "المطالب" التي أراها في سياقها التاريخي، وثيقة فكرية/ سياسية تاريخية تقدمية بكل ما تحمله كلمة تقدمية من معنى، فإنهم لم يتحدثوا في "المطالب" صراحة وبوضوح وبالاسم عن الجمهورية. قالوا الكثير مما يعني نسف بنية الإمامة في الخطاب، كرؤية ونظام حكم، على أنهم تجنبوا النطق باسم وكلمة الجمهورية!
ناهيك عن أن "مطالب الشعب"، على أهميتها الفكرية والسياسية والتاريخية، فإنها كتبت لا ليُبنى ويُراكم عليها معرفيًا وفكريًا وسياسيًا، بل ليقطع معها، ولتهمل وتوضع على الرف، لأنها كما يبدو تجاوزت السقف الأيديولوجي والسياسي لحركة الأحرار.
يمكنني القول: إن الأحرار اليمنيين، لم ينتقلوا بكليتهم؛ الذهنية والفكرية والسياسية والسيكولوجية، إلى المرحلة الجمهورية الجديدة، بقي الكثير -سيكولوجيًا- الذي يشدهم ويربطهم بما كانوا عليه، ولذلك لم يتوافقوا ويتكيفوا مع القوى الاجتماعية والسياسية، والاتجاهات الأيديولوجية الجديدة بعد الثورة.
باختصار، وجدوا أنفسهم في تحالف سياسي مع كبار مشايخ القبائل، ومع القوى الاجتماعية التقليدية (مشايخ الدين السياسي)، ومع كبار الضباط من أصحاب المصالح الصغيرة.
وهنا لعبت "التشكيلة الاجتماعية/ الاقتصادية المتداخلة" والمعقدة، دورًا في صناعة وصياغة ذلك الفرز الاجتماعي/ السياسي الذي ظهر في سياق الثورة.
إن ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 أكتوبر 1963م، هما التجاوز الفكري والسياسي التاريخي، لرؤية وبرنامج حركة الأحرار التي وصلت إلى سدرة منتهاها بقيام الثورة اليمنية المعاصرة، في صيغة الجمهورية الواضحة في الشكل والمضمون، ولذلك استمروا يقاتلون بصبر استراتيجي، طيلة سنوات 62-1968م، للحفاظ على روح وصيغة المعنى الجمهوري، والأهم محتوى النظام الجمهوري، الذي كانت هناك محاولات مستمرة ومستميتة للانقلاب عليه، من مؤتمر "جدة"، 1965م، بين الرئيس جمال عبدالناصر، والملك فيصل، إلى مؤتمر " حرض"، وصولًا إلى محاولة استبدال النظام الجمهوري، "بالدولة اليمنية الإسلامية"، وجزء هام وفاعل من حركة الأحرار أو بقايا حركة الأحرار، كانوا ضمن هذا الاتجاه والتوجه!
وبهذا المعنى، كان لقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر القول الفصل في كل ما كان يتصوره ويتوقعه بعض الأحرار، قبل شهر أو أسبوع من قيام الثورة وحتى بعد قيامها، صارت أو غدت معه كل تلك الرؤى والتصورات التي أشار إليها الأستاذ أحمد النعمان، تدخل في عداد القول المستحيل.
أي أن ثورة 26 سبتمبر 1962م، بل حتى من قبل قيامها بسنوات، كانت الحركة الطلابية اليمنية في مصر "اللجنة التنفيذية" للمؤتمر الدائم للطلاب، ومعها الحركة السياسية الوطنية اليمنية الصاعدة، قد أسقطت -جميعها- نهائيًا في رؤيتها وخطابها، فكرة وقضية المراهنة على إصلاح الإمامة من داخلها، كما كان يفكر فيه الأحرار، بما فيه فكرة أو لعبة "ولاية العهد" للبدر، والمراهنة الرومانسية الحالمة على البدر. وفي هذا السياق، وحول هذا المعنى، تحدث السفير الشاعر، عبده عثمان محمد، حول المراهنة على البدر قائلًا: "إن قصور وعيه -البدر- لم يمكنه من إدراك ذلك، فأعلن بما يسمى خطاب العرش أنه سينهج سياسة والده الرشيدة، وتنكر لكل الوعود التي كان يعد بها، الأمر الذي دفع التنظيم إلى القيام أو بالأصح إلى تفجير ثورة 26 سبتمبر 1962م"(9).
ذلك أن البدر في تكوينه الذاتي/ الشخصي ليس مجرد علاقات ذاتية، وعواطف شخصية عابرة تجاه هذا الاسم من الأحرار أو ذاك.
فولي العهد، البدر، والإمام بعد ذلك، هو في التحليل الأخير، انتماء سياسي/ اجتماعي/ طبقي، وموقف أيديولوجي/ تاريخي، ونفسية اجتماعية/ ثقافية، وقبل كل ذلك مصالح مادية وسياسية تتقدم وتسبق علاقاته الذاتية/ الشخصية/ الرومانسية الوجدانية العاطفية بهذا الاسم من الأحرار أو ذاك.
هكذا يقول منطق الفكر والواقع والتاريخ والمصالح، ولذلك استمر البدر يقاتل من بعد هروبه من قصر البشائر، من أجل الإمامة، حتى سقطت جميع أوراقه الأيديولوجية والسياسية والمادية على مذبح المقاومة البطولية لشباب الثورة،
"المقاومة الشعبية"، أي أنه كان يقاتل -البدر- من أجل الحكم والملك والعرش، وليس ضد أعداء اليمن المصريين.
إن حركة الأحرار اليمنيين محاولة نبيلة لم تنجح للانتقال من الإمامة الاستبدادية "القروسطية" إلى الإمامة الدستورية.. انتصر الإمام، واستمرت الإمامة، وسقطت الفكرة الدستورية على نبالتها، في كل مراحل الحكم الإمامي الحميدي المتوكلي.
فقد جاء في مذكرات الأستاذ النعمان المسجَّلة التالي:
"عندما رأيت أن الاتجاه ضده في مصر -يقصد ضد البدر- فهمت ذلك، وحاولت أن أخرج من مصر وأسافر إلى اليمن بعد موت الإمام أحمد، لأكون إلى جانبه أنبِّهه (...)، ولكن كما يقولون: سبق السيف العذل"(10).
حقًا، لقد "سبق السيف العذل"، كما قالها الأستاذ النعمان، وهي أن الكلمة النهائية الفاصلة كانت وصارت للشعب اليمني؛ الشعب الذي قرَّر وحسم أمره في إزالة استبداد "قروسطي"، امتد وطال لحوالي 1160 عامًا متقطعة في التاريخ السياسي، من الإرهاب السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي، جعل اليمن في آخر سورة وآية من التخلف.
يكفي أن الأستاذ النعمان ورفاقه الأحرار، طيلة نيف وثلاثة عقود، لم يتمكنوا حتى من القدرة على قول النصح والوعظ الديني والإرشاد السياسي.
ومذكرات أو مقابلة/ سيرة الأستاذ أحمد النعمان تقول هذا المعنى في أكثر من موضع من مواضع الكتاب.
أتفهَّم أن المذكرات/ المقابلة سُجِّلت ورائحة السجن وطَعم التعذيب النفسي وأصوات الحرب ماتزال قائمة، وطبولها ماتزال أصداؤها ترنّ في عقل ونفس وروح الأستاذ النعمان.
على أنني لا أستطيع، كقارئ وسياسي وباحث يمني -أتكلم عن نفسي- أن أبرر أو أتفهَّم أن الإمام البدر كان يدافع لا من أجل الملك والحكم والعرش، بل "من أجل أن يحرر اليمن من عدوها!"(11). وهي -في تقديري- قراءة سياسية/ ذاتية لا تاريخية، لا علاقة لها بالواقع، في صيرورته التقدمية الإنسانية، كما جسدتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر.
ولا أعتقد أن هناك باحثًا محايدًا مستقلًا -أتكلم كذلك عن حدود رؤيتي واطلاعي- يمكنه أن يتفهَّم خطاب الخصومة حين يصل إلى هذه الدرجة من الحدَّة، الذي تنضح به بعض سطور تداعيات الذاكرة، في المذكرات المسجَّلة بالصوت، ناهيك عن أن يبرِّرها. هذا هو انطباعي، بل رأيي الذي لا أفرضه على أحد.
النص السالف للأستاذ الجليل النعمان، فيه الكثير من الذاتية والانفعالية (رد الفعل)، وفي تقديري، لو أن مادة المقابلة/ التسجيل -كما سبق أن أشرت- عُرضت عليه بعد أشهر أو حتى سنوات من تفريغها، لكان له -في تقديري- رأي آخر فيها... في إعادة النظر فيها، تعديلًا وإضافة وحذفًا. أقصد كرؤية وتأويل، وليس كأحداث ووقائع.
هكذا يقول منطق الموقف من قراءة سُجِّلت، وماتزال رائحة القهر، وطَعم العنف والحرب قائمة، "وصعدة" تسقط فوق "رتب العمداء" (سقطت صعدة على العمداء)، حسب تعبير الشاعر الذهباني، وظلال الحرب الكئيبة تطغى على صفحة التفكير عند الجميع، بخاصة وأن التسجيل الصوتي لم يُعَد النظر فيه، لتنقيحه وتصويب بعض أخطاء وعثرات التسجيل، وتداعيات ذاكرة القول الشفاهي، وهو ما كان مطلوبًا في مثل هكذا حالة.
"وحسب رأي فريدريك إنجلز (...)، أنه كلما طالت المسافة الزمنية بين لحظة وقوع حادث ما، والكتابة عنه بغية تحليله من أبعاده المختلفة، كان التشخيص أدق. لم يكن إنجلز يقصد بالضرورة وقائع التاريخ البعيدة، وإنما تلك التي وقعت في العصر الذي يعيشه الباحث، أو المحلل، والقصد هنا، هو أن المسارعة إلى تشخيص حدث ما لحظة حدوثه (...) والأهم عدم الانتظار حتى تتبين تداعياته، والنتائج المترتبة عليه، ما يتطلب وقتًا، نقول: مثل هذه المسارعة إلى التشخيص عرضة أكثر للوقوع في سوء التقدير، إن لجهة المبالغة في حجم الحدث، أو العكس التقليل من أهميته"(12).
فما بالكم ونحن أمام تداعيات حدث جلل، فيه بُعد ذاتي إنساني، فيه سجن وتعذيب روحي ونفسي، طال حياة من يتحدث عن الحدث، في واقع مسافة زمنية قصيرة، وماتزال ذاكرة عنف السجن وتداعياته عالقة ولصيقة في أنف وفم الكلام في شفتيه، وفي صميم وجدانه المقهور والمتعب.
فرح البعض في سبق النشر غطى على مضمون ما سينشر، وعلى ما فيه من نواقص ذاتية وفنية، نص أظهر الأستاذ النعمان في حالة انفعالية حادَّة.. وأبرز في المقابل الرئيس جمال عبدالناصر كعدو للثورة اليمنية، مع أنه أحد أقطابها ورموزها البارزة، بقدر ما حاول النص إبراز وإظهار عدو الثورة وعدو الشعب اليمني كبطل، ولو على استحياء(13).
بمثل ما أظهرت ما تسمى "المصالحة"، بعد أحداث 23/24 أغسطس 1968م، عبدالرقيب عبدالوهاب نعمان، وأبطال الثورة الشباب كمتمردين حاولوا تدمير صنعاء وقصف القصر الجمهوري، في مقابل الإماميين والملكيين، الذين عادوا كفاتحين إلى صنعاء وإلى قمة السلطة.
وهي "المصالحة"، التي تمَّت "تحت إشراف الملك فيصل"(14)، العدو اللدود للثورة اليمنية في الشمال والجنوب.
إن رموز وقادة حركة الأحرار -أغلبيتهم- لم يكونوا في صميم وعمق رؤيتهم الأيديولوجية/ السياسية مع تجربة ثورة 23 يوليو 1952م، فهم قطعًا ضد إجراءات الإصلاح الزراعي(15)، وضد التأميمات، وضد فكرة الاشتراكية، وضد قضايا ومواقف عديدة اتخذتها ثورة 23 يوليو 1952م، وهي أفكار وقضايا لا يمكنهم القبول بها في اليمن -أقصد القوى التقليدية- تحت أي شرط أو ضغط، وهي لم تكن مطروحة أصلًا في التجربة الثورية اليمنية، وإن كان البعض يتوق ويحلم بتنفيذها يمنيًا، ولكنهم يتحسبون خوفًا من ردَّة فعل القوى السياسية والاجتماعية التقليدية، الذين تحالف بقايا الأحرار معهم.
وهنا نجدهم يلتقون ويتوحدون مع شبه الإقطاع السياسي/ المشيخي القبلي، ومع الضباط المشايخ، ومع القوى السياسية الاجتماعية الإسلامية، ومن هنا وحدة تراصهم وتحالفهم ضد السلال، وشباب الثورة، "المقاومة الشعبية"، القريبين في رؤيتهم من تجربة الثورة المصرية.
فقد وقف القاضي عبدالرحمن الإرياني، مبكرًا، ضد حركة جماهيرية شعبية ثورية محدودة، تحركت تلقائيًا وعفويًا وبصورة محدودة، ضد رموز شبه الإقطاع المشيخي القبلي في بعض الأرياف، وضد مشايخ كبار كانوا تاريخيًا في صف الإمامة، إذ تم سجن أو احتجاز البعض منهم، من قبل الثوار، وحُجزت بعض أراضيهم في بعض الحركات والهَبّات الجماهيرية في بعض المناطق المحدودة (تعز، وإب)، التي كان عنف وبطش هؤلاء المشايخ بالرعية والفلاحين فوق الحد، وتدخل القاضي الإرياني معلنًا احتجاجه ورفضه من موقعه كوزير للعدل ضد هذه الإجراءات المحدودة، كي لا تتسع وتتحول إلى ظاهرة.
ولذلك تم كسرها وقمعها في مهدها، وتم معاقبة وسجن من قاموا بهذه الإجراءات، حتى عودة هؤلاء المشايخ، وشبه الإقطاع السياسي في بعض الأرياف، وبقوة أكبر، مدعومين بقوة السلطة، بصورة أكبر من العنف والبطش. وموقف القاضي الإرياني ذلك، يتفق مع رؤية وموقف التحالف السياسي الذي وجدوا أنفسهم في قلبه.
وهنا يكمن الفارق الأيديولوجي والسياسي النوعي بين حركة الأحرار، والمشايخ، والقوى السياسية الاجتماعية التقليدية، وبين شباب الثورة وتنظيماتهم السياسية والفكرية المعاصرة.
هي لحظة تباين واختلاف فارقة، فكرية وسياسية، بما لا ينفي أو يلغي الدور السياسي والوطني التاريخي الكبير لحركة الأحرار في تاريخها السياسي المعاصر.
إن حركة الأحرار في نشأتها وصعودها السياسي التاريخي، غير حركة الأحرار مع وصولها إلى سدرة منتهى دورها السياسي قبيل قيام الثورة مباشرة، وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، وفي سياق مجرى العملية الثورية وما جرى فيها من تطورات ومن صراعات سياسية داخل جبهة قوى الثورة (القيادة الجمهورية)، ومع قوى العدوان الملكية والرجعية والاستعمارية، التي فتحت أكثر من أربعين جبهة عسكرية ضد ثورة 26 سبتمبر.
قطعًا، أنا لست مع حالة القتل/ الإعدام التي حدثت لبعض الرموز السياسية والفكرية "الهاشمية"، في سياق العملية الثورية السبتمبرية، بخاصة ممن ليس لهم عداوة حقيقية مع الثورة، كما أنني لا أتفق على تجريد بيت حميد الدين بالمطلق من الجنسية ومن حق المواطنة.
أقول هذا كباحث وقارئ بعد مرور أكثر من ستة عقود على قيام الثورة، ولا أعرف كيف كان سيكون موقفي في حينه، من كل ما تم في مجرى العملية الثورية، وفي سياق الحرب العدوانية على ثورة 26 سبتمبر 1962م.
أي أنني أتكلم وأكتب اليوم عن ذلك الحدث، أولًا، من موقعي كباحث، وليس مشاركًا فعالًا في الحدث، وثانيًا، أنني أكتب وأنا على مسافة زمنية كبيرة من زمن وقوع الحدث، أكثر من ستة عقود، وليس والحدث مستمرة مفاعيله وتداعياته على الأرض.
نحن أمام شعب، في غالبيته العظمى، وبكل فئاته الاجتماعية والسياسية والثقافية والوطنية، حُرم طيلة قرون غابرة ودامية من حقه في المواطنة، بل ومن حقه في الجواز كعنوان للهوية اليمنية، وعنوان لحضور معنى الدولة في واقع الممارسة، كان اليمني يهاجر وليس بيده ما يثبت هويته اليمنية، وينتحل أسماء كثيرة إلا اسمه الحقيقي، واستمر هذا الحرمان والعزلة والجمود حتى ستينيات القرن الماضي؛ بقي خلالها كل الشعب اليمني كقطيع/ عبدًا للسيد الإمام، واجب الطاعة دينيًا وسياسيًا، لم تستطع معه حتى النخبة المفكرة من الأحرار اليمنيين التحلل منه، وهو ما يشير إليه صراحة وبوضوح الأستاذ أحمد النعمان في مذكراته، والذي لا يتسع المقام للتفصيل فيه.
يمكنني القول باختصار مكثَّف: إن حركة الأحرار اليمنيين إنما وُجدت وتأسس دورها وكل معنى وجودها، على فكرة وقضية المواطنة (الرعوي والفلاح والتاجر المهاجر)، بحثًا عن العدالة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، في إزالة الظلم الاجتماعي، وتجاوز/ نفي الجمود والركود والعزلة، في صورة ركام التخلف "القروسطي"، الذي استمر يلاحقنا لقرون سحيقة، وإلى بداية ستينيات القرن الماضي، بل حتى اليوم.
ومن هنا لا أستبعد أن تقوم وتكون هناك عمليات رد فعل قاسية، وغير قانونية، وغير "وطنية"، تجاه أسماء من المكون الهاشمي الكريم، وحتى من غيره من الرموز القحطانية، مثل ما حدث مع الأستاذ، القاضي، قاسم الثور، وهي -في تقديري- أعمال جاءت وكانت عبارة عن رد فعل، في سياق عملية ثورية كانت تواجه عدوانًا داخليًا وخارجيًا.
هو أمر قد لا يكون طبيعيًا ولا مقبولًا ولا مشروعًا من خلال التفكير العقلاني النقدي المجرّد في التاريخ، على أنها إجراءات قد تكون مفهومة سياسيًا وواقعيًا وتاريخيًا، في سياق عملية ثورية ضد استبداد تاريخي.
والقراءة الواقعية النقدية التاريخية تقول هذا المعنى، بعيدًا عن الأحكام الأيديولوجية والسياسية، التي تطل علينا بأثر رجعي بين حين وآخر في قراءة التاريخ.
ختامًا، أقول: كل الشكر للدكتور فرانسوا بورغا، مدير المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية، ولمديرة مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، نادية ماريا الشيخ، جميل الشكر وعظيم الثناء، على جهدهما الطيب، وعنايتهما واهتمامهما بتبني نشر هذه الوثيقة؛ الفكرية الثقافية السياسية، في صورة هذا الكتاب، الذي أجده إضافة نوعية للمكتبة اليمنية.
الهوامش:
1- محمد محمود الزبيري: "نعمان الصانع الأول لقضية الأحرار"، الاتحاد اليمني، مطبعة الجماهير، 27/6/1961، ص14-23-24-25.
2- عبده عثمان محمد: مقابلة، أجراها الأستاذ عبدالله الرديني، مجلة الكلمة/ صنعاء، العدد (48)، سبتمبر-أكتوبر 1978م، ص22.
3- قادري أحمد حيدر: "ثورة 26 سبتمبر 1962م، بين كتابة التاريخ وتحولات السلطة والثورة: 1962-1970م"، ط(1)، يوليو 2004م، مركز الدراسات والبحوث اليمني/ صنعاء، ص25، هامش رقم (36).
4- كتاب مذكرات أحمد محمد نعمان: "سيرة حياته الثقافية والسياسية"، مراجعة وتحرير: د. علي محمد زيد، تقديم: فرانسوا بورغا، نادية ماريا الشيخ، ط(1)، 2003م، مكتبة مدبولي، ص194-195.
5- مذكرات أحمد محمد نعمان: نفس المصدر، ص195.
6- مذكرات أحمد محمد نعمان: نفس المصدر، ص194-195.
7- د. علي محمد زيد: من تقديمه لكتاب: "مذكرات أحمد محمد نعمان"، ص10.
8- جار الله عمر: "كفاح الإنسان في سبيل الديمقراطية"، إصدار منتدى الشهيد جار الله عمر، 2014م، من مقدمة د. عبدالعزيز المقالح، ص4.
9- انظر حول ذلك: د. أحمد القصير: "التحديث في اليمن والتداخل بين الدولة والقبيلة"، ط(1)، 2006م، دار العالم الثالث/ القاهرة، ص28-29-31.
10- عبده عثمان محمد: مجلة الكلمة/ صنعاء، العدد (48)، سبتمبر-أكتوبر 1978م، مقابلة أجراها الأستاذ عبدالله الرديني، ص13.
11- مذكرات أحمد محمد نعمان: نفس المصدر، ص195.
12- د. حسن مدن: صحيفة "الخليج" الإماراتية، بتاريخ 30/3/2024.
13- مذكرات أحمد محمد نعمان: حيث يورد الأستاذ نعمان حديثًا دار بينه وبين الإمام البدر، بعد سنوات طويلة من ثورة سبتمبر وسقوط الإمامة، جاء فيه التالي:
"قلت له في أول لقاء: من أحرز نفسه من عدوه فذاك قتل عدوه، إن عبدالناصر قُتل يوم نجوت أنت. فقد أجهز عليك وركَّز على قتلك وعلى أن ينسف القصر عليك -يقصد ليلة 26 سبتمبر، يوم ضرب الثوار قصر البشائر- (...)، وظللت ثلاث سنين تقاتله وتجدع أنفه. ماذا تريد بعد هذا؟ فإن بقي شيء فاجعله من أجل اليمن، واجعل اليمنيين يشعرون أنك لم تقاتل من أجل أن تصبح ملكًا أو لتأخذ عرشًا أو لتحكم، إنما من أجل أن تحرر اليمن من عدوك وعدوها". نفس المصدر، ص195.
14- د. أحمد صالح الصياد: "السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر"، ط(1)، 1992م، دار الصداقة، بيروت، ص360.
15- يشير د. أحمد الصياد إلى "أن د. عبدالرحمن البيضاني صرّح أن الحكومة ليست بحاجة إلى تحديد ملكية الأراضي الزراعية، ولا إلى إصدار قانون إصلاح زراعي. لأن الملَّاك الكبار -حسب قوله- كانوا من أعضاء العائلة المالكة، أو من الأشخاص المقرَّبين منها، وقد تمت مصادرة أملاكهم بعد الثورة مباشرة". أحمد صالح الصياد: نفس المصدر، ص282.
علماً أن البيضاني كان ضد توزيع الفائض من أراضي الدولة الزراعية على الفلاحين، بحكم موقفه الأيديولوجي/ السياسي من قضية الإصلاح الزراعي، والتأميمات في مصر، وضد أي إجراء مشابه في اليمن، وهو ما تقوله جملة كتاباته الأيديولوجية المتشددة اللاحقة حول هذه القضية/ القضايا.