«اللقاء المشترك» يوازي معارضة «آل الوزير».. فهل نحن مقبلون على ما يوازي انقلاب 1948؟.. مرحلة «ولاية العهد» الرئاسية - نبيل سبيع
هل أصبح العام 1946 خلف اليمنيين فعلاً أم أنه ما يزال أمامهم؟ لقد قام التجار في ذلك العام بـ«شبه مظاهرة» إلى قصر الامام يحيى طالبين «أن يجعلهم في عداد الموظفين ليعولوا اهليهم وذويهم بعد أن (...) تعطلت أعمالهم» بسبب استيلاء الأمراء وبعض المقربين من (الإمام) على زمام الاستيراد والتجارة وتقسيمهم اليمن بينهم إلى مناطق محتكرة على تجارتهم ومصالحهم. إن ما يقوده الرئيس علي عبدالله صالح، وهو من أطول حكام العالم عمراً في اتخاذ القرار وأشدهم هجوماً (لفظياً) على ماضي بلاده السيء وسيطرةً على حاضرها الذي لا يقل سوءاً، ليس بلداً له ماضٍ سيء وحسب، وانما أيضاً، وهذا الأخطر، بلدُُ لم يعرف أن يكون سوى نتيجة مضاعفة لأسوأ ما مر به. ولو ألقى الرجل الأول في البلاد نظرة على وجه شعبه لرأى شيئاً أقسى من جريمة «العهد الإمامي البائد» الذي ما يزال قائماً، بصورة أو بأخرى، ولم يصبح «بائداً» قط، إلا في ما يتعلق بشخصياته.
منذ اندلاع حرب صعدة الأولى عام 2004 وحتى إعلان الرئيس صالح إنتهاء الحرب الخامسة في17 يوليو الماضي، ظلت التهمة الرسمية الرئيسية للحوثيين أنهم يحاولون إعادة الإمامة مجدداً إلى اليمن، في حين داوم قادة الأخيرين، ابتداء بالحوثي الراحل حسين ثم الحوثي المقيم عبدالملك، على نفي هذه التهمة.
والسبب وراء محورية تهمة الإمامة في حرب صعدة أنها في ظل مرحلة ترتيب بيت الحكم لمرحلة ولاية عهد موازية لمرحلة «ولاية العهد» التي أرادها الإمام يحيى لإبنه أحمد، دون أن يتمكن من تسميته خلفاً له؛ إذ تم اغتياله، فضلاً عن أن إدارة البلاد تتم الآن- في خطوطها الرئيسية- بطريقة الإمام يحيى.
التشابهات بين حكم الرئيس يحيى وحكم الإمام يحيى
يقدم الباحث أحمد قايد الصايدي في كتابه المهم «حركة المعارضة اليمنية في عهد الامام يحيى بن محمد حميد الدين» إضاءة عريضة لأبرز الخطوط الرئيسية في عهد الامام الذي حكم اليمن الشمالي 30 عاماً (1918-1948) ثم خلفه ابنه أحمد في الحكم قرابة عقد ونصف حتى إعلان الجمهورية في 1962. ورغم أن الكتاب صدر في طبعته الاولى عام 1983 عن مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، أي بعد قرابة 5 سنوات فقط على تولي صالح سدة رئاسة الجمهورية الشمالية، إلا أنه يبدو كتاباً عن موضوع حي وراهن. إنه كتاب تاريخي مهم، لكنه لا يضيء الماضي فقط، بل وجه الحاضر أيضاً. ربما لأن الماضي مايزال حياً وشاباً وسيد الحاضر.
يرى الصايدي 3 سمات بارزة في حكم الامام يحيى: «الفردية المطلقة والجمود والعزلة» (ص40). ويقول إنه (الامام يحيى) «انتهج (...) تجاه القوى الاجتماعية المختلفة والمناطق المختلفة -سياسة توازن استهدفت تثبيت مكانته، وجعله باستمرار مركز الدائرة، والحكم بين جميع القوى. فأوجد موازين قوى في أوساط القبائل بين قبيلة وقبيلة، كما ضِمْن القبيلة ذاتها بإبراز بيوتات مشيخية منافسة للبيوتات الرئيسية». يتابع : «وسلَّط المناطق الشمالية ذات البناء القبلي المتماسك على المناطق الجنوبية الزراعية من اليمن المستقل، جاعلاً من الأولى أدوات لحكمه ومن الثانية مصدراً لتمويل سلطته، وأوجد كذلك توازناً من نوع آخر بين الأسر الحاكمة من القضاة ومن السادة». ويضيف: «كما لجأ إلى أخذ رهائن- في ما يعرف بنظام الرهائن- من شيوخ وأعيان البلاد الذين يخشى معارضتهم له...» (42-43).
أين الفارق بين الحكمين، حكم الإمام يحيى وحكم الرئيس صالح؟ إن الاختلاف بينهما- على ضوء الفقرات السابقة- لا يبرز سوى من ناحيتين، في الأغلب: الأولى، هوية الأسر الحاكمة التي تختلف الآن عنها في عهد الإمام يحيى، إذ أصبحت أسر قبلية مشيخية عسكرية (أسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثلاً). والثانية، أن نظام الرهائن ما يزال قائماً، بصورة أو بأخرى، والاختلاف الوحيد المهم -كما يبدو لي- هو أن هذا النظام المضاد لفكرة «الدولة» وعدالة القانون كان يستهدف أبناء المشائخ في عهد الإمام يحيى (ثم إبنه أحمد)، وأصبح - في عهد الرئيس صالح- يستهدف عامة الشعب اليمني بعد أن استولى تحالف العسكري مع شيخ القبيلة والشيخ الديني على الحكم (معروف أن أجهزة الضبط والسجون في اليمن تأخذ بنظام الرهائن، إذ يتم اعتقال شخص ما بدلاً عن أخيه أو إبنه، الخ..، حتى حضور الشخص المطلوب).
لم يسع الإمام يحيى لبناء «دولة» وإن بالمفهوم البدائي الذي كان العثمانيون قد جلبوه معهم إلى اليمن. وبالمثل، فقد شهد عهد الرئيس صالح تدهوراً ضارياً لحلم بناء دولة يمنية تتمتع بقانون سيد ومحترم من جميع الأطراف، بل إن المكتسبات البسيطة والقليلة التي تحققت بهذا الشأن في الشمال والجنوب بوجه خاص قد تعرضت للتدمير وبشكل ممنهج تقريباً.
لقد ورث الإمام يحيى «عن الأتراك بعض الأساليب الإدارية، ولكنه لم يحاول تطويرها، بل إن أسلوبه الفردي وتدخله في كل القضايا مهما صغرت- حتى في قضايا المشاحنات الشخصية في المناطق النائية- قد أدى إلى تعطيل فعاليتها». يتابع الصايدي: «كما أدى بخله الشديد إلى تقرير مرتبات لموظفي الجهاز الإداري البسيط ولموظفي القضاء لا تفي باحتياجاتهم الضرورية، الأمر الذي أعطى لهم ذريعة للرشوة، وسبَّب فساداً إدارياً متزايداً بتزايد متطلبات المعيشة. وقد كان من نتائج ذلك، خاصة في مجال القضاء، أن تحول الكثير من القضاة عن مهمتهم في حل الخصومات وفك المنازعات إلى عناصر تحريض، يختلقون المنازعات ليرتزقوا منها» (40). لطالما سمعت أشخاصاً، يتحدثون عن «كرم» الرئيس صالح، إلا أن هذا «الكرم» يستند، دوماً، إلى الخزينة العامة. والمسألة، حين تتعلق برئيس أو مسئول أقل درجة تتحرك يده طليقة داخل خزينة «الدولة» دون محاسبة، لا تعود مسألة كرم أو بخل قدرما تصبح فساداً. إن بنية «الدولة» على مستوى سلطاتها الثلاث، فضلاً عن الثقافة التي تم تكريسها، قد تعرضت للتدمير والإفساد العميقين، دون أن يكون الأمر محصوراً على جهاز بعينه.
كتاب الباحث الصايدي غني بالخطوط العريضة التي يرصدها في حكم الإمام يحيى وتجد ما يوازيها في الحكم الحالي، وأبرزها تلك المتعلقة بغياب دولة المؤسسات والقانون في أبسط صورها. ففيما يخص الجيش والأمن مثلاً، يذكر الصايدي أن الإمام اعتمد «على القبائل كقوة أمنية في المناطق، دون أن يسعى إلى إيجاد أجهزة شرطة حديثة» (41)، وهذه حالة لا تبدو غائبة أو بعيدة عما تشهده البلاد اليوم، حيث تنحسر سلطة «الدولة» عن أغلب المناطق القبلية، في الشمال تحديداً، ويتولى الرئيس غالباً التدخل في المشاكل المتعلقة بالنزاعات القبلية- القبلية أو القبلية- الحكومية أو سواها عبر الاتصال التلفوني الشخصي بالمشائخ لضبط مطلوبين مثلاً. وفيما ينحسر حضور «الدولة» في العديد من المناطق القبلية الشمالية تحديداً، يأتي حضورها في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، في أحيان كثيرة، كقوة غاشمة ضد القانون والناس والحقوق العامة والخاصة. ولا يبتعد هذا كثيراً عن توجه الإمام يحيى الذي اشترط على العثمانيين- خلال تفاوضه مع وفد الحكومة التركية عام 1906 على الصلح- إعفاء القبائل الأشد شراسة في القتال وهي «قبائل حاشد وخولان والحدأ وأرحب (...) من الضرائب» (33).
في مجال التعليم، يورد الكتاب أن «إيجاد تعليم عالٍ في البلاد يتعارض مع طبيعة حكم الامام يحيى، وذلك لأنه يقود إلى نشوء أفكار متطورة ويعزز الاتجاه نحو التغيير، لهذا فقد بقيت الكتاتيب- التي يدرِّس فيها مدرسون قرويون أنصاف أميين أطفال القرية مبادئ القراءة والكتابة، بغرض قراءة القرآن- هي أساس التعليم، ولم يحاول الإمام أن يضع سياسة تعليمية تتناسب مع عهد الاستقلال، بل على العكس من ذلك، فقد اختفت في أيامه المدارس القليلة التي أقامها الأتراك» (42).
لقد داومت أيديولوجيا الثورة الجمهورية على هجاء ماتصفه بـ«العهد الإمامي البائد» باعتباره عهداً ضد التعليم، إلا أن هذا لم يبتعد عن التنديد الجمهوري بنظام الرهائن الذي ألصق بحكم الائمة قبل الثورة، رغم أن السجون اليمنية، القانونية وغير القانونية، تعج بالمعتقلين المأخوذين كرهائن. فالعملية التعليمية، إضافة إلى المناهج، في المدارس والجامعات اليمنية لا تقوم بمهمة مكافحة الجهل والأمية قدرما تصب أهدافها في إنتاج جهلة وإرهابيين، مكتفية بتعليم اليمنيين مبادئ القراءة والكتابة على ما كانت مهمة الكتاتيب في النصف الأول من القرن العشرين. لقد تحولت المدارس والجامعات إلى ثكنات أمنية تخلو من أي نشاط بحثي محترم باستثناء نشاط التقارير الأمنية حول تحركات الطالبات والطلاب وبعض المدرسين الذين لا يحملون بطائق خاصة بأجهزة أمنية.
حركة الاقتصاد والتجارة البسيطة, أيضاً, لا تختلف في خطوطها الرئيسية اليوم عنها في عهد الإمام يحيى. يقول الصايدي: «لما أراد بعض التجار أن يقوموا باستيراد بعض المواد... وجدوا أن بعض الموظفين والأمراء قد نزلوا الميدان واستولوا على زمام التجارة وقسموا اليمن بينهم إلى مناطق يحتكرون فيها تجارتهم ويضايقون صغار التجار الذين لم يستطيعوا الثبات أمام هؤلاء التجار الجدد المؤيدين بالسلطان والصولجان...». لقد دفع هذا الوضع، الذي لا يفترق كثيراً عن الوضع الحالي، التجار إلى القيام بـ«شبه مظاهرة» إذ «توجهوا إلى قصر جلالة الامام وطلبوا من جلالته أن يجعلهم في عداد الموظفين ليعولوا أهليهم وذويهم بعد أن كفت أيديهم وتعطلت أعمالهم وباتوا لا يجدون سبيلاً إلى العيش» (114).
لقد طوى التاريخ عهد الإمام يحيى دون أن يحفظ له «أي انجاز يمكن تسجيله له باستثناء توحيد الأجزاء المختلفة تحت حكمه، حتى أنه ليذهب البعض -عن حق- إلى أن فترة حكمه كانت من الناحية الحضارية أسوأ من الحكم التركي بكثير» (43). وسيكون من المؤسف أن يطوي التاريخ عهد رئيس حظي بفرصة الحكم في مرحلة ما بعد الحداثة العالمية ولطالما عُرف بالذكاء والدهاء مثل صالح دون أن يكون في سجله سوى «إنجازين» وحيدين: «وحدة حرب 94» ضد الجنوب وحرب صعدة ضد الهاشميين وبعض قبائل بكيل والمذهب الزيدي عموماً. وهاتان الحربان من تداعيات حركة التوريث الجارية التي قد تشهد صدامات دامية في العاصمة وبقية المحافظات وتملاء سجون البلاد ومجهولها باليمنيين.
«اللقاء المشترك» يوازي معارضة «آل الوزير» قبل 48
إنها مرحلة «ولاية العهد» بحذافيرها، مع الفارق المهم في أن الرئيس صالح نجح في ما فشل فيه الإمام يحيى وهو الترتيب المتقن. ولا تختلف المعارضة التي قويت في عهد الإمام يحيى بعد انضمام شركاء الحكم المقصيين إليها كـ«آل الوزير» والعديد من الأسر الأخرى الفاعلة، عن المعارضة الحالية المتمثلة في «اللقاء المشترك» الذي وصفته «الشموع»- قبل أسبوعين- بـ«القوة الوطنية الرائعة» في معرض دفاعها المتواصل عنه مؤخراً. ولا يبدو دفاع الصحف، التي يحسبها البعض على اللواء علي محسن الأحمر، عن «اللقاء المشترك» مستغرباً البتة.
فالجبهة الرافضة لقرار إنهاء حرب صعدة، التي اندلعت أصلاً في سياق الصراع الذي خلقته «ولاية العهد» الجديدة، تقود «المشترك» عملياً وتقرر أجندته، وهي غير معنية مطلقاً بقضية «المواطنة» والحقوق والحريات، وحين تكترث لبعض هوامش الانتهاكات فإنما لـ«رشوة» الأطراف الأخرى في التكتل المعارض (كالحزب الاشتراكي ثم الناصري) اللذين يبدو انهما يجهلان ما ينتظرهما في هذا الصراع على هامش «ولاية العهد» الجمهوري. لقد انتقل «آل الوزير» وبقية الشركاء المتضررين إلى المعارضة لا كأطراف بل كزعماء وهو ما حدث في اللقاء المشترك. وبعد انقلاب 1948، تجاهل الإمام الجديد عبدالله الوزير «الدستور» الذي قدمته له المعارضة وبدأ في إقصاء شركائه في ذلك الانقلاب أو تحديد مهامهم في أفضل الأحوال. ولو امتد به العمر في الإمامة -في تقديري- لتعرض شركاؤه في معارضة ١_٩_48لما تعرض له شركاء «ثورة» سبتمبر ١_٩_62 الذين تم تصفيتهم في إنقلاب نوفمبر ١_٩_67 وأحداث أغسطس ١_٩_٦_8 إنتهاء بالعام ١_970. وكان هؤلاء المقصيون محسوبين، بشكل أو بآخر، كقوى «مستنيرة»، وللمنطقة في الواقع دورها الأساسي.
بحسب الصايدي، فقد «تكونت المعارضة ضد حكم الإمام يحيى، من قوى متباينة (كبار السادة والقضاة وبعض المشايخ، وكبار ملاك الأرض والتجار والمستنيرين)، وأسهمت فيها قوى خارجية كالاخوان المسلمين وأفراد البعثة العسكرية العراقية» (238). وكانت هذه القوى باستثناء بعض المثقفين المستنيرين، ضد «ولاية العهد» فقط التي بدأت في إقصائهم من الحكم وشبكة المصالح القائمة حوله. إذ أن عبدالله الوزير كان- وفقاً لمؤرخين عديدين- أكثر محافظة من الإمام يحيى الذي اصطدم بقبيلة حاشد، لأسباب يضع البعض على رأسها إلزامه القبيلة المحاربة بإعطاء حق المرأة في الورث، وفقاً لـ«الشريعة». لم يكن لدى الشركاء المقصيين من دائرة حكم الإمام يحيى، والذين تحولوا عقب ذلك إلى قيادة المعارضة السلمية، أي مشروع يتعلق بالمواطنة والمدنية والتحديث. وهو أمر لايبدو «اللقاء المشترك» بعيداً عنه.
داهم الوقت ونجل الإمام يحيى (أحمد) الإمام الوزير وهو -على الأرجح- متلبِّس بنوايا إقصاء شركائه في المعارضة بعد نجاح إنقلاب 1948 وتوليه الإمامة. لم تواته الفرصة التي وأتت القوى القبلية والدينية الشمالية غالباً مع بعض العسكر وبعض الأسر التعزية (أقصيت لاحقاً- النعمان مثلاً) حين انقضت على شركائها من القوى «المستنيرة» وبعض القوى الأخرى في «ثورة» سبتمبر 1962. وبدأت في افتراسهم خلال مرحلة الإنقلاب عليهم و«ثورتهم السبتمبرية»، بلجوء التحالف المشيخي -البعثي المتصارع مع السلال إلى السعودية عام 1965، حيث وقعوا على «وثيقة الطائف» التي استهدفت تغيير الصيغة «الجمهورية» لنظام «ثورة» سبتمبر، حسب مذكرات الشيخ سنان أبو لحوم. وقد ألقت تلك الوثيقة وتحالفاتها ظلالها على التاريخ اليمني الجمهوري كله حتى الآن.
لا تختلف مرحلة «ولاية العهد» الراهنة عن مرحلة «ولاية العهد» في حقبة الإمام يحيى، بما في ذلك استخدام ورقة المعتقلين في التفاوضات حول الانتخابات، أحد الترتيبات السياسية في مرحلة «ولاية العهد» الحالية. وهي ورقة توازي- كثيراً- ورقة «الرهائن» التي استخدمت في «العهد الإمامي البائد» للضغط على القوى القبلية والمعارضين «السلميين». وستظل حاجة القوى المحافظة والمعارضة لـ«ولاية العهد» الحالية، لـ«اللقاء المشترك» كبيرة، خصوصاً في هذه المرحلة التي وصل فيها الرئيس صالح إلى أقوى لحظاته في الحكم، وهو ما بدا واضحاً في قرار إنهاء حرب صعدة الذي لم يعد فيه إلى شركائه في الحرب (والحكم تبعاً لذلك). وقد تجنب الرئيس، عبر المؤتمر الذي اتخذ قراراً منفرداً في قضية التعديلات، تجنب إيصال «المشترك» إلى نقطة الإنشقاق الداخلي، لأنه ما يزال بحاجته أيضاً، إذ سيفتح عليه انفجار «المشترك» داخلياً أبواباً ليس مستعداً لها ولا بصددها الآن، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الحزب الاشتراكي والناصري والبقية سيخرجون من هذا الصراع خاسرين، وليس أمامهم الآن سوى الانضمام إلى قضايا الناس داخل المعتقلات وخارجها. وحتى لو افترضنا جدلاً أن «المشترك» سينقلب على الرئيس وترتيباته ويستولي على الحكم، فإن الاشتراكي والناصري سينضمان إلى طابور الشركاء المقصيين على غرار شركاء الإمام الوزير في المعارضة عقب انقلاب 1948 ثم شركاء «ثورة» 19٦_2 الذين لم يكونوا يستندون إلى سلاح كافٍ وعصبيات قبلية شديدة ومتحالفة مع السعودية.
nabilsobeaMail





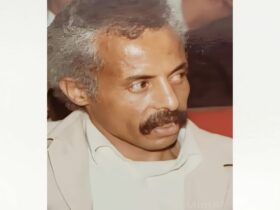
على شبكات التواصل