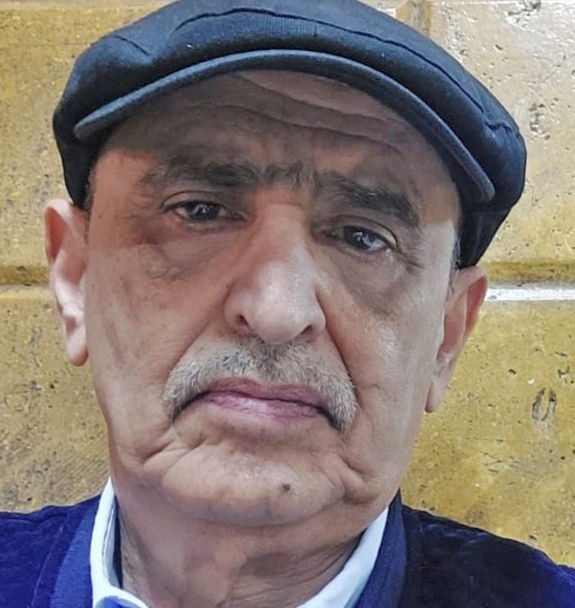لا دنيا لنا ولا دين فهل نفيق؟
لماذا نحن دون سائر الأمم نعجز عن إقامة الدولة التي يتعايش فيها الجميع؟ لماذا نراوح مكاننا في دائرة الانكسارات المتكررة، والحروب التي لا تنتهي، والصراعات التي لا طائل منها؟ سؤال يتردد في وجدان كل عربي يشعر بمرارة الواقع، ويقارن نفسه بما وصلت إليه أمم أخرى تجاوزتنا بمئات السنين، رغم أننا من أسس العلوم، وبنينا حضارات ملأت الأرض نورًا.
الخلل ليس في الدين، بل في طريقة فهمنا له وتوظيفه. فالإسلام جاء برسالة تحريرية، تدعو إلى العدل، والمساواة، وعمارة الأرض، لكنه تحول عند كثيرين إلى أداة للسيطرة وتكريس السلطة. لم يكن الدين خصمًا للدولة العادلة يومًا، لكن الذين احتكروا تفسيره جعلوه مطيةً لمآربهم السياسية، فكان الانحراف عن جوهره أكثر خطرًا من أعدائه.
نحن نعاني من إرث طويل من الاستبداد السياسي. دولنا لم تعرف المعنى الحقيقي لتداول السلطة، بل تأسست على مفاهيم العصبية والطائفية والمناطقية، وكرّست الولاء للأشخاص لا للمؤسسات، فغاب مفهوم "المواطن" وحل محله "التابع". في ظل هذه التركيبة، تصبح القبيلة والمذهب والعشيرة بديلًا عن الدولة، وتتحول الدولة إلى مجرد قشرة هشة سرعان ما تتشقق مع أول خلاف.
المشكلة الثانية تكمن في الركود الثقافي. لم نعد ننتج فكرًا نقديًا حيًا، بل نستعيد الماضي ونعيد تدويره، ونقدّس التراث دون مساءلته. من قرأ بجدية لمالك بن نبي؟ من فهم مشروع الجابري في نقد العقل العربي؟ من اهتم بما طرحه أركون عن الحاجة إلى إعادة قراءة النص؟ هذه المشاريع الفكرية لم تحظَ بما تستحقه من تفاعل، لأننا نخشى النقد، ونخاف من مساءلة المسلّمات، وندفن رؤوسنا في الرمال خوفًا من الصدام مع ما ورثناه.
ولا يمكن إغفال الدور الخارجي. فالقوى الكبرى مازالت ترى في منطقتنا ساحة نفوذ ومصدرًا للموارد. تسلّح الجميع وتدعم الجميع، وتستثمر في انقساماتنا، لأننا لم نبنِ بعد أدوات الحصانة الذاتية. نحن بيئة مثالية للتدخل، لأننا لم نحصّن أنفسنا بمشروع وطني جامع.
الطائفية والقبلية تُغذى ممن يجد فيها فرصة للهيمنة. الأنظمة تستخدمها، كما تستخدمها بعض النخب الدينية والإعلامية لتفتيت أي محاولة لبناء هوية وطنية جامعة. إنها أسهل الطرق لضمان السيطرة، في غياب مشروع حقيقي للمواطنة.
نحن مازلنا نعيش في حالة "اللادولة"، لأننا لم نؤمن بعد أن الدولة لا تُبنى إلا بالعقد الاجتماعي، وبأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وبأن الكفاءة لا النسب هي معيار التقدّم. التخلّف ليس قدرًا، بل نتيجة طبيعية حين يُهمّش العقل، ويُستبعد النقد، ويُكافأ التابع على حساب الحرّ.
كيف ننهض؟ لا طريق أمامنا إلا النقد الصادق للذات دون جلدها، والمصارحة دون مواربة. علينا أن نعيد بناء الدولة على أساس المواطنة، لا على الهويات القاتلة. أن نعيد الاعتبار للعقل والتفكير الحر. أن نُصلح التعليم والإعلام، وأن نُحرر الدين من التوظيف السياسي دون أن نعاديه. أن نقرأ تراثنا لا لنمجّده فقط، بل لنفهمه، ونفرز ما يصلح منه لما نعيشه اليوم.
لسنا أمة فاشلة، ولكننا عطلنا أعظم ما نملكه: عقولنا. خذلنا أنفسنا حين سلّمنا أمرنا لمن لا يرى فينا إلا أدوات لبقاء سلطته. المستقبل لن يُمنح لنا، بل نصنعه نحن، بجيل جديد يؤمن بالعلم، بالحوار، بالحرية، ويضع الإنسان قبل الطائفة، والمواطنة قبل القبيلة.
لقد أمرنا الله أن نعمر الأرض، لا أن نغرق في الخصومات، ولا أن نحرقها بالحروب. فهل نعود إلى جوهر رسالتنا، ونستعيد قدرتنا على الحياة، أم نواصل الغرق في لا دنيا ولا دين؟