اختطاف الدولة.. قضية لا يراد لها أن تناقش -طاهر شمسان
تقوم الدولة المدنية الحديثة على مرتكزين:
الأول: فك الارتباط بين السلطة والثروة. وهذا معناه أن من يملك السلطة ليس من حقه أن يسخرها للاستحواذ على الثروة. بينما يحق لمن يملك ثروة أن يتطلع إلى السلطة كحق من حقوق المواطنة. وتؤمن آليات الديمقراطية منظومة نزاهة متكاملة تحمي هذا المبدأ وتضمن استمراره.
الثاني: فك الارتباط بين الدولة وبين أي من العصبيات الموجودة في المجتمع, بما في ذلك العصبيات الحزبية المتدثرة بالدين أو بالأيديولوجيا. وقد بني هذا المبدأ على حقيقة مؤداها أن العصبية –إذا قويت شوكتها- تقدم على اختطاف الدولة وتتماهى فيها فتصبح هي الدولة والدولة هي. وعندها يغدو من الصعب التمييز بين الدولة والسلطة، لأن السلطة تتمدد على حساب الدولة فتستحوذ على كل شيء ابتداء من الجيش وانتهاء بكتب المطالعة المدرسية.
والدولة المدنية الحديثة بهذا المعنى صناعة مجتمعية تنم عن درجة تحضر المجتمع ورقي نخبه. إنها نتاج توافق بين نخب تمثل كل مكونات المجتمع التقت تحت سقف واحد وطرحت على نفسها السؤال التالي: كيف نبني دولة مقتدرة تمثل إرادتنا جميعا كمواطنين يجمعنا العيش المشترك على هذه الرقعة الجغرافية وتساعدنا على البقاء كمجتمع تتوفر فيه كل عوامل الصحة المستدامة، وعلى قاعدة القبول المتبادل ونبذ ثقافة الإقصاء والإلغاء صاغت الشعوب المتقدمة عقودا اجتماعية (دساتير) وبنت دولا راشدة ومنيعة؟
نحن في اليمن –تاريخيا- لا نعرف الدولة بهذا المعنى. وما نعرفه هو دول تقليدية قامت –في الشمال والجنوب- على الغلبة والعصبيات الأسرية والمذهبية والقبلية، وأسست شرعيتها على دعاوى دينية في الغالب. وآخر هذه الدول في الشمال هي دولة أسرة حميد الدين التي اتكأت على عصبية مذهبية ميزت بين اليمنيين وصنفتهم إلى "زيود" و"شوافع", وميزت بين الزيود وصنفتهم إلى "هاشميين" و"قحطانيين", وميزت بين الهاشميين أنفسهم وصنفتهم إلى درجات ومراتب. وفي هذا التصنيف توارى مفهوم الشعب واختفى مفهوم المواطنة.
وقد استمدت ثورة سبتمبر شرعيتها من الرفض المطلق لدولة بيت حميد الدين. لكن الجمهوريين الذين ثاروا ضد الدولة التقليدية التي لا يريدونها لم يكونوا –لأسباب موضوعية وذاتية– مؤهلين ثقافيا وسياسيا للوصول إلى توافق حول الدولة البديلة التي يريدونها. ولأن الحاضر هو امتداد للماضي وبداية للمستقبل فقد انقسم الصف الجمهوري إلى معسكرين يتسابقان على اختطاف دولة الثورة, أحدهما تقليدي ماضوي مشدود إلى عصبية قبلية في الأساس, والآخر ثوري مستقبلي معبأ بالأيديولوجيا التي كانت في الغالب خليطا من النزعات القومية واليسارية.
ولأن تأثير الماضي الإمامي على الحاضر الجمهوري كان أقوى من تأثير المستقبل عليه فقد مثل ذلك عامل إغراء للمعسكر الأول ليرفع سقف طموحه ويختطف الثورة ودولة الثورة ويقصي الثوريين بالقوة في أحداث أغسطس 1968. ومنذ تلك اللحظة بدأت تدريجيا عملية اختطاف العصبية القبلية للدولة ولكن تحت يافطة الثورة والجمهورية. وهذه يافطة عريضة يستحيل معها تبرير الاختطاف والدفاع عنه ما لم يؤت بشركاء شكليين من خارج القبيلة للتعمية على واقع الغلبة.
ومن معطف هذه العصبية القبلية تحديدا خرج الرئيس علي عبد الله صالح كعسكري لم يعرف عنه من قبل أنه مارس نشاطا سياسيا مؤطرا في حزب أو تنظيم وإنما هو ابن القبيلة جاء إلى السلطة يحمل ذهنيتها ويخوض معاركها عندما يقتضي الأمر ذلك وليس له مشروع سياسي يتجاوز ديارها إلى الوطن كله. ولأسباب لها علاقة بالحرب الباردة, والصراع مع دولة الحزب الاشتراكي في الجنوب, ومحاولة انقلاب الناصريين عليه, وحروب الجبهة الوطنية الديمقراطية, وطبيعة التحولات الاجتماعية في الجمهورية العربية, فضلا عن مواهبه الشخصية، استطاع الرئيس صالح أن يراكم عوامل قوته وأن يوسع دائرة اختطاف الدولة تدريجيا لتشمل كل مؤسساتها العسكرية والمدنية.
وعندما وقع الرئيس صالح مع علي سالم البيض اتفاقية 30 نوفمبر1989 لم يوقعها كرئيس لدولة تجسد مصالح كل مواطنيها في الشمال, وإنما وقعها كرئيس لدولة مخطوفة مجسدة لإرادة خاطفيها من داخل القبيلة وخارجها. ولذا كان من المستحيل أن يقبل بالوحدة ما لم يكن هو رئيسا قويا لدولتها ضامنا مصالح خاطفيها. ولا يطعن في هذه الحقيقة كون الشعب اليمني خرج عن بكرة أبيه يؤيد اتفاقية الوحدة. فالتأييد كان للوحدة كمبدأ مجرد من حسابات الساسة.
وفي الجنوب لم توقع الجبهة القومية على صك الاستقلال إلا بعد أن أقصت جبهة التحرير بالقوة. وامتدت ثقافة الإقصاء لتطال آخرين داخل الجبهة القومية نفسها حتى آل مسار تطور دولة الاستقلال إلى اختطافها من قبل الحزب الاشتراكي اليمني الذي مثل عصبية حزبية أيديولوجية صريحة انحازت علنا –عن حق أو ادعاء– إلى جانب شرائح وفئات اجتماعية معينة ضدا على أخرى جرى إقصاءها بسبب طغيان الأيديولوجيا في السياسة والاقتصاد. ولهذا لم يكن البيض لحظة توقيعه على اتفاقية 30 نوفمبر 1989 يمثل كل أبناء الشعب اليمني في الجنوب بقدر ما يمثل العصبية الحزبية التي تختطف الدولة. ولا ينتقص من هذه الحقيقة كون الشعب هناك أيد بقوة واقعة الاتفاق.
استمدت العصبية الحزبية في الجنوب عوامل قوتها من الإعمال الصارم لمبدأ سيادة النظام والقانون الذي يجسد إرادة الحزب لا إرادة الشعب. بينما استمدت العصبية القبلية في الشمال عوامل قوتها من التعطيل الانتقائي لهذا المبدأ. وهذه مفارقة تعود إلى التباين في طبيعة العصبية المتجسدة في الدولتين. ففي حالة الجنوب كان الحزب كعصبية هو الذي يخطف الدولة ويوظف مهارات أعضائه وكوادره لمصلحته كمؤسسة وليس كأفراد. أما في حالة الشمال فالذي يخطف الدولة ليس القبيلة كمؤسسة تقليدية وإنما رموزها كقادة تقليديين. وهؤلاء لا يستطيعون أن يديروا دولة صارمة في تطبيق مبدأ سيادة القانون لأنهم سيعجزون عن توظيف القبيلة كعمق اجتماعي لتكريس مصالحهم وسيكونون بالتالي أول ضحايا هذا التطبيق.
بعد أحداث أغسطس 1968 لم يشهد النظام في الشمال دورة عنف واقتتال -بين شركاء السلطة- كتلك لتي شهدها النظام في الجنوب في يناير 1986 رغم أن الدولة في الحالتين مختطفة. والسبب أن الدولة في الجنوب قامت على توازنات مناطقية كان يعتقد خطأ أن الأيديولوجيا قد أذابتها في إطار الحزب ومؤسسات الدولة. أما في الشمال فقد استقرت الدولة المخطوفة عمليا على مبدأ الاستحواذ والإقصاء, وهناك جهة واحدة فقط تحتكر القوة العسكرية متماهية في الدولة ولا يوجد طرف آخر ينازعها على ذلك. وهذه الجهة هي التي تختار "شركاءها" من خارجها وتفصلهم على مقاسها وتستطيع أن تغيرهم متى شاءت كما تغير معاطفها. وبالتالي فالتمثيل المناطقي في الدولة هو تمثيل شكلي لا يمت لمفهوم التوازن بأي صلة. وهذا هو واقع الحال في الجمهورية اليمنية اليوم.
وفي هذا السياق ليس صحيحا أن دورات العنف والاقتتال التي شهدتها دولة الحزب الاشتراكي في الجنوب كانت بسبب الاختيار الأيديولوجي لهذا الحزب. فالسبب هو التوازن المناطقي الذي أخذ طابعا عسكريا في إطار دولة مخطوفة. أما الأيديولوجيا فقد كان دورها تبريريا ليس إلا. ولو أن الجمهورية العربية اليمنية قامت على توازنات مناطقية متكافئة عسكريا لشهدت دورات عنف واقتتال كتلك التي حدثت في أغسطس 1968 وربما أسوأ منها.
في 22 مايو 1990 تحققت الوحدة اليمنية بين دولتين مخطوفتين. ولم تقم الوحدة على قاعدة بناء الدولة المجسدة للإرادة العامة وعلى توازن اجتماعي متين، وإنما قامت على مبدأ التقاسم بين الخاطفين المسلحين بتوازن عسكري. ولهذا كانت دولة الوحدة دولة مخطوفة تحمل في أحشائها منذ البداية احتمالات العنف والاقتتال.
في اتفاقية الوحدة تمسك البيض بمبدئي الشراكة والديمقراطية. لكنه -كشريك في اختطاف دولة الوحدة– لم يكن متحمسا لهذين المبدأين من منطلق الثقافة الديمقراطية الراسخة التي توجه السياسة وترشدها وإنما تحت ضغط الحسابات السياسية التي بدأت للتو تنفتح على الديمقراطية وتقترب منها ببطء شديد. ولهذا لم تكن حسابات البيض مؤسسة تأسيسا دقيقا, لأن الذي يخطف الدولة في الشمال لا يقبل -بحكم الثقافة- بالشراكة القائمة على الندية, ولأن الديمقراطية لا تستقيم إلا في إطار دولة مؤسسات مجسدة للإرادة العامة وفي بيئة مجتمعية مستجيبة لمتطلبات دولة ديمقراطية, وليس في إطار دولة مخطوفة قائمة على الغلبة أو التوازنات العسكرية وبيئة مجتمعية تتوزعها كيانات قبلية ومناطقية لا يراد لها بعد أن تتبلور في مفهوم "الشعبـ".
في انتخابات أبريل 1993 النيابية اتكأ الرئيس صالح وحزبه على تحالف وثيق مع التجمع اليمني للإصلاح وهو عصبية أيديولوجية حزبية إقصائية ظلت تراكم عوامل قوتها لفترة طويلة في إطار الجمهورية العربية اليمنية وتتحين الفرصة لاختطاف الدولة باسم الدين. ومن معطف هذه العصبية خرجت كل المجموعات الجهادية في اليمن.
ولأن انتخابات 1993 كانت نزيهة قياسا بما تلاها من انتخابات نيابية, لم يستطع أي حزب أن يحقق الأغلبية المطلقة بمفرده. ولم يستطع الرئيس صالح أن يحصل على القوة البرلمانية التي كان يريدها للسيطرة. وفي الوقت ذاته وجد البيض نفسه في موقف أضعف مما كان يبدو عليه قبل الانتخابات.
ومع ذلك رأى الرئيس صالح أن نتائج الانتخابات تسمح له بإقامة نظام رئاسي قوي بالنظر إلى وضعه التحالفي الممتاز مع التجمع اليمني للإصلاح المتحفز لمقاتلة الاشتراكي لأسباب أيديولوجية خالصة لا ناقة للشعب اليمني فيها ولا جمل. أما البيض وقد سيطر الاشتراكي على مقاعد الجنوب فيعتبر نفسه الشريك الأساسي في الحكم ويطالب بصلاحيات دستورية وتمثيل قوي في الحكومة بحجة أن مسيرة الوحدة تتطلب ذلك.
وبما أن الانتخابات جرت في إطار دولة مخطوفة فقد أفضت إلى قيام برلمان مخطوف لا يجسد فعليا الإرادة العامة للشعب اليمني بقدر ما يجسد إرادة الخاطفين. ولهذا توزع ولاؤه على الأطراف التي تختطف الدولة. وبدلا من أن يكون هذا البرلمان جزءا من الحل وقادرا على قسر أطراف السلطة على الخضوع المشترك لمبدأ المصلحة الوطنية العليا أصبح جزءا من المشكلة وساحة اقتتال بين الأطراف التي تختطف الدولة.
ورغم أن محاولة دمج القوات المسلحة والأمن, وتعديل الدستور, وإعادة هيكلة الدولة, وغيرها من القضايا المتعلقة ببناء الدولة لا تحسم إلا من خلال التوافق والتفاهم بين الأطراف التي تختطف الدولة, فقد أصر تحالف المؤتمر والإصلاح على أن يحتكم البيض في هذه القضايا للأغلبية البرلمانية -وهي أغلبية شمالية في الأساس- ويحترم الخيار الديمقراطي لدولة الوحدة أو يواجه تهمة افتعال الأزمة لتبرير ارتداده عن الوحدة بكل ما ينطوي عليه هذا الاتهام من تهديد صريح بالحرب.
ولأن التوافق والشراكة بين طرفي الوحدة -وليس الديمقراطية للمجتمع- هو الأصل في قيام الوحدة, ولأن البيض يعتبر نفسه صاحب التنازلات الكبيرة من أجل الوحدة, فقد تملكه شعور قوي بالغبن وأحس بأن شريكه خدعه ويريد إقصاءه باسم الديمقراطية, وفي أحسن الأحوال تحجيم دوره ودور حزبه, فرفض مبدأ "الاستقواء بالأغلبية العددية" وأخرج الأزمة إلى العلن حتى أوصل الجميع إلى شرعية موازية هي "شرعية الإجماع الوطني" التي صاغت "وثيقة العهد والاتفاق". فجاءت الوثيقة وكأنها اتفاق جديد للوحدة، وبظهورها تبين أن ما كان يتوجب على اليمنيين أن يفعلوه في 30 نوفمبر 1989 فعلوه بأثر رجعي في يناير 1994 ولكن في وقت أصبحت فيه إرادة الحرب والإقصاء لدى تحالف المؤتمر والإصلاح أقوى من كل العهود والمواثيق والاتفاقات, يقابلها إرادة دفاعية من الطرف الآخر بدت عليها مؤشرات تراجع عن وحدة 22 مايو 90 لصالح اتحاد فيدرالي.
في الدولة المدنية الحديثة الأقلية البرلمانية تكون محمية بالدستور وبمؤسسات الدولة وبالثقافة الديمقراطية المتوطنة في المجتمع, وهذه منظومة حماية تؤهل الأقلية للتحول إلى أغلبية في أي دورة انتخابية قادمة. أما في الدولة المخطوفة فالأغلبية تريد أن تكون أغلبية إلى الأبد حتى يكون بمقدور زعيمها أن يجلس على كرسي الحكم دون منغصات. لهذا خرج الرئيس صالح إلى ميدان السبعين ومن هناك أعلن قرار حرب صيف 1994، لا بسبب انفصال تم إعلانه ويستوجب ردعه بالقوة، وإنما لفرض حل عسكري نهائي على أزمة ذات طابع سياسي ومن ثم التخلص من شركائه في دولة الوحدة واختطافها منفردا.
بعد نحو عشرين يوما من الحرب التي رفض مشعلوها أن تتوقف ما لم يسلم البيض نفسه إلى أقرب قسم شرطة, قبل هذا الأخير –تحت ضغوط الحرب وضغوط بعض الرفاق- أن يقدم على انتحار سياسي أضفى قدرا كبيرا من القداسة على حرب غير مقدسة كانت ستنتهي بأصحابها إلى هزيمة سياسية مؤكدة في زمن قياسي لولا هذا الانتحار الذي ساعد أدعياء الوحدة على العبث بمعانيها الجميلة حتى اليوم.
من زاوية القانون الدولي كانت حرب 1994 حربا في إطار دولة واحدة. أما من الناحية الفعلية فقد كانت حربا بين الدولتين الشمالية والجنوبية اللتين استعصتا على استكمال اندماجهما الطوعي في بنية دولة واحدة بسبب عدم قدرة نخبتيهما على التوافق حول حزمة من القضايا لعل أهمها دمج الجيش والأمن -وهذه من مهام المرحلة الانتقالية!!- وتعديل الدستور وإعادة هيكلة الدولة, والتحديد الدقيق لصلاحيات الرئيس ونائبه, فضلا عن التباين حول أسلوب إدارة دولة الوحدة. ولا يمكن التعمية على هذه الحقيقة بتعيين الجنوبي عبد ربه منصور هادي وزيرا للدفاع أثناء الحرب واشتراك المئات وربما الآلاف من زملائه في المجهود الحربي. فهؤلاء قاتلوا لأنهم أصحاب ثأر تحركهم نزعات انتقامية لا علاقة لها بالوحدة وبالقضايا الوطنية الكبرى.
وإذا كان تحالف المؤتمر والإصلاح قد بدأ الحرب وخاضها باسم الشرعية الدستورية فإن الطرف الآخر كان جزءا من هذه الشرعية التي أفرزتها انتخابات 1993 النيابية. ولو أن الأمر تعلق بكتيبة عسكرية أو ثلاث لجاز الحديث عن تمرد يستوجب قمعه لفرض النظام والقانون. لكننا أمام انقسام رأسي أخذ طابعا شطريا وشمل كل سلطات ومؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس الرئاسة والحكومة والبرلمان والجيش والأمن.
تزامنا مع آخر طلقة في الحرب بعثت حكومة الجمهورية اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها التزامها الثابت بالنهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان واعتزامها مواصلة الحوار الوطني في ظل الشرعية الدستورية والتزامها بما جاء في وثيقة العهد والاتفاق كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وفي الوقت نفسه أخذ الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي الموجه إلى الداخل ينعت "وثيقة العهد والاتفاق" بأنها "وثيقة الخيانة" ما يعني أن الحرب كانت انقلابا صريحا على دولة الوحدة لصالح الجمهورية العربية اليمنية وضدا على جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي نرى الآن بأم أعيننا كيف يتعرض تاريخها (1967-1990) للتسفيه ورموزها للتخوين وثرواتها للنهب المنظم. وعلى خلفية هذه الممارسات نشأت في المحافظات الجنوبية حركة احتجاجية واسعة لسان حالها يقول: "نحن لا نستطيع أن نعيش بالطريقة التي تدار بها الأمور في ظل دولة سبعة يوليو المعمدة بالدم لأنها دولة فصلت بالقوة وبطريقة لا أخلاقية على قلة من اليمنيين -شماليين وجنوبيين- ولأن المواطن إذا لم يكن جزءا من نظام هذه الدولة لن يستطيع أن يحصل على أي شيء حتى ولو توفرت فيه كل شروط الاستحقاق". ويعبر هذا القول بوضوح عن حاجة كل اليمنيين الملحة إلى دولة يقوم على إنشائها المجتمع كله عبر نخب تمثل كل الشرائح والفئات والطبقات والمحافظات الشمالية والجنوبية تمثيلا حقيقيا. أما الحديث عن توجهات انفصالية في الجنوب فهو محض تحريض يستخدم شعار الوحدة للتهرب من مناقشة قضية الدولة.
صحفي يعمل في الفضائية اليمنية
tahershamsanMail





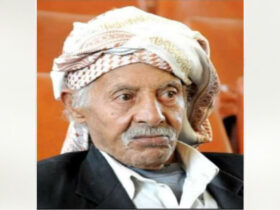
على شبكات التواصل